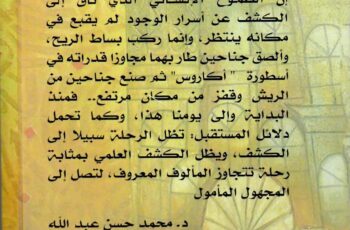خصائص الهوية الثقافية
ندوة : مفترق القرن
الثقافة العربية بين الاستشراق والاستغراب
خصائص الهوية الثقافية
محمد حسن عبدالله
أولا : تقـــديم
خصائص الهوية الثقافية
تتفاوت تقديرات ” الثقافة ” حتى يبدو أبسطها كبحيرة رائقة ساكنة قريبة القاع تكشف – للمتأمل – عن أسرارها بغير جهد يذكر ؛ فالثقافة – بهذا الحد القريب – المنتج الفني مثل القصص ، والفنون التشكيلية ، والموسيقى ، وما يؤثر فيه هذا المنتج من توجيه يرقى بالسلوك العام . وقد يتمادى في البعد حتى يبدو كمجرة سماوية تحتاج إلى آلات متقدمة ، ومعقدة ، حتى تأذن بالاقتراب من تصورها . وبين الإجمال والتفصيل تفريعات ولواحق قد تكون بعدد الذين حاولوا خوض تعريف الثقافة ، ما بين المؤثرات فيها ، والدرجة من الأهمية التي تشغلها ، ودورها في صناعة التقدم .. إلخ ، ومن شان هذا أن يدفع بنا إلى بذل المزيد من الاعتماد على المصادر والمراجع التي أنتجتها العصور والحضارات في هذا الاتجاه ، إذ بدأ عنوان هذه الورقة محددا ” بالخصائص ” وهي المميزات الفارقة بين مصطلح وآخر(1) . كما أطلق لفظ ” الثقافية ” من أي قيد جغرافي ، أو تاريخي ، أو حضاري ، أو عرقي !! إننا – إذن – لا نعرض لثقافة دول الخليج ، المحددة بالجغرافيا ، ولا ثقافة قدماء المصريين المحددة بالتاريخ ، ولا ثقافة الأندلس المحددة بزمن نهضتهم ذات المزيج العرقي النادر ، ولا عن ثقافة قبائل الإنكا ذات التوحد السلالي على سبيل المثال . فهذا الإطلاق يؤدي إلى ضرورة التوفيق بين خطين متوازيين أحيانا ومتقاطعين في أحيان أخرى ، الخط الأول : يتطلب الحرص على تجريد معنى ” الثقافة “– في ذاتها – من أية علائق أو تلوينات تضفيها المتغيرات أو الأحداث الطارئة، وهذا الخط الأول إذا التزمنا به – بصرامة – سينتهي بنا إلى الاكتفاء بالمعنى اللغوي المعجمي ، الذي لن يكون – بدوره – كامل التجرد من علائق الزمان والمكان والممارسة الإنسانية ، لأن الاستخدام ( الفعلي ) هو مصدر المعرفة باللغة . فإذا قال المعجم العربي ( مثل لسان العرب ) عن مادة ” ثقف ” تعني : الحِذْق ، والفهم ، وسرعة التعلم ، فإن هذه المعاني المجردة لن تكون على مبعدة من ( الأصل) المادي الذي يقرر أن ” الثقافة “: حديدة أو خشبة تكون مع القوّاس والرمّاح ، يقوِّم بها الشيء المعوج ، فيستقيم(2) . ولعله – بهذه العبارة المسرفة في الوضوح والبساطة – تحددت أهداف الثقافة ، ووظيفتها _ ( تقويم المعوجّ ) غير أن القضية تظل معلقة بتعريف المعوجِّ ، ومن الذي يحكم بعوجه ؟ وكيف يعدل هذا الاعوجاج حتى يستقيم ؟ أما الخط الثاني فإنه لا يكتفي بالمعاني المجردة ، فالثقافة فعل إنساني ، وهو متأثر لا محالة – مثل كل الأفعال – بالزمان ، والمكان ، والسياق ، والموروث ، والطوارئ الحادثة ، وتداول مواقع القوة والتأثير في العالم ، ودرجة الحرص على التثقيف ودوافع هذا الحرص وآلياته لدى من يرى نفسه الأرقى ثقافة ، ودرجة التقبل أو الرغبة ، أو الرفض والمقاومة لدى من جرى وصفه بأنه الأقل ثقافة . إن حديث ” الهوية ” لن يكون ولوجه ميسِّرا لتجنب ضرورة التعرض لما خاضت الإنسانية من تجارب في هذا المضمار ، لأننا – في الحقيقة – لا نعرض لتحديد صارم يحصر أو يحاصر مفهوم ” الثقافة ” ويبرز تخومها ، ليست قالبا مفرغا ، أو مجموعة جاهزة من المبادئ العامة ، نتعقبها عبر التجارب لنعاين مدى تحققها هنا أو هناك أو هنالك !! فهذا الفعل ” الثقافي ” ليس عملا فرديا ، وليس صفة شخصية لجماعة محدودة أو محددة ، حتى في حال القول بثقافة جماعة أو طائفة ، ( مثل ثقافة المحامين ، أو رجال الدين ، أو أهل الفن ، بمعنى : طرائق حياتهم وأعرافهم الخاصة ، بما يشتركون فيه من حيث هم جماعة تزاول نشاطها محددا في زمن محدد كذلك ، ولها نظرتها المشتركة إلى غيرها ) فإن هذه الدائرة تظل محكومة بظروفها الخاصة ، وليست خصوصيتها من جانب نقيضا لاندماجها الاجتماعي العام من جانب آخر. وعلى النقيض من هذه الجماعات المستقطبة ما اختاره الزعيم الصيني ماو تسي تونج شعارا(3) لاستئناف ثورته التي انتقلت بالصين – على ترامي جهاتها – من التفسخ والفوضى والجمود – إلى التوحد تحت شعار الماركسية ، وإقامة جمهورية اشتراكية (1948 ) فإنه بعد عشرين عاما رأى أن ثورته لم تنجز مهمتها كما كان يخطط لها ، فأعلن ثورة مستأنفة تحت شعار ” الثورة الثقافية ” ( 1966 ) وساقت هذه الثورة الثقافية ملايين الشباب من المدن إلى الريف ليتعلموا الحياة الزراعية على أيدي الفلاحين ، مدخلا لتخليص هؤلاء الشباب من سطوة الأفكار القديمة ، والتقاليد البالية . وموقف الزعيم الصيني لا يختلف عن موقف الوزير النازي ( جوبلز )(4) الذي كان الأداة الدعائية المروجة لهتلر زعيما منقذا للأمة الألمانية ، وهو صاحب العبارة المشهورة المتداولة : “كلما سمعت كلمة ثقافة وضعت يدي على مسدسي ” إذ يلتقي الماركسي والنازي عند تقدير خطورة الثقافة ، وإن وظفها الماركسي لنشر دعوته وإقرار مجتمعه الشيوعي ، وقمعها النازي لأنها تتقبل التعددية وتتسع مساحتها للاختلاف ، والحكم المستبد ليس لديه وقت ولا صبر على مطالب المناقشة !!
هكذا تبدو ” الثقافة ” أداة محايدة ، هادفة لخدمة التقدم الإنساني ، كما سنرى ، إلى أن تقع مواقعها المؤثرة : كالمطبوعات ، والصحف ، والإذاعة ، والسينما ، والتليفزيون .. بين يدي قوى التسلط المنحازة إلى نفسها ، فمن هنا يكون انحرافها المرحلي المؤثر سلبا على مجتمعها ، والمؤثر – إيجابا – في مفاهيم الثقافة ، وما نقرره هنا من أن الانحراف المرحلي لا يفسد مفاهيم الثقافة لدى الآخرين ( من أمم وجماعات ) يتأسس على استقرائنا لمسار الثقافة عبر العصور والحضارات ، بما يؤكد إيماننا بأن التجارب الإنسانية قادرة دائما على تصحيح نفسها من خلال استثمار الصواب ، كما من خلال مراقبة الانحراف . وليس في إيماننا هذا أية دعوة إلى السلبية ، تحت مظنة أن مراقبة الانحراف تلزم أو تؤدي إلى موقف المشاهدة ، لنصفق في النهاية لدخول الصّين في منظومة العالم الصناعي الأول ، وسقوط حكم النازي وانتحار جوبلز من قبل – على سبيل المثال. فإن من مطالب ” المراقبة ” تحليل مجريات الأحداث تحليلا علميا ، وربط النتائج بالأسباب ، ووضع السلبي والإيجابي في سياق دوافع الثقافة المرحلية ودوافعها الاستراتيجية ، والنتائج التي أسفرت عنها ، ومستويات التقبل ، أو المقاومة التي أبديت تجاه ما تعمل في اتجاهه من تغيير .
وخلاصة القول في هذا المفتتح أن مستويات تعريف الثقافة متباعدة جدا ، كما أن توظيف ” الثقافة ” لتأدية أهداف هي بمثابة الثقافة المضادة واردة جدا ، ولم يكن تسلط الفكر الفاشستي في إيطاليا ، والفكر النازي في ألمانيا ، والنظرية الماركسية في دول الاتحاد السوفييتي ، وغيرها ( في القرن العشرين ) وكذلك سطوة المذاهب التسلطية ، وما تمارس من قهر وإزراء وتهجين لأي فكر مختلف ، لم يكن هذا ليتجاوز كونه حربا نفسية تطرح تصورات تحشد لنصرتها كل وسائل الإغراء النفسي ، وتلصق برافضي هذه التصورات أو المشككين في صدقيتها نقائص ونقائض بقصد تخويفهم وتخوينهم ، بما يؤدي إلى خذلانهم ، أو تخذيل المجتمع عن تداول أفكارهم ، وإعادة مناقشة الأمور المستجدة في ضوء نقداتهم .
ونضيف في الختام أمرين :
أولهما : أن وطننا العربي – هذه الآونة – يعيش مرحلة من التحولات التي بدأت تظهر قسماتها ، وتسفر عن غايات قد لا تكون هي تلك التي تطلعت إليها الملايين من البشر ثاروا على القهر والتخلف وفرض الفقر على سواد الناس ، ولا تملك هذه الورقة أن تعطي ظهرها لما يصطخب حولها من ضجيج الحوارات وتصادم التطلعات ، وبخاصة ان هذه الندوة مفترق القرن : ” الثقافة العربية بين الاستشراق والاستغراب ” تتخذ من الراهن العربي ركيزة وأساسا ، من ثم يصعب جدا أن تضيق دراستنا هذه من أفق تناولها بأن تتسع إلى المدى المطلق ، وكيف يمكن إرهاق العقل والضمير بتجاهل شركاء الوطن الذين يجلون حناجرهم بالهتاف والإعلان عن أن مستقبلنا – دون كل الأمم والطوائف – وراءنا ، وأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان منذ أكثر من ألف عام ، وأن العزلة الحضارية ومخاصمة كل منجزات العصر بالتجاهل هي الحصن والأمان ؟
ثانيهما : أن كاتب هذه الورقة من المشتغلين بالشأن الثقافي ، وإن يكن محددا ببعض محاوره : الإبداع الفني والنقد الأدبي والتطور الحضاري بوجه عام ، لا يسيغ له أن يجعل همه ، أو جل همه أن يطارد التعريفات ، والمصطلحات ، وأن يقسم الظاهرة إلى مستويات من التعاقب المرحلي والتوازي والتقاطع ، دون أن تكون له إضافة مؤثرة مستخلصة من طبيعة نشاطه العقلي التأليفي ، على رجاء أن تكون هذه الإضافة إلى الهوية الثقافية نقدا لواقعنا ( العربي ) الفكري والثقافي بوجه عام .
ثانيا : تعريفات كاشفة عن مستويات :
الركنان المؤثران هما : الهوية ، والثقافة ، سواء بالعلاقة العاطفة ، أو علاقة التضايف : هوية الثقافة ، أو علاقة الموصوف بالوصف : الهوية الثقافية . وليس من شك من أن ” الهوية ” هي التي تمنح ” الثقافة ” شجرة النسب التي تحدد مسار الانتماء ، وتحرس كيانه التاريخي ، بحيث تظل ثقافة مجتمعية ذات لون ، ومذاق ، وأهداف تحول بينها وبين الامتزاج _ إلى حد التسرب والذوبان – في ثقافات أخرى . قد تكون أقوى ، أو أقدم ، أو أقدر ، أو أدخل في مطالب العصر ، أو أكثر بهرجة وإغراء . الهوية هي – على المستوى الفردي : الأب ، وعلى المستوى العام : الوطن ، لا تباع ، ولا تشترى ، ولا تستبدل ، حتى وإن كان البديل – في مرأى العين – أحلى وأبهى(5) . أما المعجم الفلسفي فله حده المنطقي لتعريف الهوية :
الهوية ( Identity ) حقيقة الشيء من حيث تميزه عن غيره ، وتسمى أيضا : ” وحدة الذات ” ، ” وهو ” : ما يقابل الأنا ، ويطلق على الغير . أما فلسفة الهوية ( Identity Philosophy )– بوجه عام– فهي كل نظرية لا تفرق بين المادة والروح ، ولا بين الذات والموضوع ، وتنظر إليهما على أنهما وحدة لا تنفصل . ويقترب ” مبدأ الهوية ” من هذا التعريف إذ يقتضي أن يكون كل معنى هو عين ذاته دائما ، وفي مختلف الأحوال ، فلا يختلط به غيره ، ولا يلتبس به ما ليس منه(6) .
إن هذا التحديد الختامي عن فلسفة الهوية : توحد المادة والروح ، والذات والموضوع ، بحيث يكون كل معنى هو عين ذاته ، لا يختلط بغيره ، ولا يلتبس به ما ليس منه . هذا التحديد قد أسيء استخدامه في عصور مختلفة ، وفسّر بكثير من العصبية وضيق الأفق بما يجعل الهوية أحيانا بمثابة ذلك الحذاء الخشبي الذي ( زعموا ) أن قدمي الفتاة الصينية كانت تحبس به لتحظى بقدمين صغيرين ، فتنتهي إلى الحصول على قدمين شائهتين !! لقد حاربت الأقليات العرقية والدينية واللغوية معاركها ضد طغيان الأكثرية وإثبات حق هذه الأقليات أن تكون لها ثقافتها الخاصة ( في إطار الوطن الواحد ) عملا بحق استقلال الهوية . كما حوربت هذه الأقليات بأنواعها المشار إليها ، من الأغلبية ، وبذلت محاولات طمس هويتها وإدماجها قسرا في هوية الأغلبية بذريعة أن ( الوطن الواحد تميزه هوية واحدة ) .
لعله يتضح الآن أن البحث في الهوية ، أو عنها ، هو الذي يفتح الطريق إلى أسئلة الثقافة : عناصرها بين الثابت ، والمتطور ، والمتغير ، وضرورات الحفاظ عليها أو نبذها، وما هو الأساسي من هذه العناصر والفرعي ، وما ليس من ذات الشجرة لكنه التصق بها ، جهلا أو تحقيقا لغاية ؟ وإلى أيّ مدى تتفق مفردات تشكيل الهوية لتقدم صورة حضارية ذات رؤية متكاملة لا تتضارب فيها القيم وتنخر في أساسها . لقد قامت دولة الخلافة العربية زمن العباسيين ، واستمرت خمسة قرون ، تناوبتها مراحل ضعف ، وتسلط عناصر غير عربية على مركز الحكم فيها ، ولكنها استطاعت أن تحتفظ بمفهوم ” الولاء ” للدولة العربية الإسلامية ، وتحافظ – إلى حد كبير – على طابعها العربي الإسلامي ، مع احتوائها لأعراق مختلفة : فارسية ، وكردية ، وتركية ، وقبطية ، وبربرية ( أمازيغية ) وأفريقية ، وحتى الشيشان والطاجيك . وقد شهد لهذه الدولة منظرون من علماء الحضارة لهم ثقلهم فيما أجروا من دراسات(7) . وهنا من الضروري أن ندرك أن الأمم ذات الوجود الحضاري الطويل تتعرض بالضرورة إلى مراحل من القوة، وموجات من بلوغ الذروة ، وأزمنة تقود فيها التقدم فتسبق – في زمانها – غيرها من الأمم ، تعقبها ، أو تتخللها مراحل من الخذلان ، والهبوط ، والركون إلى الجمود ، والرضا بالدون ، والذل والهون !! هذا أمر تدهش له أو تستغربه النظرة المتعجلة ، ولكن التأمل ودراسة تاريخ الأمم وأسباب النهوض والسقوط ( أو قيام الحضارات وسقوطها ) سيجد من الأسباب الموضوعية ما يفسّر هذا التداول في أحوال الأمم ، وكما لاحظنا في مراحل من حاضرنا الذي نعاينه ونعانيه أن الالتزام بالهوية موضع اتفاق ، ولكن العناصر المكونة لها ، والمثل الأعلى الذي يتخذ نموذجا يسعى الجميع إلى بلوغه لم يكن موضع اتفاق ، بل لم يكن فيه مساحة للتقارب أحيانا(8) ، فإذا كان المعنى ( النفسي ) العام الساعي إلى الحفاظ على الهوية المحققة لشخصية الوطن ينبعث من مبدأ الحنين إلى الماضي ، فإن هذا الوطن نفسه وقد تعرض وجهه إلى أقنعة مختلفة يحتاج إلى من يتخلّى عن أفكاره المبتسرة ، وتسلطاته المتنكرة ، وأن يتجاوز المرحلي إلى الدائم ، والقشري إلى الأصيل ، والعرض إلى الجوهر ، لتكون ” الهوية ” الحقيقية القابلة للديمومة ، المستأثرة بعوامل القوة الكامنة ، القادرة على استيعاب كافة معطيات العصر والعصور الآتية ، هي تلك التي ينبغي البحث عنها والحفاظ عليها .
الهوية – إذن – هي فكرتنا عن الأمة ، عن الوطن ، و” الفكرة ” ليست أية سانحة عارضة يدلي بها شخص أو جماعة تحت دوافع مرحلية مهما تبدو وجيهة أو براقة ، إن احترام الفكر ، وضرورة أن تكون الأفكار المعتنقة – حتى وإن بدأت فردية – من الواجب أن تعرض على محك الاختبار والتجريب ، وأن تقاس إلى أفكار الماضي ، وأفكار الأمم الأخرى قديما وحديثا ، لكي تكتسب ” الهوية ” مزيدا من القوة ، والخصوبة، بأن تملك الأفكار التي تصمد أمام هجوم الأغيار ، أو تعارض الهويات ، ومن المسلم به أن مفهوم ” القيمة ” غير قابل للمساومة ، ولا يخضع للفهم الخاص ، فالحرية قيمة ، والعدل قيمة ، وحق الحياة قيمة ، والتساوي بين البشر قيمة ، واعتناق التقدم والعمل في سبيل تحققه قيمة – وليست ” القيمة ” وساما يعلق لتجميل الكلام ، ولكنها قوة دفع هي التي تمنح الأفكار نفاذها وتأثيرها . يقول ” بيوري ” – في مقدمة كتاب : ” فكرة التقدم “: ” عندما نقول : إن الأفكار تحكم العالم ، أو تحدث تأثيرا حاسما على التاريخ ، فإن ما نعنيه – بوجه عام – هو تلك الأفكار التي تعبر عن أهداف إنسانية ، المعتمدة على الإرادة الإنسانية في تحقيقها ، ومن أمثالها : الحرية والتسامح والمساواة في الفرصة …(9) ” ، ويستكمل تشارلز بيرد حديث المؤلف فيما كتب من تمهيد يحفزنا على ضرورة أن نتمعن في أفكارنا قبل أن تنعقد عليها عقولنا وقلوبنا ، لأن الفكرة – في ذاتها – تنطوي على قوة دينامية دافعة . يقول :
” تحتوي أية فكرة على قوة كامنة فيها ، ولا يقصد بذلك أية دلالة غيبية ، فكما قال فوبيه : إن المقصود هو الصورة الواعية التي تتخذها مشاعرنا ودوافعنا . فكل فكرة لا تعني فعلا فكريا فحسب ، ولكنها تعني أيضا اتجاها معينا في عالمي الإحساس والإرادة. ومن هنا ، فإن لكل فكرة في حالة المجتمع ، وكذا في حالة الفرد ، قوة تنزع بلا توقف إلى تحقيق غاياتها الخاصة بها . بعبارة أخرى : ليست الفكرة مجرد معنى ذهني ، ولكنها تحتوي في ذاتها على قوة دينامية قادرة على أن تحرك الأفراد ، والشعوب ، وتدفعهم إلى الاتجاه لتحقيق الغايات ، وخلق الأنظمة التي تساعد على ذلك(10) ”
ولعلنا – بهذا العرض المركز لما تعنيه ( الهوية ) وما تؤدي إليه من قوة حال التوسع والمرونة في فهمها ، وما تثير من قلق وشروخ في بناء الأمة حال التضارب في فهم جوهرها وتحديد مطالبها – نكون أقرب إلى فهم أن الهوية ليست اختراعا ، وليست حلما يتحقق بالتمني ، ولكنها قراءة مستخلصة بوعي من الماضي ، وموجهة بفهم إلى المستقبل ، ويمكن أن نطبق هذا الإطار ( المحتوي للهوية ) على قراءتين للماضي ، وإن كانا يخصان الهوية المصرية أكثر مما يعبران عن غيرها ، فإن توجهات الفكر وقراءة التاريخ تمنحنا أساسا يمكن أن يستعان به بالتوسع وتلمس الأشباه أو الاختلافات .
القراءة الأولى قام بها طه حسين حين أصدر كتابه ” مستقبل الثقافة في مصر(11) ” ( ونلاحظ هنا أمرين : أنه اتخذ من هوية مصر أساسا ومنطلقا لتقديم تصور ” مختلف ” لثقافتها السائدة – الثاني : أن هذا الكتاب أثار معركة فكرية لا تزال تهب بين حين وآخر كلما طرح شأن من شؤون الهوية أو التكوين الثقافي المصري ، وهو بهذه القدرة الفائقة ينافس كتابه السابق : الشعر الجاهلي ) . وخلاصة رؤية طه حسين لشخصية مصر الحضارية / الثقافية : أنها قبلت الإسلام دينا ، وتكلمت العربية ، ولكن هذا لا يستلزم بالضرورة أن تحبس نفسها في إطار ثقافة الجزيرة العربية وما تعتنق من قيم البداوة ، لأن مصر – تاريخيا وجغرافيا – ترتبط بدول حوض البحر المتوسط ، وهذا هو محيطها الثقافي المشكل لهويتها الحضارية . يبدأ طه حسين من الحضارة وما تنهض عليه من الثقافة والعلم ، ويرى في تراجعهما ضياع الأمة ذاتها : ” ولولا أن مصر قصرت طائعة أو كارهة في ذات الثقافة والعلم لما فقدت حريتها ، ولما أضاعت استقلالها(12) ” ثم يؤسس سؤال الهوية على ما أشرنا إليه في فقرة سابقة : ” إن مصر الجديدة لن تبتكر ابتكارا ، ولن تخترع اختراعا ، ولن تقوم إلاّ على مصر القديمة الخالدة ، وبأن مستقبل الثقافة في مصر لن يكون إلا امتدادا صالحا راقيا ممتازا لحاضرها المتواضع المتهالك الضعيف .. ومن أجل هذا لا أحب أن نفكر في مستقبل الثقافة في مصر إلاّ على ضوء ماضيها البعيد وحاضرها القريب..(13) ” ثم يطرح السؤال الفارق المثير : أمصر من الشرق أم من الغرب ؟ وأنا لا أريد بالطبع الشرق الجغرافي والغرب الجغرافي ، وإنما الشرق الثقافي والغرب الثقافي (14) ” ثم يعقب بطرح السؤال الذي يتحدّى التأويل : ” أيهما أيسر على العقل المصري : أن يفهم الرجل الصيني أو الياباني ، أو أن يفهم الرجل الفرنسي أو الإنجليزي ؟(15) ” ويمهد بذكر هذه ” المفارقة ” بأن يستقرئ التاريخ فيقرر أن قدماء المصريين لم يتصلوا – في الاتجاه شرقا – بما يتجاوز ما يسميه الآن : فلسطين والشام والعراق ، أي أنه الشرق الذي يقع في حوض البحر المتوسط ، ثم يمضي إلى ” فارس ” وقد كانت علاقة مصر القديمة بها علاقة حرب وخصام ، في حين اتصل العقل المصري – منذ أقدم العصور بالعقل اليوناني ، وكان اتصال تعاون وتوافق ومنافع متبادلة في الفن والسياسة والاقتصاد ، وكان العقل المصري ملهما لليوناني ومستلهما منه ما بين عصر وآخر ، ” فإذا أردنا أن نلتمس المؤثر الأساسي في تكوين الحضارة المصرية وفي تكوين العقل المصري ، وإذا لم يكن بد من اعتبار البيئة في تقدير هذا المؤثر .. من الحق أن نفكر في البحر الأبيض المتوسط ، وفي الظروف التي أحاطت به ، والأمم التي عاشت حوله .. فإذا لم يكن بد من أن نلتمس أسرة للعقل المصري نقره فيها، فهي أسرة الشعوب التي عاشت حول بحر الروم ، وقد كان العقل المصري أكبر العقول التي نشأت في هذه الرقعة من الأرض سنا ، وأبلغها أثرا(16) ” ، ثم يتحرك هاجس في فكر عميد الأدب فيضيف بعد قليل عبارة دالة ، وتهمنا فيما نحن بصدده من تلمس تلك الأسس التي تقام عليها الدول ، وتتحدد الهوية ، فيقول : ” ومن المحقق أن تطور الحياة الإنسانية قد مضى منذ عهد بعيد ، بأن وحدة الدين ، ووحدة اللغة ، لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية ، ولا قواما لتكوين الدول (17) ” . أما ذلك ” الهاجس ” – الذي ألمحنا إليه فإنه يستخلص من تحديده للدين واللغة ، وكونهما ( لا يصلحان ) وربما كان الأوفق والأقرب إلى الدقة وما شهد به تاريخ الأمم أنهما ( لا يكفيان حال انفرادهما ) ، ولقد كان طه حسين – كما يبدو لنا – يعيد قراءة علاقة مصر بالثقافة العربية جملة ، ودورانها في محيط الموروث القادم من الجزيرة العربية ، كما كان يفتح طريقا أو يوسّع طريقا – لأنه كان مفتوحا منذ عصر محمد علي ، ولكن بتحفظ وتحوط وحذر في مجال العلوم الإنسانية والفنون خاصة – للالتحام الحميم بالحضارة العصرية في مهادها الغربي ، وكان العميد يدرك أنه لا حجة يملكها الحريصون على بقاء مصر في الدائرة العربية غير الحفاظ على الدين ، والاحتفاظ باللغة ، إذ كان من الواضح تماما أن مصر قبل الفتح العربي وبعده ، كانت الأكثر تقدما وتحضرا من بين أقاليم الدولة الإسلامية .
هذه خلاصة القراءة الأولى لهوية مصر ، أما القراءة الأخرى ( المقابلة أو المضادة ) فإنها تقتحم محاذير منهجية لتنتصر للإنتماء العربي ( القومي ) الإسلامي ( الديني ) وهذا الاقتحام المنافي للمنهج ولحقائق التاريخ هو التعامل مع التاريخ المصري بدءا من قدوم جيش عمرو بن العاص إلى مصر ( 18 هـ ) وكأن هذا ( الحادث ) على أهميته البالغة وما ترتب عليه من آثار ماثلة إلى اليوم يعطي رخصة بإنكار ثلاثين قرنا من بناء الحضارة ، وتأصيل الثقافة ، عبر عصور تميزت بأن أضافت للهندسة ، والطب ، والزراعة ، فضلا عن النظام الاجتماعي ، والعسكري ، والفكر اللاهوتي ما لا يمكن جحده بدءا من عصور الأسرات ( الفرعونية ) وحتي العصر اليوناني ( البطلمي ) والروماني ، ثم القبطي ( المسيحي ) وقد امتد إلى ستة قرون ، كيف يمكن ” إلغاء ” هذا الامتداد الزاهر أو كيف يمكن تضمينه ( قسرا ) في الألف سنة الأخيرة من عمر مصر ؟ إن دعاة القومية العربية كانوا أكثر قدرة على إعادة ” تكييف ” الماضي ، بأن لم يجد بعضهم حرجا في أن يعيد أصول قدماء المصريين إلى عرب الجزيرة ، مسترشدا بالهكسوس معتبرا أن زحفهم على مصر كان أمرا له سوابق في أزمنة سحيقة(18) ، أما المتعصبون لمذهبهم في فهم الاسلام وتاريخه فإنهم يرفضون العصور المصرية قبل عمرو بن العاص ، جملة وتفصيلا ، ويستهينون بل يهجنون كل منجزات تلك العصور( دون أن يعرفوا عنها شيئا ) لأن معتنق هذه القراءة لا يريد أن يكون الدين ( الإسلامي ) عقيدة ، ولا يريد باللغة العربية أن تكون أداة اتصال وحياة وإبداع . إنه لا يقنعه إلاّ أن يكون الدين عقيدة وشريعة وحياة وممارسة يومية تتخلل كل الشؤون ، ويرى أن حياة لغته مرهون بانفرادها وإعدام فرص المشاركة فضلا عن المنافسة ، من ثم تتحول ” الصحوة ” – وهي شعار مطلوب ومحبوب ، إلى نوع من العودة إلى الماضي ( الديني ) الذي يرتبط – في عقائد الوعاظ والمذكرين – بشخصيات كان لها أثر حميد ووعي بحركة الزمن قياسا إلى المتاح في زمانها ، وكأن ” الموقف ” التاريخي يمكن استعادته ، و” الشخصية ” التاريخية قابلة للتكرار بشروط بزوغها السابق ، وهذا مما لا يمكن حدوثه .
من المهم الاعتراف بأهمية ( الدين ) في تعميق الهوية وحراستها ، فالأديان – على اختلافها تمثل اتجاهات ثقافية ورمزية وفكرية ، وتعكس التنوع في التجربة الإنسانية وتباين السبل التي يتخذها البشر للتعامل مع وعد الحياة الإنسانية وتحديها ومأساتها . وهناك أشكال جديدة للأصولية (التي ينبغي أن نطلق عليها : الصحوة الدينية) وللبحث عن الدين عامة ، وكما يقول تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية – يمكن اعتبارها ظواهر إيجابية بناءة ، فهي تمثل بحثا عن الهوية والمعنى في عالم قاسٍ تتصارع فيه القيم ، ورد فعل لأزمة الانتماء ، وحقلا للتجاوب الثقافي الاجتماعي(19) . وهذا الرأي المتفهم لطبيعة المرحلة ومشكلاتها يحسن الظن بالدعوة الأصولية ، أو الصحوة الدينية ، وهذا حقها بصفة عامة ، وينبغي أن ينصرف الوصف إلى الصحوات الدينة لدى أصحاب الأديان المختلفة ( فليس القول هنا موجها إلى الدعوات الأصولية في العالم الإسلامي كما سنرى في الشواهد ) غير أن بداية هذه الصحوات وأهدافها (النظرية) المبكرة كثيرا ما تخالف ، بل تناقض ما تصير إليه أمورها بقوة الدفع ( الزمني ) وقوة الحشد البشري وراء الفكرة ، وهذا ما يفهم من فقرة في ” تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية ” جاءت تحت عنوان : ” الصحوة الدينية : تعصب أم بحث عن معنى ؟ ” وتعقيبا على ما اقتبسناه سابقا يقول التقرير : ” يتبين من التاريخ أن الدين غالبا ما يرتبط بالوعي بالهوية القومية ، وأحيانا ما يؤثر على العلاقات بين الأغلبيات والأقليات ، وغالبا ما يتخذ ذريعة للغزو المادي أو الإقليمي ، كما يسهم الدين – إذا اصطبغ بالسياسة – في زيادة حدة الصراع أكثر من إسهامه في بناء السلام ؛ ومن الأمثلة على ذلك : الصراع بين الهندوس والمسلمين في الهند ، وبين الشيعة والسنة في العراق وباكستان ، وبين البروتستانت والكاثوليك بأيرلندة الشمالية . إن الآراء النظرية المتطرفة تنظر إلى ماض في الخيال ، وتراه أكثر بساطة واستقرارا ، وبالتالي فهي تمهد الأرض لمختلف أعمال العنف ولتخويف الأفراد ، بل مجتمعات بأسرها في أمور الفكر والسلوك والمعتقدات ، وتقهرها على قبول وجهة نظر أصولية واحدة . إن أواخر القرن العشرين قد شهدت استشراء الأصولية المسيسة في كل الأديان(20) ” إن هذه الملاحظة الأخيرة عن ” تسييس الدين ” قد تؤدي إلى القول بأن الدين ” المسيّس ” قد انقلب على نفسه وناقض جوهر رسالته ، وقد بذل عالم الاجتماع ” دوركايم ” جهدا تحليليا في قراءة مبدأ ” الدين ” منذ عصر الأساطير والطواطم وحتى عصر الديانات البشرية والسماوية ليثبت أن وظيفة الدين هي ” تقوية الأواصر التي تربط الفرد بالمجتمع الذي هو عضو فيه ، وهذا ما يستنتج من مراقبة أشكال الممارسة والمعتقدات الدينية التي تتنوع ما بين مجتمع وآخر ، فإنها تحقق الوظائف ذاتها في كل مكان ، وتحديدا :دمج الفرد في الجماعة الاجتماعية(21). لا يغيب عن بالنا أن دوركايم يعنى الدين الواحد في المجتمع المحدد ، ومع هذا نرى أن المبدأ ذاته يمكن أن يؤدي وظيفته في مجتمع متعدد الأديان ، إذا ما جرد المعتقد الديني من تداخل السياسة ، ومن النظر إلى الدين على أنه ” استئثار ” دنيوي قبل أن يكون أخراويا ، بما يؤدي إلى أنه لكي يفوز فريق فلابد أن يخسر الفريق الآخر !!
وهناك تحليل طريف ، يجمع بين مراقبة الواقع والتحليل السيكولوجي لنزوع الطبقات تجاه الدين . قال بهذا ماكس فيبر Max Weber ( 1864 – 1920 ) إذ يتساءل : لماذا تنتشر الديانات التي يبشر أنبياؤها بالخلاص بين الشرائح الاجتماعية الأقل حظوة ؟ هنا يبدو الطابع الوظيفي جليا في الإجابة ، إذ يرى أن المضطهدين والمهمشين سيكونون دائما بحاجة إلى مخلص ونبي يعدهم ويمنّيهم بأن حياتهم في الآخرة ستقدم إليهم التعويض عن معاناتهم في الدنيا .. أما أصحاب الحظوة والسلطة فليسوا بحاجة إلى هذا ، غير أنهم مستمسكون بالدين كذلك ، لأن هؤلاء الأقوياء بحاجة بحاجة إلى اعتقاد مقدس يسري على الكل ، ويضفي مع هذا – الشرعية على نمط حياتهم ومركزهم !! ويعلل فيبر أن المحظوظ نادرا ما يكون قانعا بحقيقة كونه محظوظا ، إنه يريد أن يطمئن نفسه بأن له الحق في حظوته وتميزه ، وأنه يستحق هذا في مقابل الغير ” فالقدر الإلهي لابد أن يصبح هكذا قدرا شرعيا(22) ” . وتربط بعض الدراسات بين القدرية الدينية والسلبية السياسية ، فمع التسليم بالأولى وما يترتب عليها من أنه ليس للإنسان من إرادة في توجيه مصيره أو جدوى مقاومته لما لا يريد ، يسهل عليه التهاون في حقه في الديموقراطية والخنوع للنظم السياسة السلطوية ، ” فالشعب الذي ينسحب من الحياة السياسية يوسع نطاق ممارسة القوة الحكومية التحكمية ، مما يغذي – بالتالي – انسحاب المواطنين من السياسة ، ويتسبب هذا النمط من التكرار الذاتي في إفراز نظرة ضارة بالديموقراطية في المجتمعات التي تسود فيها ثقافات سياسية قدرية(23) ” .
ثالثا : معنى الثقافة .. وحدودها
هذه الكلمة الأكثر دورانا على ألسنة المثقفين ، والصفة التي يرغب الجميع إلى أن يوصف بها مهما كان حظه منها ضئيلا ، تثير القلق لدى الباحثين ، وتبدو حدودها زئبقية، قابلة للاتساع والانكماش تبعا لخصوصية المعنى أو عموميته ، وقد تغني عبارة ” ناثان جليزر ” عن قول يسهب في هذا إذ يقول : ” إن أحد أسباب النفور من التصدي لموضوع الثقافة هو أنه يمسّ أعصابا شديدة الحساسية ، وهي الأعصاب القومية ، والعرقية ، والتقدير الشخصي للذات . يتجلى هذا عند الحديث عن فكرة تقضي بأن بعض الثقافات خير من بعضها الآخر ، على الأقل من حيث إنها تسهم أكثر في دعم وتعزيز الرفاه البشري(24) ” .
هناك ما يمكن إضافته إلى العبارة السابقة ، ” فالثقافة ” ليست موضع اتفاق على مدى أهميتها في صنع المصير أو المصائر بين الحضارات والأمم ، وهناك ثقافة غالبة وثقافة مغلوبة في الزمن الحالي ، ولكن ماضي كل منهما كان على النقيض من ذلك ، ومن شأن هذا – حين تلتهب حمىّ التنافس أن يصطدم التاريخي بالراهن . وفي الفقرة السابقة عن ” الهوية ” أخذ الدين موقع المحرك للثقافة في اتجاه الحفاظ على الهوية ، وهكذا تتصادم الأقوال المأثورة ، فإذا كان ينسب إلى القديس أوغسطين قوله : ” إذا كنت في روما افعل ما يفعله أهل روما(25) ” وهذه دعوة إلى التكيف والمرونة في التعامل مع المختلف ، فهناك من يرى أن عناصر الهوية متماسكة ، وأن أي تغيير يلحق بأي عنصر ثقافي هو تنازل – ( مؤكد ) عن عناصر أخرى(26) !! فقد يكون للمثل الشعبي ( المصري ) الذي يربط بين اللغة والدين : ” من غير لغته غير دينه ” أساس معرفي حضاري لا يختص بلغة معينة أو دين محدد ، فالربط بين الهوية الحضارية واللسان اللغوي لم يكن خاصية انثربولوجية موقوفة على العرب ، بل كان سمة إبستمية ( معرفية ) مشتركة بين جميع الثقافات الكبرى(27) ، ولعلنا نكتفي بهذا التمهيد لنتلقى تعريف الثقافة ، أو تعريفات الثقافة ، وكما سنرى فإن امتداد الزمن ، وتطور علاقة الإنسان بالكون ، وتعدد أصقاع الأرض ، ومن ثم تعدد الحضارات ، لابد أن يترك أثره على التعريف :
- يبدأ تعريف الدكتور فؤاد زكريا للثقافة من مسلمة أن هذه الكلمة الأكثر تداولا هي الأشد غموضا ، ولكنه يخرج من المعاني المتعددة بمعنيين رئيسيين : الأول : الثقافة كما يستخدمها علماء الاجتماع ، ويمكن تعريفها بأنها ذلك الكل المعقد الذي يشمل المعرفة ، والاعتقاد ، والفن ، والقانون ، والأخلاق ، والعرف ، وأية قدرات وعادات أخرى يكتسبها الإنسان بوصفه فردا في المجتمع . ويقترب من ذلك التعريف الوارد في قاموس أكسفورد – والعبارة لفؤاد زكريا – بأنها : الاتجاهات والقيم السائدة في مجتمع معين ، كما تعبر عنها الرموز اللغوية ، والأساطير ، والطقوس ، وأساليب الحياة ، ومؤسسات المجتمع التعليمية والدينية والسياسية .
الثاني : الثقافة بالمعنى الإنساني الرفيع ، ويمكن تعريفها بأنها صقل الذهن ، والذوق ، والسلوك ، وتنميته وتهذيبه ، أو بأنها : ما ينتجه العقل أو الخيال البشري لتحقيق هذا الهدف . ويلاحظ أن هذا المعنى يرتبط بالأصل اللغوي لكلمة Culture في اللغات الأجنبية ، وهي كلمة تعني تعهد النبات وحرثه ورعايته حتى يثمر ( منها جاءت كلمة زراعة Agriculture ) بل إنه يرتبط بهذا المعنى نفسه في اللغة العربية ، لأن الأصل ” ثقف ” يحمل معنى التهذيب والصقل والإعداد . وهنا تكون الثقافة عملية رعاية وإعداد مستمر للعقل والروح البشرية. أما معناها بوصفها منتجا يؤدي هذه الوظيفة فلم تكتسبه إلاّ فيما بعد(28) .
يمكن أن نلاحظ في التعريفين المقابلة بين الثقافة كبعد اجتماعي ، والثقافة كسمة فردية ، ولكن فؤاد زكريا – بطبيعة تكوينه السياسي – لا يركن إلى هذين النوعين، وإنما يستخرج منها نوعا ثالثا وسطا ، يطلق عليه : الثقافة الشعبية ، وهي تلك التي تتعلق بنواتج وأعمال ثقافية يقوم بها متخصصون – مهما كان مستواهم ، وليست مقتصرة على القيم والعادات وأساليب التفكير التي يتلقاها المرء تلقائيا من المجتمع ، ولكنها – أيضا مختلفة ، كما يدل اسمها – عن الثقافة الرفيعة ؛ لأنها ترضي ذوقا شعبيا واسع النطاق . وتتأكد نزعة الكاتب (اليسارية ) في إضافة إنسانية دمثة ، إذ يقرر حكما قيميا فيقول : ” بطبيعة الحال فإن المثل الأعلى للثقافة ، في أي مجتمع ، هو إزالة الحد الفاصل بين الثقافة الرفيعة والثقافة الشعبية أو تخفيفه ، بمعنى أن تكون هناك ثقافة عالية تقدم – على أوسع نطلق ممكن – لجماهير قادرة على تذوقها(29) ” .
- في مقدمة كتاب : ” الثقافة والمجتمع ” يربط مؤلفه ( رايموند وليامز ) بين خمسة ألفاظ استخدمت لأول مرة ، وألفاظ أخرى نشط استخدامها وتوسع في اللغة الإنجليزية المتداولة – في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر ، والنصف الأول من القرن التاسع عشر ، وهذا يدل على تغير واضح في الحياة والفكر على السواء . أما المفردات المستجدة فهي : صناعة ، وديمقراطية ، وطبقة ، وفن ، وثقافة . ومع ترجيحنا بقوة الربط والتناغم بين هذه المفردات الخمس فإننا نترك هذا الجانب لقارئ الكتاب ، اكتفاء بما ذكر عن ” الثقافة ” ، التي كانت تعني من قبل تهذيب شيء ما ، إلى أن أصبحت تعني شيئا مستقلا ، كما أصبح معناها أولا: حالة أو عادة عقلية عامة ، ترتبط ارتباطا وثيقا بفكر الكمال الإنساني ، وغدت تعني ثانيا : الحالة العامة للتطور الفكري في مجتمع بأسره ، والمعنى الثالث هو الكيان العام للفنون ، وفي أواخر القرن ( الثامن عشر ) أصبحت تعني معنى رابعا هو طريقة شاملة للحياة : مادية ، وعقلية ، وروحية . ومن المهم أن نذكر أن التغيرات التي لحقت لفظة ” فن ” كانت ذات استجابة وثيقة الصلة بالثقافة . ولهذا مغزاه بالطبع . وكذلك كانت ” الثقافة ” قد تخطت أن تكون استجابة للاتجاه الصناعي ، إذ كانت ذات امتداد واستجابة للتطورات السياسية والاجتماعية الجديدة ، أي الديموقراطية ، وكانت أيضا في ارتباطها بهذا الوضع استجابة جذرية ومركبة للمشاكل الجديدة المتعلقة بالطبقات الاجتماعية ، كما أصبحت ذات صلة بمجال الخبرة الشخصية التي تبدو خاصة ، والتي أثرت تأثيرا ملحوظا على معنى الفن وممارسته ، وتلك هي المراحل الأولى لصياغة فكرة الثقافة ، كما يرى رايموند وليامز ، وقد توسعت حتى أصبحت ” طريقة شاملة للحياة(30) ” . وفي خاتمة هذه الدراسة يقول رايموند وليامز : ” إن تاريخ فكرة الثقافة هو سجل لردود أفعالنا – فكريا وشعوريا – للظروف المتغيرة في حياتنا العامة . وما نعنيه ” .
- إن الدلالة اللغوية لأصل كلمة ” ثقافة ” أو ” Culture ” أو ما يماثلها في لغات العالم – قديمها وحديثها – تدل على تطور المفاهيم ، وتوسع الدلالة واستجابتها لمستحدثات الحضارة ، وما يتبع هذا من اختلاف أساليب الحياة ( العملية والسلوكية على السواء ) وسنلتقي بتنظيرات للثقافة هي صدى لعقائد سياسية وأفكار فلسفية ستغني تعريف الثقافة ، وإن لم يكن معتمد هذه التنظيرات الفكر الاجتماعي أو التطور الحضاري .
وهذا آشلي مونتاغيو – العالم الانثربولوجي الأمريكي – يلفت انتباه الباحثين في تحديد العناصر المكونة للثقافة ، الداخلة في تعريفها بالضرورة ، إلى خطأ تصور محتمل أو انحرافه عن المعيار إبان تحديده لمفهوم ” البدائي ” في مقابل المثقف العصري ، فيصف بعض الثقافات البدائية بأنها كانت من بعض الوجوه أشد تطورا من أكثر الثقافات المتمدنة، وهي لهذا ” أفضل ” من الثقافات المتمدنة حسب المعايير التقويمية السائدة حول هذه الأمور في المجتمعات المتمدنة . ويقدم العالم الانثربولوجي مثالا بما يتصف به الاسكيمو والاستراليون الأصليون ، ففيهم كرم ، وود ، وتعاون أكثر من اتصاف غالبية أعضاء المجتمعات المتمدنة بهذه الخصال، بمعاييرنا نحن حول هذه الأمور(31) . كما يضيف بعض ” الأضواء الجانبية ” المهمة على تصور علاقة الثقافة بالزمن ، وبالمكان ، إذ يشكك في أن الإنسان ” البدائي ” أقرب شبها بالإنسان ” القديم ” ، ذلك لأن المجتمعات لا تتحجر ، فكلها يتغيّر ، غير أن معدلات التفاوت تختلف ، فتسرع أو تبطئ من حيث تتأثر بالتجارب التي يتعرض لها كل مجتمع ؛ فاللغة ، والدين ، والعادات ، والتكنولوجيا لا يمكن أن تبقى على حالها مهما بدا لنا ذلك ، إنها تتغير ، ولكن ” المجتمعات المنعزلة عن مجرى التغير الثقافي الرئيسي تتغير ببطء ، أما تلك التي تتعرض للتأثيرات المخصبة الناجمة عن تبادل التأثيرات الثقافية مع الشعوب الأخرى فإنها تتغيّر بسرعة .. لذلك يمكننا القول بثقة إنه ليس هناك من ثقافة نعرفها اليوم هي على ما كانت عليه في العصور الغابرة(32) ” ، وهنا يضيف آشلي مونتاغيو إضافة جديرة بالتفكر بقوله : إن البيئة تضع في العادة حدودا لا تستطيع الثقافة تخطيها، ما لم تتطعم بتغييرات جذرية تأتيها من الخارج(33) . يمكننا – من ثم إرجاع أسباب التفاوت الحضاري بين الأمم إلى اختلاف الموقع الجغرافي ، ومن المسلم به من خلال الاستقراء : أن الحضارات الأولى التي تأسست على مجتمعات متحضرة إنما نشأت على ضفاف الأنهار ، وأن المناطق التي تقع على بحار مفتوحة ومواصلات ميسرة أسرع في وتيرة التقدم من المناطق المغلقة أو النائية عن حركة العالم من حولها ، كما يمكننا القول بأن محاولة استعادة الماضي البعيد أو القريب بكل حذافيره أمر غير ممكن ، يدخل في نطاق الأحلام والأوهام ، وتأملات اليوتوبيا المغتربة إلى الماضي ، لأن هذه المحاولات تتنكر لمبدأ تدافع الزمن ، أو تأثير الماضي في الحاضر ، فهذا ” التأثير ” قد ترك أثره ، وامتزج بالنفس ، واستخلصته الممارسة، مما يعني أن العودة عنه ستكون ضد الطبيعة وقوانين التطور التي تستهدي مبدأ ” الانتخاب الطبيعي ” !! وها هنا ” إشكالية ” جديرة بالتوضيح ، ففي مثال سابق ذكر الباحث الأنثروبولوجي أن ” الشخص ” من الاسكيمو – على سبيل المثال – أرقى ثقافة من إنسان عصري يعتنق مبدأ المنفعة والأنانية والحذر وإضمار التوجس من الآخرين ، وهذا حق ، حين نوازن بين فردين وليس بين مجتمعين ، فحركة الزمن وقدرات العقل لم تتوقف عن الكشف ، فإذا كان المثل الذي قدمه ” مونتاغيو ” عن أن الحفر بالماكينة أفضل – لاشك – من الحفر بالفأس أو العصا ، فإنه – في زمن قادم _ سيكون الحفر بالماكينة بطيئا متخلفا ( بدائيا ) أمام وسائل سيتم الوصول إليها . ومن المقبول أن يقال إن التغير ( أو التطور ) المادي يختلف عن نظيره في مجال الأخلاق والاعتقاد والسلوك العام ، ولكن غير المقبول الزعم بأنه يناقضه ، وأن هذه الجوانب ( الإنسانية ) قابلة للتحجر ، أو يمكن إنكار المنجز منها والعودة إلى الوراء !!
- ويكتمل ما عرضنا له بتأكيد دراسات جادة عن ” الجغرافيا الثقافية ” بالقول بأن الثقافة مهما كان من تفاوت بين تحديدها – لا يمكن معالجتها إلا باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أوضاع الحياة الواقعية بطرق دقيقة في الزمان والمكان ، وإن لم ينكر أن الواقع المتخيل هو حقيقة فوق الوقائع المادية قد يتجاوز أو يحتوي على الحقيقة أكثر من الواقع اليومي المادي ، وذلك إذا احتكمنا إلى الفنون والآداب : القصائد والرسوم والأفلام ، كمنتج ثقافي يعبر عن عصر أو زمن متطلعا لعصر أو زمن آخر لا يزال في ضمير الغيب(34) . وهنا إضافة لحليم بركات تبدأ بترديد ما بدأ به فؤاد زكريا من تعريف وما أضاف الباحثون إلى مقولته ، ثم يصل إلى ما تعنيه ” أصالة الثقافة ” ، فإنها لا تعني مجرد التمسك بالأصول ، بل تعني الثبات والديمومة أو الاستمرار والصيرورة معا ، لأن الثقافة– حسب دوركايم – خارجة عن الأشخاص الذين يمارسونها ، فنحن لا نتحدث عن العديد من الأشخاص الذين يمارسون عادة الزواج ، بل نتحدث عن ظاهرة الزواج في المجتمع ، أي مظاهرها وثوابتها ومتغيراتها وخصائص الأشخاص الذين يتزوجون في المجتمع .
ويستنتج بركات أن الثقافة العربية ليست جوهريا ” ثقافة تقليدية ” بل هي ثقافة صراع بين القديم والجديد ، ففي كل عصر من العصور هناك نظام سائد يمثل مصالح وقيم طبقات وجماعات ميسورة ، وحركات أخرى تمثل مصالح وقيم طبقات وجماعات محرومة ، ثم يخلص من هذا القول إلى أن ما يحدد الثقافة العربية خاصة في هذه المرحلة الانتقالية هو الصراع بين اتجاهات قيمية متناقضة. مثل هذا الوضع قائم كذلك في الحياة الإبداعية وفي الحوارات الفكرية المختلفة .
ويضيف ثروت إسحاق في دراسته عن ” حدود علمية الثقافة ” بعض ملاحظات تغادر ” العام ” إلى ” خاص الثقافة العربية ” : واقعها الراهن ، مستمدا بعض مقولات حسن حنفي :
” يرى البعض أن الثقافة الشعبية هي الرابطة بين التراث – الذي يضم النصوص الدينية والأمثال الشعبية ونسق القديم – والتغير الاجتماعي الذي يعمل علي أن يتحول التراث إلى ثقافة شعبية ، ففي المجتمعات التراثية تكون أنساق القيم هي الباعث الحقيقي على السلوك الاجتماعي ، إذ إنه من الملفت للنظر أن هناك صورة واضحة للصراع بين الدين والعلمانية في الكثير من بلدان الوطن العربي ، حيث يتساءل حسن حنفي هل من الممكن إيجاد أرضية مشتركة بين التراث والعلمانية ؟
فأصحاب فكرة السلفية يصفون من يدافعون عن التقدم بالتغريب والانحراف ، بينما يصف الذين يرفعون راية التقدم أقرانهم الذين يدافعون عن السلفية بأنهم يقفون بصرامة ضد التغيير الاجتماعي ، ويجاهد بعض الثقاة لتطوير قوى التغير الاجتماعي والسياسي ونسق القيم برمته ( بما يتضمنه من أبعاد دينية ) حتى يؤثر بفاعلية في التراث والثقافة الشعبية من خلال القضايا الأساسية كالحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية(35) .
رابعا : تنظيــر الثقـــافة
من المتوقع أن تخضع الظاهرات الثقافية لأفكار فلسفية وتنظيرات أيديولوجية ، إذ لا يتصور أن حضور الثقافة وأثرها في تشكيل المجتمع ، وإقامة الفروق بين الطبقات ، وبين المجتمعات وبين الحضارات .. يصعب أن يظل محاصرا بمناهج الأنثروبولوجيين من جانب ، وعلماء الاجتماع من جانب آخر متسق أو مكمل أو مناقض . وكما أن للفكر دوره في تحليل الظاهرة فإن للنظريات السياسية طموحها لتفسير ما كان وتكييف ما ينبغي أن يكون بقصد الانتصار للنظرية السياسية .
وإذا كان من الممكن – بداهة – أن تكون للثقافة صلة تفاعل بالشعور الديني أو اتصال عضوي بالشعور القومي فإن صلة الثقافة بالتنمية الاقتصادية تبدو مجرد افتراض في حالات كثيرة ، في حين أن الثقافة كانت العامل المؤثر والحاسم في نهضة أقطار كانت تنتمي إلى التخلف ( مثل جيرانها ) فلما قيضت لها قيادات وظروف غيرت من النمط الثقافي السائد تحققت التنمية في زمن وجيز ، وانتقلت بهذه الأقطار من وهدة التخلف ووصمة العالم الثالث إلى صيغة البلاد المتقدمة ، المنتجة ، التي تقدم لعصرها نموذجا من الثقة بالنفس وعظمة الإرادة ونجاح الإدارة لتحقيق الغايات الصعبة ، وتوفير الحياة الرخية لأهلها .
إن النموذج الحاضر لصناعة التقدم ماثل – عادة لدى الباحثين – في تجارب اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا .. وغيرها . ولكن أول الرؤى الفلسفية تفجر أمام النظر تجارب قديمة جدا ، تؤكد أن ” فكرة التقدم ” إحدى أهم الأفكار المستقرة المتوارثة في العقل وفي الخيال الإنساني ، وهذا مما يؤكد بدوره أن الأمم التي تستسلم لتخلفها حرّية بأن تفتش في أنساق قياداتها ، وخطط عملها ، وستبدو لها مغلقة على موروثها ، معاندة في قبول الجديد ، تغلق الباب أمام احتمالات التجديد ، وهذا يتأتى بفساد الحكم التسلطي ( الدكتاتورية ) الذي لا يعنيه إلا خدمة ذاته وانتشار الخوف من سطوته والرضا بالاستسلام الذليل له ، أو فساد الإدارة ( ولدينا الآن مصطلح : ثقافة الفساد ) الذي يملك عصا سحرية شريرة قادرة على إفساد كل شيء وتبديد أثره الإيجابي وتحويله إلى أداة تعطيل(36) . في دراسة عن ” فكرة التقدم ” – سبقت الإشارة إليها ، من تأليف : ج . ب . بيوري – يرى أن التاريخ ليس مجرد استمرار لعملية التطور في الطبيعة ، فهناك الإنسان المتطلع دائما ، وعندما سطعت فكرة التقدم انقضّت على فكرة الدائرة المفرغة ، أو القناعة بالسكون أو الثبات ، وعندما بسط ” دارون ” نظريته فإن هذا عزز نظريات التقدم الإنساني التي كان المؤرخون قد نهضوا بها بالفعل ، وقد سبق الخيال الفكر في هذا المجال ، فغزت مخلوقات الفضاء ، وغزا هرقل الجحيم ، وبحث جلجامش – من قبلهم – عن الخلود والقوة ، ثم كان ” عصر النهضة ” في أوروبا ، وقد كان من أهم منجزاته ، كما يقرر بيوري : أن العقل الإنساني استعاد ثقته بنفسه ، وأنه تم الاعتراف بالقيمة التي تتمتع بها الحياة على الأرض ، مستقلة عن أية أمان أو مخاوف مرتبطة بالحياة بعد الموت(37) .
والجدير بالالتفات والتفكر أن مبدأ التقدم يعتمد على أنساق المجتمع ونظمه وتطلعاته ، وهذا الميراث الاجتماعي وما يغرس في الفرد منذ نعومة أظفاره من أفكار وتطلعات وقيم أهم من الميول الني تنتقل جسمانيا من الأب إلى الطفل ، ومن ثم يتقرر مبدأ برهنت على صحته تلك الأمم التي ( كانت ) متخلفة واستطاعت أن تقفز الفجوة الحضارية بمجرد تبديل أنماط الثقافة السائدة ، هذا المبدأ خلاصته أنه ” لا فروق غير قابلة للتخطي أو التعديل بين جميع السلالات البشرية(38) ” . لابد أن يكون هذا ومثله قد شغل المفكرين والفلاسفة كما شغل أصحاب الأيديولوجيات السياسية . إن أهم نقاط التصادم بين المنظرين من الفلاسفة ورجال الفكر ، وبين المنظرين السياسيين : أن الفصيل الأول يبدأ من مراقبة الواقع ، ويفكر في النسبي والممكن ، ومن ثم يتقبل مبدأ ” تعدد الثقافات ” فلا يرى في التعدد ضعفا وتشرذما ، بل على العكس يراه مصدر قوة وإلهام ومناقشة خلاقة ، شريطة ألا يتحكم شعور الاستعلاء والرغبة في الانفراد . أما المنظرون السياسيون فإنهم يستوعبون تجارب الماضي ، ولكن ما يشغلهم هو المستقبل ، ومن ثم تتسلط الأيديولوجية الواحدة ، التواقة إلى اختفاء التعدد وصهر الجميع في بوتقة التوحد ( كما يحدث في المدن الفاضلة : سواء كانت حلما بالمستقبل ، أو رغبة في استعادة الماضي ) وهو ما لم يتحقق ولا يمكن تحقيقه .
يمكن اتخاذ إميل دوركايم ( 1858 – 1917 ) مثالا للفكر الفلسفي المهتم بالأساطير والرموز ، كما أنه يؤسس تحليلاته الاجتماعية على المعرفة ( الحدسية ) بإنسان ما قبل التاريخ . إنه يطرح السؤال : كيف يعرف الناس ما يعرفونه ؟ ولماذا والفرصة متاحة للجميع ، لنفس الطبيعة ، المادية والبشرية ، لا يصلون إلى نفس النتائج؟ ويمكن عكس التساؤل : إذا كان كل فرد مختلفا عن الآخرين فلماذا لا يصلون إلى نتائج مختلفة تماما ؟ هنا تبرز ” العلاقات الاجتماعية ” ، ” فتصنيف الناس يعيد تصنيف الأشياء” ، بما يؤدي إلى أنه لا الخبرة الفردية ، ولا العقل الفطري كان باستطاعته توليد الأفكار الأساسية مثل : الزمن ، والفضاء ، والسببية . إن الأفراد – في نظر دوركايم – يتمثلون النظام الاجتماعي لغرض معين ، ربما يكون خافيا عليهم ، ولكن عالم الاجتماع يستطيع رؤيته . هذا الغرض ، ( أو الوظيفة ) هو دعم نمط حياة ما ، ونتيجة لاستبطان المعتقدات حول ما هو مقدس وما هو مدنس ، ما الذي يشكل فعلا إجراميا ، أو : ما الأفكار المعقولة ، لكي يتم حماية نظام اجتماعي معين ؟ ، فالعلاقات الاجتماعية تولد أنماطا لإدراك العالم تساهم في الحفاظ على تلك العلاقات(39) . إن دوركايم مؤسس ” علم اجتماع المعرفة ” يقرر أن المؤسسة بمجرد نهوضها تمارس تأثيرها مستقلا على من أوجدوها( نتذكر هنا مسرحية ت . س . إليوت : جريمة قتل في الكاتدرائية – فإن المستشار ربيب الملك بمجرد حلوله في كرسي منصبه الديني بدأ يفكر بوحي من موقعه المقدس ضاربا عرض الحائط بولائه السابق لمليكه !! ) ولا تغيب آراء نافذة وحاسمة مثل إشارته إلى ” عبادة الأسلاف ” وأن هذا الإجراء الطقسي لا يزال يؤدي وظيفته حيث يساعد تذكر الأشياء الماضية عبر تعاقب الخلف على إضفاء الشرعية على عدم المساواة في المكانة ، لكنها قد تكون مدمر في سياق العلاقات الاجتماعية الفردية ، حيث تؤدي مطالب السلف إلى تقييد حرية التعامل ، أو في سياق مساواتي ، حيث – ربما – ” تفرض اليد الميتة ” للماضي مظاهر عدم المساواة لعصر أقل استنارة(40) .
إن كارل ماركس أقوى المفكرين في القرن العشرين اهتماما بالتنظير للثقافة في إطار نظريته عن صراع الطبقات ، ومقولته في الإنتاج : فإن الطبقة التي تمتلك أدوات الإنتاج المادي تحت تصرفها لديها سيطرة – في نفس الوقت – على وسائل الإنتاج العقلي، حتى يمكن ، وبصفة عامة – أن تخضع لها أفكار أولئك الذين يفتقرون إلى أدوات الإنتاج العقلي . إن هذا يعني أن ماركس في دعوته إلى تأسيس اقتصاد يحرر أدوات الإنتاج ، فتتحرر الطبقة العاملة ( البروليتاريا ) من سطوة إملاء الأفكار والتوجهات ، من ثم يختفي اغتراب الإنسان عن ذاته ، ويكتسب وعيا بموقعه لا تضلله عنه إرادة الاستغلال المختفية وراء أقنعة الحكام الذين لا يحبون التفكير في أنفسهم كمستغلين (بكسر الغين)، إن تصور الماركسية العام للإنسان أن البشر جميعا ولدوا من طبيعة خيرّة، ولكن المؤسسات الشريرة هي التي تفسرهم ، فإذا استبعدت هذه المؤسسات ظهر الجوهر الصافي للفرد في إطار الطبقة ، على أن طبقة البروليتاريا – دون غيرها – هي الطبقة الوحيدة التي تعمل لمصلحة الإنسانية أكثر من مصالحها الطبقية الضيقة . ربما أخذ على المثقفين – في مجتمع البرجوازية – أنهم خدام الطبقة ، ولكن إلغاء الطبقة سيؤدي إلى إبطال هذا الدور(41) . ويتحول المثقف من خادم للطبقة إلى ” مهندس ” . وإذا جاز لنا أن نرصد – في هذا السياق – تحولات الأدب الروسي قبل البلشفية إلى الأدب السوفيتي الاشتراكي بعدها ، سنجد مثالا لاختفاء سطوة البرجوازية لتحل في مكانها هيمنة حراس مجتمع البروليتاريا . ليس صحيحا أن الأديب الروسي أحسّ بتحرره الثقافي ومن ثم اتخذ وجهة مجتمعه الجديد :
” يرى هنري جيفورد H . Gifford أن الأدب الروسي قد أجدب بعد الثورة وانتكس ، ومن ثم لم يعد يكشف عن وجود عظماء تتجه إليهم الأنظار كما كان الأمر من قبل ، ويرجع ذلك إلى تطرق تعليمات ” لينين ” إلى الأدب إذ قال : يجب أن يتخذ الأدب منهجا جماعيا . وقد ووجه بمعارضة من تروتسكي الذي حذر من التعميم الأصم للنظرية الماركسية ، ورأى أن الماركسية ليست أسلوبا فنيا ، كما أن قوة الفن ليست متساوية عند الجماعة الواحدة ، ولهذا يجب أن يترك الفن ويأخذ طريقه الطبيعية . ولكن صيحة المعترضين ضاعت أمام تصميم الحكم الجديد ، فجمع الكتاب في منظمة واحدة ونقل إليهم باسم اللجنة المركزية ( سنة 1934 ) وجوب كتابة أعمال أرفع مستوى تجمع بين الأيديولوجية وجاذبية الفن ، ويذكر ” يانكولافرين ” أن جوركي قد رأس هذا الاجتماع وأقر الدعوة الجديدة إلى مزج التعاليم الماركسية بالفن ، وكأنه بذلك أقر الواقعية الاشتراكية واعتبر رائدا لها .
ويذكر الباحثان لافرين و جيفورد أن ستالين لم يقنع بما تحقق ، وعاد إلى التدخل السافر في جو من الإرهاب ، فبعث إلى الكتاب في اجتماعهم بمن أخبرهم بأن ستالين قد اعتبرهم ” مهندسي النفوس الإنسانية ” ودعاهم إلى إخلاص أكثر للواقعية بقصد إرساء قواعد الثورة وترسيخها ، ونادى بوجوب الربط بين الواقعية وهذه النظريات الشجاعة التي يعتنقها المجتمع . ويعلق جيفورد على هذه المحاولات التي تبذل للحد من النظرة النقدية أو الناقدة قائلا : إن الكاتب الاشتراكي الذي يخضع للتعليمات الاشتراكية يصبح بلا أفكار ، ولذلك فإن الأدب السوفيتي قد فقد طرق خبرته . هؤلاء الكتاب الذين ساروا في طريق الواقعية الاشتراكية التي اختيرت لهم بدقة وتحت أشكالها المختلفة حاولوا أن يغيروا المشاهد القديمة وينقلوها من ميادين المعارك إلى المصانع أو أراضي البناء ، من الغابة الكثيفة إلى الميدان الواسع ، ولكن النتيجة دائما كانت واحدة ، فجميع الروايات صارت على أسلوب واحد ، وهكذا أوضح الأدب الروسي حقيقة واحدة هي كيف وضعت تعاليم كارل ماركس لتطوير الجماهير . لهذا يرى جيفورد أن أدب ما بعد الثورة أو ذلك الأدب الذي التزم بالاشتراكية وأدخل في الخطة كأي نشاط عملي آخر قد فشل ، بالرغم من الجهود البشرية التي بذلت من أجله في تغيير وجه الحياة الروسية ، ويرجع جيفورد هذا الفشل إلى جمع هذا الأدب بين الجدية والتشكيك مع العجز عن تحديد أسباب هذا الشك ودوافعه ، ووضع الظن قبل الحقيقة دون أن يفرق بين ما هو واقع وما هو أمل يرتجى ” بكل دقة : الواقعية الاشتراكية نغمة وتصميما وهدفا هي الرواية التي تدور حول نفسها في الشئون البشرية عامة أو المصير الروسي “
ثم يمضي الناقد ليحدد خصائص هذه الواقعية الاشتراكية في أنها تقر المبدأ القائل بأن الخلق الفني كسواه من الأعمال يعود بفائدة أكثر حين يتحول من الفردية إلى الجماعية ، فضلا عن أنه ينظر إلى البطولة كمسلك طبيعي ، ويرى أن الحياة أكثر حكمة وإقناعا من التخيلات ، كما أنه لا شيء أجمل من الحقيقة ، مع إبطال المغزى المحزن ، وتأكيد الأفكار النامية في خدمة مستقبل الإنسان ، واختيار الأبطال على أساس نصيبهم من الشقاء وقدرتهم على الكفاح(42) .
خامســا : تسييس الثقــافة
يعطي ختام الفقرة السابقة مؤشرا على العلاقة أو الرابطة العضوية بين التنظير والتسييس ، فكما رأينا في النظرية الماركسية / اللينينية للإنتاج الأدبي – والفني بصفة عامة – أنه تابع لقوى الإنتاج التي تشكل البنية التحتية للمجتمع ، على أن النظرية طالت كل جوانب الحياة الاجتماعية إذا ألغيت ملكية أدوات الإنتاج بما فيها الأرض الزراعية ، واستقرت المؤسسات التعاونية ، وحمل الجميع لقب ” رفيق ” ، وتخلت الدولة كما تخلى الجميع عن رعاية الكنائس ، وفرضت رقابة صارمة على الصحف وأصبحت مملوكة للدولة، وحرم الاتصال بالعالم الخارجي إلاّ بإذن من السلطة .. إلى آخر ما كان مشهودا في التجربة السوفييتية ، وأدّى – بعد سبعين عاما – إلى سقوطها من داخلها ، لأن تصلب الشرايين ضربها في مقتل ، إذ تخلّت عن مبدأ النقد والنقد الذاتي،وأهملت الموروث التاريخي للشعوب ، وفرضت متغيرات ثقافية ليست نابعة من حاجات الناس وممارساتهم .
وهذا ” الفرض ” يصح في حالة واحدة سنشير إليها لاحقا ، أما “تسييس الثقافة “، فيجب أن يضع في اعتباره ” ثقافة السياسة ” ، وهذه الثقافة السياسية توصي عادة بتجنب الإلزام والتصنيف النظري ( الافتراضي ) وتلائم بين ما تهدف إلى تحقيقه في الحقل الثقافي خاصة ، والتطور الاجتماعي ، لأن هذا التطور – في ذاته – ثقافة ، لأنه يتأثر ويؤثر في الموقف الإنساني الاجتماعي من الوجود ، كما أن فعل التطور محدد بقوة واتجاه طبيعة القيم الثقافية السائدة في المجتمع ، مثلما تحدده تطلعات المجتمع واتجاه استجاباته ، ونظرته أو تأويله للتحديات(43) . وهذا يتطلب أن يكون تسييس الثقافة إرادة اجتماعية ونتيجة وعي واختيار ، وليس قرارا فوقيا يصدر عن السلطة ، لأن كل ما يصدر عن السلطة هو لصالحها من جانب ، ويؤدي بأفراد المجتمع وجماعاته إلى السلبية، وهنا تصح مقولة ماركس : إن وعي البشر لا يحدد وجودهم ،إنما على العكس : فإن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم(44) . وهنا لابد من استعادة المقولة الماركسية الأساسية ، وهي أن البنية الاقتصادية وسياسة الإنتاج هي المتحكم في كل الأنشطة ومظاهر الحياة والعلاقات والسلوك العام بما في ذلك : الثقافة ، التي ينبغي أن ترتب مفرداتها ، مظاهرها ، مع هذه الحقيقة المؤسسة للنظرية . لقد بذل بعض المنظرين جهدا في التأكيد على أن الثقافة – في أساسها المادي – يمكن أن تكون في مقدمة التنظيم الاقتصادي الاجتماعي وليست في موقع الصدى أو التابع لهما ، ولكن القول الأكثر اعتدالا واعتمادا ما قاله ” وارنر ” عن الثقافة :
” يترتب تقدم الثقافة على تقدم الظروف المادية من أجل الثقافة ، وبوجه خاص فإن التنظيم الاجتماعي لأي فترة من التاريخ يقيد الإمكانيات الثقافية لتلك الفترة . ومع ذلك ثمة تفاعل مستمر بين الثقافة والتنظيم الاجتماعي عبر التاريخ كله . وحقا أن الثقافة لا تستطيع أن تتجاوز ما هو ممكن ، بينما التنظيم الاجتماعي يمكن أن يتخلف ويتأخر ، من وجهة نظر الثقافة ، عن كلا الممكن والمرغوب فيه . وثمة تواصل بين كلا الأشكال المتنوعة للتنظيم الاجتماعي والأشكال المتنوعة للثقافة ، غير أن التواصل الثقافي أكثر تميزا لأن تصور الإمكانيات عقليا أسهل من وضعها موضع التطبيق بالنسبة للشيء الواحد ، وكذلك لأن التغيير والتقدم في المجتمع يقاومهما دائما طالما أمكن أولئك الأشخاص ذوو المصلحة الذين يكونون في تلك اللحظة في القمة ، فيرفضون أي نوع من إعادة التوافق في نطاق المجموع . ونجد أن الثقافة ، في تلك الفترات التاريخية التي يصبح من الضروري تغيير تنظيم اجتماعي ، تعارض مستويات المجتمع التي استفادت من زمنها ، وهي مستويات ، بهذه المناسبة ، رفعتها وامتدحتها بحق ثقافة الماضي ، لكنها برهنت على قصورها وعدم دفعها لمزيد من التقدم نحو المستقبل (45) ” .
إن مرتكز القوة في هذا التفاعل المستمر ، وهو الذي باستطاعته أن يرشّد السياسة الثقافية ويجنبها الشطط ، إذ لا تعمل مستقلة عن قواعدها الاجتماعية الشعبية ، وهذا ما يفتتح به شوقي جلال مقدمته لكتاب ” الثقافات وقيم التقدم ” – المشار إليه آنفا – حين ينبه إلى ان لدينا أفرادا مجتهدين على مستويات مختلفة ، ولكن فكر الأمة ليس حاصل تراكم فكر أفراد ، فلابد من المشاركة الجمعية النشطة لبناء ثقافة مؤسسة على فهم علمي عصري .
إن مكونات الثقافة ينبغي أن تكون حاضرة في تسييس الثقافة ، وليست تحايلا عليها وتجاهلا لجوهر كينونتها . ليس في مكنة هذه الدراسة ، وليس مطلوبا منها أن تقدم ” فرزا ” لعناصر الثقافة وشروط تفعيلها في مجتمع ما ، إذ يعد الإخلال بهذا العنصر إفسادا للثقافة من حيث هي ” قيمة ” مؤتمنة على تحقيق التقدم ، وتعبر عن تصور مجتمعي مبني على العدل والحرية واحترام الإنسانية ، ونكتفي بعنصرين لعلهما الأكثر ” قلقا ” في صورة مجتمعاتنا الثقافية الراهنة ، وهما الأدخل في مفهوم السياسية الثقافية، والأحوج إلى الوعي المجتمعي في التعامل معهما : موضوع الأقليات ، وموضع الجنوسة أو المرأة. وإذا كان ترتيب العناصر يتقدم فيه الكم فإن موضوع المرأة هو الجدير بالتقدم، لأنه يشمل نساء الأقلية أو الأقليات أيضا ، لأننا – والحالة هذه – نعرض لنصف المجتمع كحد أدنى . ولكن موضوع الجنوسة ( المرأة ) يتفاعل – في الوطن العربي – ويحقق تقدما عاما بعد آخر ، منذ قاسم أمين ( 1863 – 1908 م ) وحتى أصبحت المرأة العربية نائبة في المجالس النيابية وقاضية ، ووزيرة ، ورئيسة دولة في بعض الأقطار الإسلامية مثل بنجلاديش وباكستان ، مع هذا لدينا ما ينبغي أن يقال في هذا الاتجاه . أما ” الأقليات ” الدينية والعرقية واللغوية في الوطن العربي فإنها تصطدم بموروث ديني يتزيّى بالاجتماعي ، والعكس أيضا صحيح ، وقد سبقت الإشارة إلى مشكلة ” الأقليات ” تحت عنوان ” الهوية ” وكيف أن الهوية تفهم خطأ على أنها لون واحد ، نمط واحد ، عقيدة واحدة ، نسب واحد، حتى وإن ارتكب الشطط وإنكار الواقع والتاريخ . لقد ألف ميلاد حنا كتابا يطرح رؤية الأقلية من منظور الأكثرية وما تعانيه من انحراف في الفهم ، ولهذا اختار عنوانا لكتابه : ” قبول الآخر ” وفي تصوره أن هذا القبول ( الطوعي ) هو الذي سيوصل إلى ” فهم الآخر ” وعلى أساس هذا الفهم يتحدد استيعاب الجميع بفكرة الوطن ، تصبح الهوية الثقافية المرنة المشتركة معادلة لهذا الوطن . الهوية الثقافية هي بذاتها الخصوصية الثقافية لجميع المصريين ، هي الأعمدة السبعة للشخصية المصرية ، مهما كان الدين ، أو الطبقة ، أو الصناعة ، التي ينتمون إليها ، هذه الأعمدة السبعة يشرحها بقوله : ” إن المصري هو نتاج الزمان ، والمكان ، فعبر المكان تراكم لدى المصري – كل مصري – آثار رقائق من الحضارات ، أو الأعمدة الأربعة التي تتالت على مصر ، وهي : الفرعونية، واليونانية الرومانية ، والقبطية المسيحية ، والإسلام بكل رقائقه الداخلية . وبمقتضى المكان ، أي الجغرافيا ، فإن مصر قلب العالم العربي ، وتطل على البحر المتوسط ، وجزء من أفريقيا ( هذه ) الأعمدة السبعة للهوية المصرية وهي موجودة بأشكال وأحجام مختلفة لدى كل مصري(46) ” . إن ميلاد حنا – في توقيت دراسته عن ” قبول الآخر ” يعطي مؤشرا مهما عن انحراف مفهوم ” الهوية ” أو تضييقه في مصر ، وإذا كانت أمثلته من مصر حيث اختلاف نسبة من المصريين في الدين ، ونسبة أخرى أو نسب أخرى في العرق ( النوبة في جنوبي مصر ، والأمازيغ في بعض واحات الصحراء الغربية ، وبعض قبائل البدو في الصعيد وسيناء التي لا تزال تحرص على الانتساب لأعراقها خارج الوطن المصري إلى اليوم ) هذا التمثيل يصدق بدرجات مختلفة في جميع الأقطار العربية دون استثناء ، ( وكذلك قضية المرأة ) على أن ميلاد حنا يوجه رسالته في كتابه عبر مبدأين : أن يكون قبول الآخر مقدمة إلى فهم الآخر ، وهذا يتحقق من خلال ” الحوار ” الذي يؤدي إلى مزيد من التقارب الذي يتيح للطرفين معا أن ما يجمع البشر وطنيا أو إقليميا أكثر اتساعا مما يفرقهم أو يثير الخلاف بينهم ، من ثم يحذر من التوجه العكسي ، أن يؤدي الاختلاف إلى خلاف ، ومن الحق ما يراه ميلاد حنا من أن الاختلاف يثري ويبدع ، في حين أن الخلاف يؤدي إلى الكراهية والتنابذ . أما المبدأ الثاني فإنه متضمّن في التسليم بأهمية المبدأ السابق ، ونعني الثقة في أن تعدد الثقافات في إطار موسع هو الهوية الوطنية ينبغي أن يكون موضع تقدير واحترام وثقة بأنه لا يؤدي إلى اختلاط الهوية أو فسادها . إن ثقافة المدينة – والمثل من عندنا – تختلف عن ثقافة القرية ، وثقافة البدو ، ولكننا لا نملك الحق في استبعاد أي منها من الانضواء في المفهوم العام .
إن ميلاد حنا في دراسته المختصرة هذه يلمح إلى حق هيئة الأمم المتحدة في تفعيل ميثاقها ، ومن ثم إنشاء ” مجلس أمن ثقافي ” يفحص التوجهات المتسترة بالشكل الثقافي ، وهي تحمل ثقافة الكراهية تتسرب في مناهج التعليم ووسائل الإعلام وخطاب المؤسسات الدينية ، وهذه ” الخمائر ” المبكرة والمنتشرة هي التي تعمق الجفوة والنزاع، وقد تؤدي إلى الشقاق والانقسام والحرب ، من هنا يرى الكاتب أن ثقافة قبول الآخر – خطوة في اتجاه فهم الآخر- هي البديل المنشود لثقافة الكراهية(47) التي تبثها سلطات مستبدة ترى أن الشقاق والنزاع هو سبيلها إلى السيطرة على الجميع . وبصرف النظر عن الطموح العالمي لاستقرار وتكامل ” ثقافة الموزاييك ” على مستوى العالم ، فإننا نلاحظ أن أقطارا قامت على التعددية العرقية ، والتعددية الدينية ، والتعددية اللغوية مثل ماليزيا في الشرق ، وسويسرا في الغرب ، ولم تتعرض إحداهما لتلك المخاشنات والتصدعات التي تتكرر في مجتمعاتها لأسباب عابرة ، وأحيانا لأسباب مفتعلة تماما ، أو تافهة كان يمكن القضاء عليها بمجرد القليل من الصبر مقترنا بالصدق وحُسن الظن ، والحقيقة أن قلق الأقليات لا يستشري إلاّ في المجتمعات المتخلفة ، التي تتراجع في طريق التحضر والتحديث ، ولا تملك مشاريع قومية تمثل هدفا بازغا يحقق نقلة يتطلع إليها الجميع في اتجاه الرفاهية وإشباع حاجات الناس المادية والنفسية والروحية على اختلاف توجهاتهم . أما المجتمع الذي يضمر أولو الأمر فيه أنهم لا يعينهم غير إخضاع الناس لسيطرتهم ، وتعتقد الأغلبية فيه بأنها – دون غيرها – صاحب هذا الوطن ، لأنها التي تملك تاريخه وواقعه وتقبض على الحقيقة المطلقة ، مثل هذا الوطن لن ينعم بالأمن، ولن يتحقق له التقدم ، ولن يكون قويا بالقدر الذي يحفظ له وحدته .
لقد اهتم كتاب ” نظرية الثقافة ” – الذي حرره مجموعة من المفكرين – بالسياسة الثقافية لمجموعة من الأقطار ( الأوروبية والأمريكية ) التي استطاعت – بالديموقراطية – التغلب على المحاور الثقافية المتأصلة في مجموعات عرقية أو المتحيزة في مناطق جغرافية مثل إيطاليا والمكسيك . وقد تعد الولايات المتحدة الأمريكية النموذج الماثل للتكامل والتوحد في إطار الاختلاف ، حيث تتعدد الولايات وتختلف الثقافات ، وقد تتنافر الأعراق ، وتتنافس الأهداف ، ومع هذا يحافظ المجتمع الأمريكي على تماسكه تحت راية واحدة ، ودستور يحظى بقدسية عالية ، وقيم ديموقراطية لا تقبل الاستثناء . في تعقب دخيلة فتاة أمريكية موظفة ( كاتبة اختزال ) في الثامنة عشرة من عمرها نجد هذا التوصيف لعالمها الخاص ، كمثال المدنية المشاركة ، مرموزا لها بالحرف ( أ ) :
” فبرغم اعتيادها على أن أباها لديه الكلمة النهائية في القرارات الأسرية ، تشعر الآنسة (أ) بحرية في التعبير عن آرائها ، وترى أنه ربما من الأفضل أن يشارك صغار السن في القرارات الأسرية بدرجة أكبر . وتنتمي الآنسة (أ) إلى عدد من المنظمات ، منها منظمتان كنسيتان فضلا عن نادي شابات أمريكا ( YWCA ) . وبرغم أنها لم تصل لسن التصويت فهي تعتبر نفسها من الديمقراطيين : ” لقد رأيت دائما أن الحزب الديمقراطي يدافع عن الضعفاء ” . لكنها تشعر ” بأنها عندما يصبح لها أبناء ستدعهم يقررون بأنفسهم ، وإذا أرادوا أن يكونوا من الجمهوريين فستشعر بأن لديهم أسبابا معقولة ” . والآنسة (أ) راضية جدا عن عملية الحكم على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى القومي ، وتعبر عن فخر شديد ببلدها : ” لدينا ذلك ، ولدينا نظام حكم جيد ، ونحن إحدى القوى العظمى في العالم ” .
وهي تشعر بأن المواطن الصالح يجب ألا يذهب للتصويت فحسب ، وإنما عليه المشاركة في شؤون المجتمع والكنيسة والمدرسة ، فضلا عن ضرورة أن يكون ” وطنيا فخورا ببلده ، ومستعدا لفعل أي شيء لحماية حرية بلده ” .
إننا لن نجد مجتمعا يستقبل من المهاجرين ، ويتسع لمجموعات عرقية وجزر لغوية وتعدد في الأديان والمذاهب مثل المجتمع الأمريكي الذي لا تزال فيه أسماء مهاجري دول أوروبا وأمريكا اللاتينية تحمل اللوازم ، أو الملصقات اللغوية التي تدل على أصولها البعيدة ، دون أن يؤدي هذا إلى شرخ أو وهن في مبدأ الولاء العام للدولة وحماية أسس بنائها الديموقراطي إلى أبعد مدى ، ومثال الأمريكي ( الأسود ) من اصل أفريقي مثال آخر .
ولا نستطيع القول بأن الدولة الأمريكية ،مثل فريد في هذا الأمر ، إذ نرى الولاء يدور مع روح العدل والإنصاف والمساواة في الحقوق والواجبات وجودا وعدما ، في أقطار مختلفة ، قد يكون أكثرها في أوروبا ، ولكن القارة الأوروبية لا تنفرد بها .
أما قضية المرأة ، أو الجنوسة فقد أصبحت علامة فارقة – لا تحتمل الجدل بين التقدم والتخلف ، لشدة ارتباطها بحقوق الإنسان ، بوجه عام ، وأنها تدخل في شد أزر البنيان الاجتماعي من ” الشباب ” و ” الطفولة ” على أهميتهما ، لأن ” المرأة ” أعم من الشباب ، وأعم من الطفولة ، فنصف الشباب من النساء ، ونصف الأطفال كذلك ، مما يعني أن الخلل الذي يلحق بإنسانية المرأة يعصف بنصف المجتمع ، ويؤثر سلبا على النصف الآخر حتى وإن ظن أن ميل الميزان في اتجاهه يحقق له مصلحة . وسنقدم مثلا واحدا أو مثلين من آثار تحريف الثقافة والعدوان على مفهوم العدل والقيمة ، من المجتمع المصري . ففي صعيد مصر ، حيث الرقعة الزراعية الضيقة ، والطابع العشائري القبلي يحكم العلاقات الاجتماعية ، فقد دأبت نسبة عالية من الأسر على حجب حق الميراث في الأرض عن النساء ( سواء كن متزوجات أو غير متزوجات ) تجنبا لانتقال ملكية هذه الأرض أو الانتفاع بها لأسرة زوج المرأة أو من يحتمل أن يصبح كذلك . هنا إهمال معلن لفريضة دينية وحق واجب بشرع الله ، ولكن من يجترحون ذلك ويستحلونه لا يشعرون بتناقض أو إخلال بمبدأ وحق . من ثم فإن ” الذرائعية ” أو ” الميكافيلية ” تجد سندها الحاضر في مثل هذه السلوكيات المبررة بعوامل ” اقتصادية ” سوّغها المجتمع الذكوري لنفسه ، وأنكرها العدل والقيمة ومبادئ الدين ..
لقد أكرهت المرأة على الاستسلام لتبعية الرجل ، في كافة الحضارات القديمة ، وحتى عصر النهضة في أوروبا ، ولكن الشمول الذي طرحت به قضايا المجتمع ما لبث أن احتوى قضية النوع ( المرأة ) فيما طرح من تصورات وعوامل التقدم ، مع شيء من التجاوز في الأساليب وإن بقي الهدف واحدا . تعبّر ” ويندي هاركورت ” عن اختلاف التوجّه مع ثبات الهدف بإشارتها إلى الحركات النسائية كانت تقصي الرجال عن الكفاح ضد الأبوية ( الذكورة ) لكنها الآن تعيد تشكيل وتعريف مفهوم العمل لصياغة مجتمع جديد لكل من الرجال والنساء يقوم على تجارب ومهارات النساء كراعيات ومنجبات . إن القضية لا تكمن في إضافة مفهوم النوع إلى الفلسفات الدنيوية الكبرى ،وإنما في إعادة كتابة هذه الفلسفات من جذورها(48) . هل يبدو هذا القول مبالغا بعض الشيء ؟! إننا لا نرى ذلك ، وإن كل ضمير حي – بالمعنى الحقيقي للتحرر – لا يجد مسوغا لفرض الشعور بالنقص والهوان والتبعية لكائن بشري مكتمل ، لمجرد انتمائه إلى نوع معين . وإننا نقدر تلك الضغوط الرمزية والطقوسية المتوارثة منذ القدم ، والتي وجدت دائما ما يسوغها من منظور ذكوري حتى إحراق المرأة ( الهندية ) إذا مات زوجها !! إن التركيز على البنية البيولوجية يمكن أن يضلل الواقع ويحرّف المعيار دون أن تفطن المجتمعات ( المستسلمة للموروث ) لهذا ، فالنساء – كقوة عمل – لا تقل كفاءة ، بل تزيد ساعات العمل والإنتاج عن قدرات الرجال ، وإذا كان الهدف ( الذي يؤطر معيار القيمة ) هو حماية الأسرة ومقاومة الفقر فإن حظ النساء في أداء هذه المهمة تفوق على حظ الرجال . إن مشكلة النساء في العديد من الثقافات أن العمل المناط بهن كثير أو ثقيل عن الحد ، فالنساء في هذه المجتمعات لا يعملن فقط عملا شاقا لساعات طويلة ، بل يزج بهن إلى جانب الأعمال المنزلية إلى نطاق محدود من المهن كالخدمة المنزلية ، والبيع ، والأعمال المكتبية المتدنية .. ويقصين عن الوظائف الأعلى ذات الراتب المجزي ، كذلك تدفع للنساء أجور أقل عندما يمارسن نفس وظائف الرجال .. إن المرأة التي تقوم بسبعة أدوار: الأمومة ، والزواج ، والمنزل ، والأقارب ، والمهنة ، والمجتمع ، وتحقيق الذات ، لابد أن يطغى بعض الأدوار على بعض آخر ، فالمرأة الأم غير مرغوب فيها في سوق العمالة من جانب ، وهي نفسها تجد في الأمومة قيدا يحدّ من انطلاقها في العمل !!(49) لقد أصبحت هذه العوائق مفهومة ، ولكن أشدها استعصاءً على الحل في عديد من المجتمعات: تراجع وصول النساء إلى السلطة بشكل حاد ، وإلى المناصب العليا في أقطار كثيرة ، وسوء مآل المطلقات الأرامل بالنسبة للعمل أو الزواج من جديد مما يقذف بهن إلى الفقر ، مما يستوجب أن يتأسس وعي جديد بحق النوع ( النسوي ) في أن يكون له استحقاقات ثابتة في تخطيط المشروعات وتصميم الأعمال على اختلاف أنواعها ، بما يحمي الكيان النسوي العام من الإقصاء والتهميش والانحياز ضد ، بما يؤثر سلبا على ” عدالة ” الوطن في معاملة كافة أفراده ، ومن ثم غياب الشعور بالكرامة الإنسانية والجدارة الحياتية(50) .
سادسا : العــولمة .. أو حرب الثقــافات
” الحروب ” ظاهرة إنسانية لم يخل منها عصر من العصور ، حتى عندما كان مجموع البشر على ظهر الكرة الأرضية أقل من مجموع سكان إحدى القارات الآن ، وهذا يؤكد على أن ” الصراع ” يتجاوز كونه دفاعا عن الحياة أو الرزق أو الحق في الحرية . لقد كان عنصر واحد من عناصر تشكيل الهوية الثقافية – عبر أزمنة طويلة – يكفي لإشعال حرب ، كاختلاف الدين أو المذهب ، والتنافس العرقي بين العشائر ، وحيازة الأرض ، والولاء للنظام . . إلخ ، على أن هذه الأسباب المعلنة لاستثارة العامة لكي يبذلوا أرواحهم وأموالهم ستكون – دائما – مجرد دخان يخفي الأسباب الحقيقية الكامنة في استعلاء القوة والرغبة في الهيمنة بكل ما يترتب عليها من استنزاف الموارد والتدخل في تغيير الثقافة قسرا(51) بما يخالف الطبيعة البشرية القائمة على اختلاف ( تعدد ) الثقافات .
لقد أصبحت العولمة ( Globalization ) مصطلحا يتصدر التحليلات الاقتصادية والسياسية والثقافية ، ولئن كان المدخل الاقتصادي للعولمة يأخذ مكان الصدارة ، فما لبثت الثقافة أن أخذت هذا الموقع المتقدم ، لدى الشعوب المستهدفة بإعمال مبادئ العولمة ( أي الدول الأضعف ، لأنها الأقل إنتاجا وإن تكن مصدر خامات يسيل لها لعاب الأقوياء ) فأصبحت هذه الشعوب مقتنعة بقوة : أن ثقافتها ، شخصيتها ، ما يميزها عن غيرها هو المستهدف ، كي تتخلى عن جوهر وجودها وتقنع بدور التابع المقلد .
بين أيدينا ثلاث دراسات ( مشبعة بدرجة ما ) عن العولمة ، لا تنكر فضائلها ، ولكنها يتبرز خطرها على الأمم والشعوب المستهدفة ، وتنقدها من داخلها نقدا حادا ، لأن هذه الدراسات لمؤلفين غربيين ممن ( يفترض ) أنهم مشاركون في اجتناء فوائد العولمة ، وهي حسب ترتيب نشرها بالعربية :
- فخ العولمة : الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية – تأليف : هانس – بيتر مارتين ، وهارالد شومان ( ترجمة عدنان عباس علي ) 1998 .
- الكونية الجذرية ، لا العولمة المترددة – تأليف : فريد هاليداي ( ترجمة خالد الحروب ) 2002 .
- العولمة والثقافة : تجربتنا الاجتماعية عبر الزمان والمكان – تأليف : جون توملينسون ( ترجمة إيهاب عبد الرحيم محمد ) 2008 .
يرجح لدينا من قراءة عناوين هذه الدراسات والمبادرة إلى نقلها إلى العربية ( وهناك غيرها بالطبع ، ولكن هذه الأكثر انتشارا ) أنها تميل إلى ” إدانة ” العولمة ، وإظهار ما تخبئه تفاصيلها وما تحاول ستره من غاياتها التي تبدأ باستلاب اقتصاد الدول الضعيفة والفقيرة ، مقدمة للنفاذ في هويتها الثقافية ومحو خصوصيتها التاريخية أو إضعافها بدرجة تتقبل فيها أن تكون مسخا ملفقا غادر جذوره وطبيعته ، ولا يملك امكانات التواصل والتمكن بجذور هي من الأصل ليست له ، ولا تناسبه . في مقدمة “فخ العولمة ” برهن رمزي زكي على أن العولمة ترسم صورة المستقبل ( الاقتصادي ) بالعودة للماضي السحيق للرأسمالية بعد قرن من الأفكار الاشتراكية والديموقراطية ومبادئ العدالة الاجتماعية . ويقرر إنها حركة مضادة تقتلع كل ما حققته الطبقة العاملة والطبقة الوسطى من مكتسبات(52) . إن الاقتصاديين يتحدثون عن عالم أصبح قرية كونية وسوقا واحدة ، والحق أنه لا رابط الآن غير الإرسال التليفزيوني ، فنحن نعيش في عالم متدابر، جزر منفصلة ، فروق المستوى المعيشي بينها هائلة : هذا بالإضافة إلى حصر الديموقراطية في سيطرة رأس المال . إن الوجه الاقتصادي للعولمة يحمل نذرا مدمرة للدول الضعيفة والطبقات الوسطى والكادحة . غير أن الأثر الثقافي للعولمة كان موضع اهتمام دراسات أخرى . وهذا الاهتمام يبدأ من التسليم ( العلمي ) بوجود الثقافة (العربية)، المتوارثة ، تختلف عن الثقافة ( الغربية ) في أمور متعددة(53) ، والتسليم أيضا بأن هدف العولمة حرية تنقل السلع ورأس المال ، ولكن الحياة الثقافية ليست منفصلة عن هذا الهدف الاقتصادي ، ويقدم عبد الرحمن بن محمد عسيري أمثلة للتأثير الثقافي ، منها ألعاب الأطفال وما يلحق بها من وسائل الترفيه . وانتشار اللغة الإنجليزية الذي يسهل تقبل ما تحمله من ثقافات ، دون غيرها من اللغات(54) . وهنا تظهر توقعات ومخاوف ” الغزو الثقافي ” غير أنه في الحالتين السابقتين : لعب الأطفال ، وتفوق أساليب تعلم اللغة الانجليزية لا يترك اثره إلاَّ بقبول طوعي من المتلقي ، فالأمر فيها مرهون بثقافة متقدمة، غنية بأفكارها ، مجددة في اساليب عملها . وهذا يختلف عن ” العولمة ” التي تؤدي إلى غزو ثقافي أشبه بقطع الطريق بأسلحة تهديد لا تملك حين تقع في مرماها غير الاستسلام لها والأخذ بما تعرضه عليك . ومن الإشارات الطريفة في هذا الاتجاه تلك العبارة المنسوبة لداعية العولمة الذي أشعل الخصومة الثقافية والحضارية بين الولايات المتحدة وأقطار الدول الاسلامية خاصة ( صمويل بي هنتنجتون ) ، تقول : ” إن شعوب العالم غير الغربية لا يمكن لها أن تدخل في النسيج الحضاري للغرب ، وإن استهلكت البضائع الغربية وشاهدت الأفلام الأمريكية ، واستمعت إلى الموسيقى الغربية ، فروح أي حضارة هي اللغة والدين والقيم والعادات والتقاليد ” ويضيف هنتنجتون : ” إن التحديث والنمو الاقتصادي لا يمكن أن يحققا التغريب الثقافي في المجتمعات غير الغربية ، بل على العكس : يؤديان إلى مزيد من التمسك بالثقافات الأصلية لتلك الشعوب ، ولذلك فإن الوقت قد حان لكي يتخلى الغرب عن وهم العولمة ، وأن ينمّي قوة حضارته وانسجامها وحيويتها في مواجهة العالم . وهذا الأمر يتطلب وحدة الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، ورسم حدود العالم الغربي في إطار التجانس الثقافي(55) ” بهذا الحسم يتقرر أن الشعوب التي تهجر ثقافتها ، ومهما خلعت جلد الحمل ووضعت مكانه جلد النمر فإنها لن تصبح من فصيلة النمور ، بل ستظل ” مستلحقة ” ، ” تابعة ” تغادر محطتها الفطرية ، ولا يؤذن لها بدخول محطة غيرها . ولعل هذا أصبح مفهوما جدا الآن ، ولهذا تراجعت تطلعات المستغربين ، كما انطوى المستعربون على دراساتهم في مكتبات مراكزهم الثقافية ليخدموا في سفارات بلادهم ، أو في صحافتها ومراكزها البحثية ، بما يعني أنهم – في جملتهم – تخلوا عن الحلم بشمس الشرق وتقاليد مجتمعاته الأصيلة . أما ” الاستعداء ” في الاقتباس السابق الذي لا يتقبل ” الصحوة ” أو ” الصحوات ” في العالم غير الغربي فإنه يوغر صدر الغرب ( وهو لا يحتاج إلى جهد في هذا ) بأن يذكر ” مواجهة حضارات العالم ” : ” مواجهة ” ، وليس تفاعل أو محاورة أو اقتراب للتفهم !! ويمكن أن نصف هذه ” المواجهة ” بأنها ضد المفهوم الصحيح للثقافة ، ونقيض لما تتطلبه حيوية الثقافة وقدرتها على التجدد عبر التفاعل مع الثقافات الأخرى ، والأخذ عنها ، ومنحها ، دون أن يعني هذا تغيير جلدها ، أو خطوطها الأساسية ، أو ما يكوّن هويتها ، ويمنحها خصوصيتها . إن فكرة ” النقاء الثقافي ” فكرة غريبة على الثقافة ذاتها، وهي طريق إلى الجمود والاضمحلال ، وكما يقول تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية ، إن ” فكرة الإبداع أوسع نطاقا من النقاء الثقافي(56) ” ، وقد يتأكد هذا – عمليا – فيما صدر به ” هنتنجتون ” كتاب : ” الثقافات وقيم التقدم ” فاشار إلى ملاحظة سجلها زميله “هاريزون” الذي لاحظ أنه في مطالع تسعينيات القرن الماضي كان المستوى الاقتصادي لكوريا الجنوبية وغانا متماثلا تماما ، غير أن الأمر اختلف كثيرا بعد عدد محدود من السنوات ، وهذا الاختلاف المثمر محمل على ” الثقافة ” ، تلك التي اعتنقتها كوريا الجنوبية ، وماليزيا كذلك ، مما جعله أشد اقتناعا بالمبدأ الذي طرحه في صيغة تقريرية جعل منها عنوانا لكتاب : ” التخلف حالة عقلية ” ، ويذكر بالأمثلة المستمدة من دول أمريكا اللاتينية أن ” الثقافة ” كانت العقبة الأولى والأساسية على طريق التطور في تلك الدول ، وقد اعترض عليه الاقتصاديون والمثقفون في أمريكا اللاتينية الذين يرون أن الثقافة مؤثر كبير ولكنه ليس وحيدا في توجيه السلوك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي(57) . على أن هنتنجتون – الذي يورد هذا الرأي لا يتحمس للنتيجة قدر تحمسه للأسباب الموصلة للتغير الثقافي ، فالثقافة – في رأيه – متغير تابع ، من ثم يطرح التساؤل : كيف يمكن لجهد سياسي أو غير سياسي أن يغير أو يزيح العوائق الثقافية التي تحول دون التقدم ؟! ثم يضيف : ” نحن نعرف أن التطور الاقتصادي يغير الثقافات ” [ هنا يمكن أن نفكر في عكس ذلك وهو أن تطوير الثقافة يؤدي إلى تطوير الاقتصاد ] ثم يقول : ” يمكن أيضا للمجتمعات أن تغير ثقافتها استجابة لصدمة كبرى(58) ” ويمثل للبرهنة بكارثة ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية ، ومن بعدها الأرجنتين ، أما سنغافورة فهي مثال على أن القيادة السياسية يمكنها أن تحقق حفز التغيير الثقافي في ظل الظروف ذاتها . وعلي النقيض ما حدث في اندونيسيا وروسيا حيث قضى الفساد على أي احتمال لتطوير السياسة توصلا إلى الثقافة(59) . وينهي هنتنجتون تصديره بأن يضع أمام بصيرة قارئه مفارقة مهمة يطرحها في صيغة تساؤل : ” إذا كانت الثقافة مهمة، وقد درس الناس الثقافة على مدى قرن أو يزيد ، فلماذا لا نملك حتى الآن نظريات جيدة الصياغة والبناء ، ولا مبادئ توجيهية عملية ، ولا روابط مهنية وثيقة بين أولئك الدارسين للثقافة وأولئك القائمين على رسم وإدارة سياسة التطوير ؟(60) ” ومن الواضح أن المفارقة تقوم على أن كل “محاولة ” ثقافية لا تجد دعما من الإرادة السياسية يبذلها بإخلاص من بيدهم رسم سياسة البلاد لن تغادر موقع ” المحاولة ” ، والحلم بالتغيير ، دون طائل .
إن إشارة هنتنجتون إلى إمكان أن تتولى ” الصدمة الكبرى ” تغيير الثقافة يستثمرها في تصور استراتيجي لضرورة وجود ( صراع عالمي ) صادم ، بعد انتهاء الثنائية القطبية بسقوط الاتحاد السوفيتي ، ووقوف الولايات المتحدة وحيدة في الميدان ، إن هذا لا يقنعه بالتفوق المطلق ، بل لعله يقرأ فيه بداية انحلال تلك القوة العظمى وهبوط قدراتها ، من ثم كانت نظريته عن ” صدام الحضارات ” . يعرض فريد هاليداي لأفكار هنتنجتون ، وينقدها ، في كتابه : ” الكونية الجذرية لا العولمة المترددة(61) ” الذي يبدأ برصد أسباب التفاؤل بانتهاء الحرب الباردة ( 1991 ) واستهلال قرن جديد ( 2000 ) ، وفي هذا السياق ” بشّر ” فرانسيس فوكوياما ، وتوماس فريدمان بأن انهيار الشيوعية يفسح المجال للعولمة إذ تهيمن الليبرالية السياسية واقتصاد السوق والتقدم العلمي ، من ثم سيطرت موجة من التفاؤل قبل اختبار الرؤية ووضعها على المحك . أما هاليداي – وقد بدأ بالتفاؤل – فقد حصر دوافعه في خمسة أسباب من أهمها السبب الرابع الذي يقرر أنه ” برغم ادعاءات القوميين والأصوليين وبعض فلاسفة السياسة فإننا لم نعد نعيش في عالم مقسم أساسا بحسب الأيديولوجيات ، أو يتصف بأن الاختلافات القيمية بين أطرافه غير متصالحة أو لا تتواصل فيما بينها . صحيح أن فروقات وخلافات عديدة مازالت موجودة في العالم ، تعود بشكل مفهوم إلى تعدد التقاليد والمصالح ، ولكن هذه الفروقات والخلافات تُرى وتُناقش بحسب مفاهيم مشتركة إلى حد كبير ، مثل مفاهيم الاستقلال ، السيادة الشعبية والقومية ، الحقوق ، الازدهار الاقتصادي ، وبذلك صارت هناك لغة أعراف معولمة ومشتركة ، وصار الخلاف يكمن حول ما يقصد باستخدام تلك اللغة …(62) ” ولكن هذه النغمة المتفائلة لا تلبث أن تنقلب إلى التشاؤم ، ويقفز مصطلح ” صدام الحضارات ” وتوقع حرب مدمرة ، حتى يقول هاليداي : ” حسب الأوضاع القائمة فإن العالم سيكون محظوظا لو تمكن من تجاوز الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة من دون أن يشهد استخداما للأسلحة النووية في الحروب الإقليمية . كما أن الفجوة في مقدار القوة التي تمتلكها الدول مقابل الشعوب في اتساع ، ينضاف إلى ذلك : تنامي عدد من القوى المدمرة في نزاعات إثنية ، ولا مساواة اقتصادية ، وانتشار تجارة المخدرات والأسلحة اللاقانونية(63) ” مع أسباب أخرى إضافية قد يبدو بعضها أقرب إلى إشعال العداء من الأسباب سابقة الذكر ، لم تمنع فوكوياما وفريدمان من الإشادة بالنظام العالمي الجديد ، والتغني بعظمة القرن الأمريكي(64) . ولكن هاليداي يرد بالإشارة المحددة إلى ما صنع الصرب وأوروبا في كوسوفو ، وما صنعت روسيا في الشيشان ، وقد اقترن التطهير العرقي بالتدمير الثقافي بصفة خاصة ، وكذلك يرشح ثلاث مناطق هي الأقرب إلى الانفجار : في الشرق الأقصى وجنوب آسيا والخليج ، ويصفها بأنها ” ليست غريبة عن الحرب في التاريخ الحديث(65) ” . ويبدي هاليداي ضيقه وتخوفه من استخدام مصطلح ” العولمة ” وما يحمل من دلالات اقتصادية وسياسية ، أما ثقافيا – وهو ما يعنينا أكثر في هذه الدراسة – ” فالعولمة تعني زيادة التفاعل بين الثقافات ، وتجاوز سيطرة الدولة ، أو السلطات الثقافية الراسخة ، ولأن العولمة ترافقت مع الثورة التكنولوجية والإنترنت ، فإن كثيرا من الكتاب يقدمون طروحات أوسع حول العلاقة بين زيادة التفاعل بين المجتمعات ، وانزياح المفاهيم المرتبطة بالعالم ( ما بعد الحديث ) الموسوم بعلاقات عابرة للزمن والفضاء والهوية ، وهنا يأخذ النقد المتشكك (!!) موقعه في رصد ما يحدث(66) . هنا يظهر خطر العولمة على التنوع الثقافي والتعدد . إن الاندماج الكلي للدول – كما للثقافات، واللغات ، والشعوب – ليس ممكنا ، ولا مرغوبا ، وإن التفاعل والتقارب والتفهم المتبادل يؤدي إلى نتائج يصعب الاعتراض عليها ، وتؤدي إلى منافع كثيرة .
إن تسلل مفاهيم الصراع الثقافي ، وصدام الثقافات الذي تحدث عنه ونشره صموئيل هنتنجتون يضع العلاقات الدولية في مستوى غير مضمون وغير مبشر بمستقبل آمن للبشر وللثقافة معا . ولكن يبقى السؤال : كيف استطاع هنتنجتون أن يحول التعددية الثقافية من مصدر للتشوق والاكتشاف والتنوع الملهم إلى مصدر للتهديد ونذير بصدام الحضارات ؟
لقد قرأ خارطة العالم قراءة حضارية ، فتكشف له أن هذا العالم مقسم إلى ثمان أو تسع حضارات كبرى ، مرتكزة على فوارق ثقافية ثابتة ، ظلت باقية على امتداد قرون . وهذا ما يمكن قبوله ، كما يمكن تأويله وتعديله أيضا ، ولكن هنتنجتون يمضي خطوة أبعد خلاصتها : ” أن صراعات المستقبل ستحدث على امتداد خطوط التنازع الفاصلة بين هذه الحضارات ، أن هذه الحضارات صاغتها في الأساس تقاليد دينية لا تزال قوية النفوذ حتى اليوم ، على الرغم من قوى التحديث(67) وهنا يأخذ ” العالم الإسلامي ” مكانا بين هذه المحاور الحضارية التي يرى أنه بعد نهاية الحرب الباردة ستقع النزاعات السياسية أساسا على امتداد هذه التقسيمات الثقافية وليس على امتداد خطوط أيديولوجية أو اقتصادية . هذا احتمال قد يصح ، وقد يخطئ ، وهذا الأمر ليس مرهونا بمصادفة ، فالعالم لا تسيره المصادفات . وحيال مشكلات الثقافة وما يمكن أن يترتب عليها ، بل حيال مناطق التوتر في العالم كله ، ثقافية وغير ثقافية فإن الضمانة الوحيدة لاستقرار السلام القطري ، والقاري ، والعالمي ، يعود إلى الديموقراطية : هل هي صاحبة الكلمة بين الجماعات والطبقات والمذاهب والأحزاب داخل الوطن ؟ وهل هي التي تهيمن على علاقات الدول ، فتكبح جماح القوة وغطرسة الرغبة في الانفراد بالقرار ؟
إنه حل ممكن ، ليس وَهما أو حلما ، غير أن نقطة الارتكاز فيه أنه يبدأ من الإيمان بتعدد الثقافات في الوطن الواحد ، متكاملة في إطار الهوية الوطنية الواحدة ، تؤدي فيها الديموقراطية دور المياه في أنابيب الأواني المستطرقة .
سابعا : الخـاتـمـــة
هذه الأسطر القلائل التي تأخذ مكان الخاتمة تتمرد على أن تحبس في النسق التقليدي أو المتوقع للخواتيم ، بأن تكون تجميعا لأهم ما سبق طرحه من أفكار توصلا إلى رأي ” نهائي ” – أو شبه نهائي – في موضوع الدراسة . الأمر هنا يريد أن يختلف بأن يقدم ” نقدا ” أو لنقل إضاءات جانبية على ” الثقافة العربية ” تحاول أن تكشف عن بعض جوانب القصور في هذه الثقافة العربية . وهنا ينبغي التنبيه على ثلاثة أمور : أولهما : أن الدراسة التي قدمنا لا تخص ” الهوية الثقافية العربية ” بل مطلق ” الهوية الثقافية ” ، من ثم لم نشر إلى ملامح أو جوانب أو اتجاهات تخص الثقافة العربية إلاّ لماماً ، وكما أشرنا إلى ما يخصّ غيرها من الثقافات أيضا . الأمر الثاني : أننا لا نريد بهذه الخاتمة الناقدة أن نطالب بإجراء تغيير أو إصلاح في الثقافة العربية ، ليس لأن هذا يخرج بهذه الدراسة عن منهجها الموضوعي التحليلي المجرد . وحسب ، وإنما – أيضا – لأن ” التدخل ” لتعديل ثقافة ما لتساير مطالب الحاضر والمستقبل لا يتم بهذه الطريقة ، فلقد عرفنا من قبل أن ” الثقافة ” نتاج مجتمع ، وليست اجتهادا شخصيا أو يمكن أن تمليها جماعة أو طبقة ، إلاّ أن تغيّر من نفسها فتصبح – مع الزمن – قدوة ذات تأثير عام . الأمر الثالث يستحضر ما نعرف من مسارعة إلى اتهام أية محاولة تطالب أو حتى تفكر في نقد الحركة الثقافية ، أو الثقافات العربية عبر تاريخها المترامي ، بصفة خاصة ما يمكن أن يقترب مما استقر في وجدان العامة وعقائدهم أنه من شأن الدين ، أو ما يتصل بالمصادر المقدسة للإيمان . وهذا السيف المصلت جاهز دائما ، وقد طارد مفكرا عظيما مثل طه حسين حين كتب ” في الشعر الجاهلي ” ، ثم حين كتب ” مستقبل الثقافة في مصر” ، وكما نرى فإن أمور الشعر ومناقشة مصادره لا تمس العقيدة في شيء ، وكذلك توجه مصر الثقافي ، لا ينتقص دينها الإسلامي ، ولا انتسابها العربي ، وإنما يخدم مستقبلها العلمي والمعرفي ، ومع هذا انثالت الاتهامات تحاصر عميد الأدب ، كما حاصرت غيره من دعاة التنوير ، وكأن التنوير دعوة إلى الإلحاد ، وليس دعوة إلى قراءة المجتمعات العصرية ، واكتشاف قوانين التقدم من خلال تحليل ما أنجزته .
إن بلادا إسلامية وغير إسلامية سعت إلى تجديد ثقافتها ( أو ثقافاتها ) دون أن ترى في هذا التجديد تناقضا أو هدما لعقائدها المتوارثة . إن الدعوة إلى التجديد أو تقليد أمم أخرى في اتجاهات ومبادئ وقيم أثبتت فعاليتها في الرقي بالمجتمع ، هي – عندنا – دعوة متهمة بأنها تحريض على هدم الثوابت الدينية ، وإضعاف الانتماء التاريخي ، وتجميل للتبعية ، وفتح طريق لتنازلات قد توصل إلى إلغاء خصوصيتنا وتاريخنا وتهدد ديننا !! هذه تصورات مذعورة ذات طبيعة تسلطية ، لا تفكر إلاّ في أن تظل مهيمنة على سطوتها الاجتماعية ومكاسبها الأدبية والمادية ، متشائمة ، وفي أحسن الأحوال : هذه التصورات واهمة ، قلقة ، قليلة الدراية بأمور العالم من حولها ، لا تقرأ تواريخ الأمم ، ولم تحاول أن تتعرف – علميا – على أسباب قيام الحضارات ، وأسباب تراجعها عن مكان الصدارة إلى الصفوف الخلفية ، أو سقوطها المطلق وذوبانها في موجات حضارية قبضت على ناصية المستقبل بأن استخلصت العوامل الجوهرية التي ينبغي الأخذ بها ، والأمور المظهرية أو السطحية المعوّقة ، المحمّلة على الثقافة والهوية ، وهي مجرد ” قشرة ” أو ” غلاف ” يمكن إلغاؤه إذ ثبت عجزه عن الوفاء بمطالب مستحدثة ، ذات تأثير إيجابي في الإنتاج أو في العلاقات الاجتماعية . ( والأمثلة في هذا الاتجاه يسيرة ، ويكفي أن نشير إلى ” إزيائنا الشعبية ” ، والتمسك بها زيّا للعمل أيضا ، وهي معطلة ، وقد تؤدي لخطر قاتل أثناء العمل بين الآلات ، أو تعوق حركة الجسم لأداء الأعمال الدقيقة والعنيفة على السواء ) .
هناك إشارة تستحق أن نتأملها فيها صدق ودقة ملاحظة نجدها في مقدمة شوقي جلال التي مهد بها لترجمته لكتاب : ” الثقافة وقيم التقدم ” وقد اقتبسنا من هذا الكتاب غير مرة ، يقول : ” إن نهضة اليابان لم تكن محاكاة قصد التشبه ، بل محاكاة قصد الندية والمنافسة ” !! إن اختيار اليابان – قبل غيرها من أقطار غيرت بعض مظاهر الحياة فيها ، دون قصد التشبه ، وإنما لتيسير الندية والمنافسة – يغني عن كلام كثير في هذا المجال ، بل – أكثر ما أشار إليه صاحب الترجمة – نعرف أن اليابان هزمت عسكريا بعد ضربها بالقنابل الذرية الأمريكية ومحو مدينتين كبيرتين من الوجود . كان لابد من الاستسلام الكامل ، وقد حدث ، وحرم على اليابان إنتاج السلاح ، كما أجبر الإمبراطور على الظهور للناس والتحدث إليهم والكشف عن طوابع حياته الخاصة ، وقد كانت سرا ( دينيا ) مقدسا ، كما أن التطلع إليه عن قرب كان من المستحيلات ، مع هذا التغيير ( الإجباري ) والاعتقاد ببشرية الإمبراطور ( الذي كان مقدسا ) فإن اليابانيين لم ينقلبوا أو يستهينوا أو يطالبوا بأن يكون للشعب دور في اختيار إمبراطوره .. لقد بقي الشعور بالخصوصية والاحترام الذي يلامس التقديس ، واستطاعت اليابان أن تغير نسق ثقافتها العسكرية ، كما تخلصت ألمانيا ( الهتلرية ) من ثقافتها النازية ، وطابعها العسكري . وحولت إيمانها القومي إلى الإنتاج ، واستطاعت أن تبلغ ما بلغته اليابان من قوة اقتصادية بهرت العالم ، وقدمت كلتاهما نموذجا متفوقا في الإنتاج والإدارة والتسويق والعدل الاجتماعي والمدخرات ، حتى بالنسبة إلى تلك القوى العظمى التي هزمتها في ميادين القتال !!
لقد تصادف أن تطرقت إلى مفهوم المدينة الفاضلة أو Utopia ( في سياق كتابي: أساطير عابرة الحضارات ) بدءا من الجذر القديم جدا ، الماثل في ” جمهورية أفلاطون ” ، واستمرارا مع محاولات متقاطرة في الزمن الممتد ما بين عصر أفلاطون ( القرن الخامس قبل الميلاد ) وحتى عصرنا هذا ، وإن تحولت المدن الفاضلة التي يحدد ملامحها الفلاسفة والعلماء والكهان والشعراء _ إلى ” مدينة الخيال العلمي ” التي يرسمها الأدباء باحثين عن حل غير تقليدي ، يضمره الخيال الإنساني انطلاقا من واقعه إلى احتمالات قد بشّر بها هذا الواقع . في كتاب : ” المدينة الفاضلة عبر التاريخ “(68) – تعريف وتحليل لأهم مكونات المدينة الفاضلة ، انطلاقا من المحاولة الأولى ( أفلاطون : كتاب الجمهورية ) التي ظهر فيها انعكاس أثر هزيمة أثينا أمام اسبرطة ، إلى ( بلوتارك: حياة ليكور جوس ) في القرن الأول الميلادي ، ومدينة القديس توما الإكويني في القرن الثالث عشر ، إلى يوتوبيات عصر النهضة الأوروبية ، ابتداء بجزيرة يوتوبيا التي أبدعها ” توماس مور ” ( 1480 – 1535 ) ومنح هذه المدن المتخيلة اسمها الذي أصبح علما عليها جميعا ، وأنها تسعى إلى حياة شديدة النظام ، والانضباط ، والعمل / والأمن ، والإنتاج ، والسلام الاجتماعي .. إلخ . إلى ” مدينة الشمس ” ، كما رسمها توماسو كامبانيلا ( منتصف القرن السادس عشر ) ، و ” مدينة المسيحيين ” التي أسسها فالنتين أندريا ، ( أوائل القرن السابع عشر ) إلى أن نصل إلى ” أطلنطا الجديدة ” – وقد خطا بها فرانسيس بيكون خطوة نحو الواقع ، وتتعاقب اليوتوبيات من عصر الثورة الإنجليزية ، إلى يوتوبيات عصر التنوير ، حتى نصل إلى يوتوبيات القرن التاسع عشر ، حيث تظهر المبادئ الاشتراكية ، وندخل إلى القرن العشرين بمدن الخيال العلمي . إننا لم نقصد إلى التعريف بمحتوى كتاب ” المدينة الفاضلة عبر التاريخ ” ، وإلاّ احتجنا إلى عشرات الصفحات ، وما نريد أن نتمعن دلالته يمكن إيجازه في أن جميع هذه اليوتوبيات إبداع غربي خالص ، ليس لأية ثقافة أخرى أي درجة من المشاركة ( مع ما نذكر من المدينة الفاضلة للفيلسوف الإسلامي : الفارابي ) . إنني أنظر إلى هذا الجهد الإبداعي الخلاق من زاوية أنه ” محاولة تجريبية لثقافة بديلة ” – وهو العنوان الذي نقترحه لظاهرة المدن الفاضلة من حيث هي تجارب ذهنية خيالية لنظم اجتماعية مقترحة هدفها أن يكون المجتمع أكثر تماسكا ، والأفراد أكثر استقرارا ، حتى وإن دلت التنظيمات المقترحة على غير ذلك . ما يعنينا فيما نحن بصدده أن المدن الفاضلة ، الجمهوريات المقترحة ظلت ” حالة فكرية ” غربية ، لم يقترب منها العقل العربي أو الإسلامي ( غير العربي ) إلاّ في حالة نادرة ، جزئية ، مثلما نجد في حكاية ” حي بني يقظان ” ، وقد ” تجرأ ” أبسال وسلامان – الشخصيتان المصاحبتان لحيّ – على القول بأن نظام الزكاة بنسبه المقررة لا يكفي لإقرار الكفاية والعدل ، وهذه الحكاية – على أية حال – لم تتحول إلى عنصر ثقافي مشارك في تكوين العقل العربي . ومن المهم هنا أن نذكر أن أياًّ من هذه المدن الفاضلة التي اقترحها الخيال والفكر الغربيان ، لم تتحول إلى واقع ، ولو على سبيل الاختبار ، ولكن هذا لا يعني أنها كانت ” كأن لم تكن ” ، إننا نستطيع – بقراءة سريعة – أن نكتشف تطور النظم الاجتماعية زمنيا ما بين عصر جمهورية أفلاطون ، وحتى قبيل ظهور رواية الخيال العلمي ، لنلمح أوجه الاختلاف ، ونلمح أيضا تطور النظم الاجتماعية وحدود السلطة والحراك بين الطبقات .. إلخ ، على مستوى المتحقق الفعلي ، وإذا كان المشرع لم يقل أبدا إن تغييرا ما قد حدث بفعل تأثير ثقافي متسلل من المدينة الفاضلة ، وهذا طبيعي ، فإنه لم ينف هذا التأثير . وما يخصنا – من ناحية قمع الاختلاف وكبت حرية التخيّل والاقتراح – أن بعض هذه المدن الفاضلة خالفت بحدة بعض الأصول الخلقية التي أجمع ذوو الفطرة السليمة على احترامها ، وأقرتهم شرائعهم على هذا ، ولكن أحدا لم يصرخ في وجوههم : أيها الزنادقة !! كيف تقترحون ما يخالف شرع الله ؟ وهل أنتم تعرفون مصلحة الناس أكثر من خالقهم ؟
لقد اقترح توماس مور أن يتجرد راغبا الزواج من ثيابهما بالكلية ، ويقفان عاريين متواجهين ،وإن شرط وجود طرف ثالث ( مراقب ) حتى لا يحدث غش أو إخفاء عيوب ، وهناك من سبقه إلى ترديد مبدأ المكاشفة المطلقة حرصا على سلامة النسل !! هذه ” شطحة ” لم يأخذ بها احد ، ولكن أحدا لم يمارس الزجر أو القمع أو الاتهام بسقوط الواعز الأخلاقي . وهذا المثال نذكره لطرافته ، وفي المدن الفاضلة الكثير مما يؤكد حق حرية التخيل ، والاقتراح ، والكتابة .
حين نتأمل مصادر التاريخ العربي الإسلامي ، سنكتشف بأنها – دون استثناء تقريبا – قد كتبت من منظور تسجيلي ، يغلب عليه الطابع الرسمي الذي ترتضيه السلطة الحاكمة : الخلافة والمؤسسة الدينية ، وهما – عادة – يتبادلان التزكية والتأييد والتأكيد على أنهما صمام الأمان للأمة ، أما نقد التاريخ ، نقد المؤسسة ، فليس له موقع ، إلاّ أن يكون هذا النقد يتناول أحداثا صغيرة ، أو شخصا معينا ، فهذا مما يمكن قبوله . أما أن يعرض الباحث ( الناقد ) لبعض اتجاهات التفكير ، أو سيطرة الخرافات . أو تسلل اختلاقات الوعاظ والدعاة لأمور لم تكن ، بقصد خلق اتجاهات اعتقادية أو محاربة القول بضدها .. فهذا يعرض لمساءلة تعرض لها فلاسفة ومفكرون من مستوى الحلاج في المشرق ، وابن رشد في الأندلس ، وليس مستغربا – بالنسبة لموروثنا الثقافي – أننا – إلى اليوم – لم نطرح ” سقوط دولة الإسلام في الأندلس ” على محك التحليل ، ولم نعرض لقضاة الأندلس وما أثاروا من نعرات ما أجازوا من زيف بأي نقد ، ولا يختلف الأمر بالنسبة لحالة العداء ( التاريخي ) التي يغذيها فريق من الفقهاء ضد مخالفيهم من أصحاب فكر الاعتزال ، إن اضطهاد ” المعتزلة ” ، وتسمّي الفريق المواجه للفكر العقلي بأنهم أهل السنة والجماعة ، قد أبطل الاجتهاد ، وعطّل الفكر ، وافسد مفهوم الإجماع ، وبالمثل حوربت جماعة ” إخوان الصفاء ” وتوارث الناشئون معاداة فكرها والتشكك في دعواتها قبل أن يتعرفوا عليها ، أو يقتربوا – بدرجة كافية – من فكرها ، وقد يحدث مثل هذا وإن يكن بدرجات مختلفة ، وعلى التبادل بين : أهل السنة والجماعة ، والشيعة على اختلاف مذاهبهم . وهذا يوجد تصدعات في بنياننا الثقافي ، ويجعل من قبول الاختلاف فرضا للخلاف ، وبينهما فرق كبير . وإذا كانت هذه الدراسة لم تعقد لكي تناقش مشكلة الهوية في الثقافة العربية ، فإنه لم يكن في استطاعتها استبعاد هذا الجانب ، وإن اكتفت بالتذكير به ، لعل يوما يأتي يمكن فيه ” إخراج ” محتويات هذه المخازن الراكدة الغارقة في الغبش ، وعرضها تحت شمس الفكر الساطعة ، لتتكشف حدود الأشياء وطبائعها ، وعلى الأقل – بعض خفاياها . وفاء بحق الناس ، كل الناس : في أن تعرف !!
الهوامش والمصادر والمراجع
- جاء في كتاب ” التعريفات ” أن الخاص هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد ، والمراد بالمعنى ما وضع له اللفظ – عينا كان أو عرضا – وبالانفراد : اختصاص اللفظ بذلك المعنى . والخاص : كلمة مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط . ينظر : علي بن محمد بن علي الجرجاني – كتاب التعريفات – شركة القدس للتصدير . القاهرة 2007 ص160 ، 161 . وقد سمى أبو الفتح عثمان بن جني كتابه ” الخصائص ” لاشتماله على أهم ما تتميز به اللغة العربية ، فقد كان ابن جني من كبار فقهاء اللغة بكافة أفرعها .
- لسان العرب : مادة ” ثقف ” .
- ماو تسي تونج .
- جوبلز ( الدكتور جوزيف جوبلز 1897 – 1945 ( وزير الدعاية ، وابرز خطباء عهد النازية المروجين لدكتاتورية هتلر ونزعته العرقية المتعالية ، ولا يزال يعطي المثل لسطوة أجهزة الإعلام وقدرتها على تحريف الرأي العام واستلاب حرياته الفطرية .
أما عبارته المأثورة ومصدرها الذي اقتبستها منه :
Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meine Revolver. – Joseph Gobbels – stammt ursprunflich aus dem Stück >> Schlageter << von Hanns Johst .
نص المقولة ليوسف جوبلز نقلا عن مسرحية شلاجيتر للكاتب الالماني حانز يوست صدرت 1933 .
- وكم كان أمير الشعراء وطنيا فطنا ، كما كان شاعرا رقيقا حين نظم للأطفال قصة العصفورتين في الحجاز حلتا على فنن ، في خامل من الرياض لا ندٍ ولا حسن . وقد مرّ على أيكهما ريح سرى من اليمن :
حيــا وقــــال : درتان في وعاء ممتهن
لقد رأيت حول صنعاء وفــي ظــل عـدن
خمــائلــــــا كـــأنها بقيــة مـن ذي يزن
الحب فيها سكر ، والماء شهد ولبن ، كما بذل لهما أداة نقل سريعة مجانية يتطوع بها الريح نفسه ، ولكن إحداهما قالت له ( والطير منهن الفطن ) :
يا ريح أنت ابن السبيل ما عرفت ما السكن
هب جنة الخلــد اليمن لا شيء يعدل الوطن
- المعجم الفسلفي : مجمع اللغة العربية – الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية – القاهرة 1982 .
- من الواجب هنا أن نشير إلى دراستين نراهما غاية في الأهمية لما يحملان من دلالة على قدرة القيادات ذات الخبرة والرؤية على استيعاب نواحي الاختلاف بين الجماعات أو الدويلات المكونة للامبراطورية الإسلامية . الأولى منشورة بعنوان: ” رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة ( سنة 309 هـ = 921 م ) وخلاصة ما نريد من الوصف أن ملوك هذه الأمم رفعوا حاجاتهم إلى سدة الخلافة في بغداد ، يطلب بعضهم نصرتها العسكرية ، ويطلب آخرون علماء لتبصير الناس بالإسلام وأن تقيم مسجدا يدعى من فوق منابره للخليفة .
ينظر نص الرسالة ومقدمة المحقق الدكتور سامي الدهان .
مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق – 1959 .
الدراسة الأخرى في مجلدين كبيرين تأليف : آدم متز ، المستشرق السويسري ، بعنوان : ” الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ، أو : عصر النهضة في الإسلام ” . ترجمها محمد عبد الهادي أبو ريدة . وليس بوسعنا أن نجمل محتوى هذا الكتاب شديد الدقة ، شديد الأهمية ، ويكفي أن مؤلفه اختار في وصف القرن الرابع الهجري بأنه ” عصر النهضة في الإسلام ” ، بما يحمل مشروع النهضة من تفتح وتطلع ومرونة وقدرة على استيعاب مطالب الراهن والمستقبل .
الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة – دار الكتاب اللبناني – بيروت – الطبعة الرابعة 1967 .
- في مجلس الشعب ( المصري ) المنتخب بعد ثورة 25 يناير 2011 ، وقد فازت فيه الجماعات الدينية ( الإخوان والسلفيون ) بأكثرية النواب ، ارتفعت أصوات بعضهم تجرم تعليم اللغات الأجنبية في المدارس لمقاومة الغزو الثقافي ، وبعض آخر يطالب بفرض الرقابة على الانترنت لحجب الصور الإباحية ، ومن قبل وصف أدب نجيب محفوظ – العربي الوحيد الحاصل على جائزة نوبل في الآداب ( 1988) بأنه دعارة وانحلال ، وصرح أحدهم بأنه لا يفخر بتراث قدماء المصريين ( العرايا ) فضلا عن أن ” الأصنام ” حرام .. إلخ ، وهذه الومضات الدالة تكشف عن المرحلة التاريخية التي يتخذها هؤلاء وأشباههم مثالا وهوية لا يجدون السلامة إلاّ في استعادتها .
- ج . ب . بيوري : كتاب : ” فكرة التقدم ” – ترجمة أحمد حمدي محمود – المجلس الأعلى للثقافة – القاهرة 1982 – المقدمة : ص29 .
- تشارلز بيرد ( في تمهيده لكتاب فكرة التقدم – مرجع سابق ) – ص5 .
- صدر كتاب ” مستقبل الثقافة في مصر ” عام 1938 ، وكانت مناسبته – فيما ذكر طه حسين في مقدمته أن مصر وقد حصلت على استقلالها بمعاهدة 1936 مع انجلترا جديرة بأن تفكر في تبعات الاستقلال ، وفي مقدمتها بناء ثقافتها ( المستقلة ) .
المرجع السابق : طه حسين : ” مستقبل الثقافة في مصر ” – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة 1993 .
- مستقبل الثقافة في مصر – ج1 – ص9 .
- مستقبل الثقافة في مصر – ج1 – ص12 .
- المصدر السابق نفسه .
- المصدر السابق – ص13 .
- المصدر السابق – ص17 .
- المصدر السابق – ص18 .
- قال بهذا المفكر القومي محمد عزة دروزة ، في كتابه ” القومية العربية ” ، وقد سبقه إلى شيء من هذا التصرف الأديب أحمد على باكثير الذي أشاد بعظمة الفرعون إخناتون ، وربما عده نبيا ، ( في مسرحيته : إخناتون ونفرتيتي ) وقال في مذكراته لماذا لا نعد الفراعنة من قدماء العرب كما نعد بلقيس ومملكة سبأ ؟!
- التنوّع البشري الخلاق : تقرير اللجنة العالمية للثقافة والتنمية (الطبعة العربية ) – المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة 1997 ص69 .
- المرجع السابق : ص69 ، 70 .
- ينظر الفصل السابع بعنوان : ” دور كايم ” من كتاب : نظرية الثقافة – تأليف مجموعة من الكتاب ، ترجمة على سيد الصاوي . سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة – الكويت 1997 – ص223 ، وتحديدا : ص229 .
- المرجع السابق : الفصل التاسع عن : ماكس فيبر – ص269 ، وتحديدا : ص278 وهنا يسجل فيبر ملاحظة أن كبار المحاربين والنبلاء لا يبذلون مظاهر الإجلال لرجال الدين والقديسين مثل غيرهم ( ص279 ) ونضيف ما نري في الريف بخاصة في المغرب ومصر والعراق وإيران من انتشار مقامات الأولياء والصوفية ، وإسناد صفات محددة لهم تتصل بمبدأ الخلاص والشفاعة .
- المرجع السابق : ص405 .
- ينظر : الثقافات وقيم التقدم : تحرير : لورانس . أ . هاريزون ، وصمويل بي هنتنجتون ( ترجمة شوقي جلال ) المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة 2005 – ص45 .
- نص العبارة المنسوبة إلى القديس أوغسطين مترجمة عن اللاتينية إلى الإنجليزية :
When in Rome, do as the Romans do Meaning
It is Polite, and Possibly also advantageous, to abide by the customs of a society when one is a visitor .
St Augustine : Letters Volume I was translated from the Latin by Sister W . parsons and published in 1951 .
- هذا ما يعنيه مثل ( عامي ) شائع في ريف مصر – كما سمعته – رافضا التخلص من لهجات الريف إلى لهجة المدينة،ونصه : “من غيّر لغته غيّر دينه ” ، ولكن المشاهد أن الريفي إذا طالت إقامته في المدينة فإنه يصطنع لهجتها ، ومن المشاهد كذلك أنه حين يعود إلى منبته الريفي فإنه ( يتباهى ) بما اكتسب من لهجة المدينة !!
- ينظر : جورج طرابيشي : إشكاليات العقل العربي – دار الساقي – بيروت 2002 ص75 ، واقرأ الأمثلة التطبيقية ص 75 – 79 .
- فؤاد ذكريا :خطاب إلى العقل العربي– كتاب العربي– الكويت 1987 – ص14 .
- المرجع السابق – ص16 .
- رايموند وليامز : الثقافة والمجتمع ( ترجمة وجيه سمعان ) – الهيئة المصرية العامة للكتاب – القاهرة 2001 – ص7 – 13 .
- آشلي مونتاغيو : البدائية ( ترجمة محمد عصفور ) سلسلة عالم المعرفة – المجلس الوطني للثقافة – الكويت 1982 – ص13 .
- المرجع السابق : ص13 ، 14 .
- المرجع السابق : ص15 .
- مايك كرانغ : الجغرافيا الثقافية ( ترجمة سعيد منتاق ) سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة – الكويت 2005 – ص13 ، 68 ، 69 .
- نقلا عن دراسة لثروت إسحاق بعنوان : حدود علمية الثقافة ( من كتاب : الثقافة والجامعة المصرية ) – الهيئة العامة لقصور الثقافة – القاهرة 2008 ص 56 – 64 .
- من أطرف ما قرأت عن تخلف ” الإدارة ” ومسؤوليتها عن استبقاء التأخر والفساد ما ذكره أستاذ الإدارة ( العالمي ) الدكتور سيد أبو النجا – في كتاب من جزءين بعنوان : ” ذكريات عارية ” وصف فيه تجربته مع أساليب الإدارة في المجتمعات المتقدمة ، وأفاعيل الإدارة في بلادنا المحكوم عليها بالتخلف !!
- ج . ب . بيوري : فكرة التقدم – مرجع سابق – ص49 .
- فكرة التقدم – ص148 .
- نظرية الثقافة ( مرجع سابق ) – ص223 .
- ينظر الفصل السابع ( دور كايم ) 223 – 230 من كتاب نظرية الثقافة .
- ينظر الفصل الثامن ( ماركس ) 249 – 266 من كتاب نظرية الثقافة .
- ينظر كتاب : الواقعية في الرواية العربية ص 56 – 58 والمراجع المبينة بالهامش .
- شوقي جلال : مقدمة كتاب : ” الثقافات وقيم التقدم ” تأليف : لورانس راي هاريزون ، وصمويل بي هنتنجتون . المجلس الأعلى للثقافة – القاهرة 2005 – ص13 ، 14 .
- رايموند وليامز : الثقافة والمجتمع ( مرجع سابق ) ص 296 .
- المرجع السابق – ص300 .
- ميلاد حنا : قبول الآخر – الهيئة المصرية العامة للكتاب 1999 – ص15 .
- المرجع السابق – ص18 .
- التنوع البشري الخلاق ( مرجع سابق ) ص141 .
- المرجع السابق – ص152 ، 153 .
- المرجع السابق – ص162 ، 165 .
- في العصور الوسطى خاض ملوك أوروبا حروبهم ” الصليبية ” بمباركة بابا روما تحت شعار تخليص مهد المسيح من أيدي المسلمين ، أما السبب الخبئ فكان إشغال الفلاحين والبسطاء عن المطالبة بحقوقهم لدى السلطة المطلقة لملوك الإقطاع ، والتخلص منهم بإرسالهم إلى الشرق ، فإذا استطاعوا الاستحواذ على بعض الأراضي فإن في هذا فائدة ( إضافية ) للملوك ، وللبابا أيضا !! ونادرا ما كان السبب الاقتصادي يعلن عن نفسه صراحة،كما فعلت انجلترا في حرب الأفيون التي أجبرت فيها الصين على فتح موانئها أمام التجارة البريطانية قسرا !!
- مقدمة كتاب فخ العولمة : سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة – الكويت 1998 ص8 – ويشير رمزي زكي إلى ما هو ماثل الآن من زيادة البطالة ، وانخفاض الأجور ، وتقلص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة ، وإطلاق آليات السوق واتساع درجات التفاوت في توزيع الدخل والثروة بين المواطنين . يرى الباحث أن هذا ما كان سائدا في البدايات الأولى للنظام الرأسمالي إبان مرحلة الثورة الصناعية ( 1750 – 1850 ) المرجع السابق – ص8 ،9 .
- ينظر نص دراسة فيصل محمود الغرايبة بعنوان : ” الثقافة العربية في عصر الاتصالات والعولمة ” ضمن أعمال ندوة استراتيجية الثقافة والتنمية – جامعة الكويت – مارس 2000 ، وقد رصد الباحث تسعة أوجه للاختلاف بين الثقافتين العربية والغربية ، تشمل: التسامح – إعمال العقل – العلم – الأهداف الاجتماعية، الخصوص والعموم – موقع الدين – قابلية التغير – وضوح الهوية وثباتها – ص80 ، 81 .
- ينظر نص دراسته بأعمال الندوة المشار إليها سابقا – ص124 وما بعدها .
- المرجع السابق ص 126 – هنا أذكر شبيها بقول هنتنجتون إن الشعوب غير الغربية لا يمكن أن تدخل في نسيج الحضارة الغربية حتى لو أخذت بجوانب من ثقافتها ، بموقف ذكره لي طبيب بحريني شاب كان قد ابتعث إلى أمريكا لدراسة الطب إبان زمن الفصل العنصري بين البيض والسود . فقد أرسل الطبيب ولديه إلى اقرب مدرسة إلى بيته ، فردهما مدير المدرسة لأنها لا تقبل الملونين !! غضب الطبيب العربي لكرامته وواجه مدير المدرسة ، وكان الطبيب أبيض البشرة، فوضع يده بجوار يد المدير وسأله : أينا يده أشد بياضا !! ؟ ولكن المدير ابتسم واثقفا وقال للطبيب العربي : إنك تظن أن صفة ” أبيض ” مجرد لون للبشرة ! أنت على خطأ ، فالأبيض سلالة وعرق وموروث ثقافي !! وليس مجرد لون !
- التنوع البشري الخلاق ( مرجع سابق ) ص82 .
- الثقافات وقيم التقدم ( مرجع سابق ) – ص20 ، 21 .
- المرجع السابق – ص22 .
- المرجع السابق – ص23 .
- المرجع السابق – ص24 .
- الكونية الجذرية لا العولمة المترددة ( ترجمة خالد الحروب ) – نشر دار الساقي – بيروت 2002 .
- المرجع السابق – ص26 .
- المرجع السابق – ص28 .
- المرجع السابق – ص66 .
- المرجع السابق – ص98 .
- المرجع السابق – ص109 .
- داينيل إيتونجا : الثقافة والديموقراطية – دراسة في كتاب : الثقافات وقيم التقدم – ص168 .
- المدينة الفاضلة عبر التاريخ – تأليف ماريا لويزا برنيري – ترجمة عطيات أبو السعود – سلسلة عالم المعرفة – المجلس الأعلى للثقافة – الكويت 1997 .