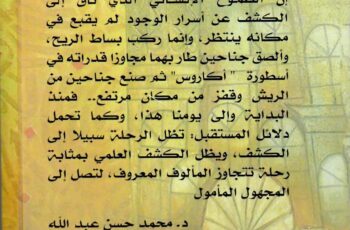مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري .. إحياء الحركة الثقافية العربية
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري
إحياء الحركة الثقافية العربية
د . محمد حسن عبدالله
استهـــلال
أما وقد أتمت – بنعمة الله على مؤسسها وعليها – عامها الخامس والعشرين ، فبلغت إشراقة الشباب ورونق الحياة وقوة الحضور ، فإن ” مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري ” جديرة بهذه الجلوة ، تباهي بفعالها ، متماهيا في جلالة دورها ، لتكون قدوة ومثلا ، وهذا الدور الذي تؤديه لم يجد إلى اليوم من ينافسه أو يضاهيه أو يقاربه فيما صنع ، وفيما وعد فوفى وأوفى ، وفيما لا يزال يعد ويسعى في طريق الوفاء ) لمثل هذا فليعمل العاملون ((1) . على أن هذه الورقة – وقد حملت أمانة التعريف بدور المؤسسة في ” إحياء الحركة الثقافية العربية ” – لتقدر عظم المسؤولية ، لاتساع المسافات ، وتعدد الاتجاهات ، وتراكب الأنشطة ، حتى صدق فيها قول الشاعر القديم :
تكاثرت الظباء على خِرَاشٍ فما يدري خراشٌ ما يصيد(2)
واعترف بأن حيرة الكاتب ( الناقل ) في الإمساك بأطراف خيوط يصعب حصرها وتنضيدها لتقديمها إلى القارئ في صورة يسهل إدراكها ، ليست بأقل – في معاناة أسر مفردات اللغة وتنسيقها في شبكة المعنى – من حيرة كاتب يقلب ناظريه في أرض خلاء فيحمل وزر استنبات ما يقال سترا لمناسبة !! هذا مع اختلاف الحالة النفسية إلى حد التناقض . لقد بذل صاحب المؤسسة ، وراعيها ، الساهر على بذرتها ، العامل بدأب دون توقف عبر ربع القرن على تناميها والحفاظ علي حياتها : جذورا وفروعا ، وسائل وغايات، علما وعملا ، وطنيا وقوميا وعالميا ، لا تغفل عينه عن رعاية هدفه الأول والأصيل : ” إحياء الحركة الثقافية العربية ” ؛ الذي تنطلق منه كل الروافد ، تؤدي وظائفها الإنسانية الراقية ، لتعود فتصب فيضها فيه ليزداد غنى ورونقا وتجددا ، فينطلق متوسعا إلى آفاق جديدة ، دون أن يتراجع اهتمامه بنقطة الانطلاق المركزية التي بدأبها . هذه أهم الملامح المنهجية التي ترسخت في توجهات ” مؤسسة الجائزة ” في سعيها الدائب لإحياء الحركة الثقافية العربية .
على أن هناك وجها آخر للحفاوة بالمؤسسة في عيدها الفضّي ، قد يكون في البحث عن آفاق جديدة ، واقتراح أو أنشطة لم تكن داخلة في التصور السائد سباب ، والأسباب كالأمواج لا تستقر على صورة !! ونحن إذ نعيش مع المؤسسة يوم عيدها الفضي حدثا كبيرا ، فإن الأحداث الكبيرة تستدعي الأسئلة الكبيرة !!
هناك نقاط من الواجب الالتفات إليها ؛ فقد أصدرت ” المؤسسة ” كتابا أنيقا موثقا، دقيقا – شأنها في كافة مطبوعاتها – بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيسها ، بعنوان: ” سنوات من العطاء : 1989 – 2010 ” وقد اشتمل على تسجيل وتوثيق موجز ، لكل ممارساتها التي بدأت برعاية الشعر والشعراء ، ولكنها ما لبثت أن تنامت – عبر السنوات بتوسيع أفق الحركة ، وتنويع وسائل الاتصال ، واكتشاف موضوعات وقضايا استدعتها أحداث مستجدة لم تكن مطروحة من قبل ، واكتساب علاقات بمؤسسات علمية وشخصيات عالمية وأنصار متحمسين لم يكونوا في مدى الرؤية من قبل … هذا بعض – أو أهم – ما تضمن كتاب ” سنوات من العطاء ” الذي لم يمض على صدوره أكثر من أربعة أعوام ، ولعلنا نجد أنه لم يكن من الصعب أن يعاد إصدار هذا ” البيان ” المختصر الشامل ، مع إضافة ما استجد من دورات وملتقيات ومطبوعات فيما بين عامي 2010 م و 2014 م ، من ثم يؤدي وظيفته كاملة إلى أن يبلغ بها مشارف هذه الاحتفالية .
أما الإضافة التي تستحق التنويه حقا ، فقد لحقت العنوان ، وهي بمثابة ” كلمة السر ” أو المفتاح ” الماستر ” إذ أصبح العنوان : ” سنوات من العطاء الثقافي ” بهذا التحديد الصريح فائق الروعة !!
هذه كلمة إنصاف واجبة في حق هذا ” السجل ” الموثق بالدقة والأمانة والموضوعية ، غير أن هذه الموضوعية ألزمته الوقوف عند ضفاف الواقع المشاهد ، فلم يؤسس للظواهر ، ولم يكشف عن السياق ، ولم يعن بإظهار أوجه التكامل والملاءمة .. إلخ، وهذه الهوامش – وغيرها – ما يمكن لهذه الورقة أن تضيفه اعتقادا بأهميته وجوهريته في إحلال ” مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري ، ودورها في إحياء الحركة الثقافية العربية ” مكانتها التي تستحق عن جدارة ، وتثمين دورها الذي تنفرد به دون غيرها مما يسعى في ذات المضمار .
إن ” مؤسسة الجائزة ” لم تولد كاملة ، ولم يكن لها ذلك بحكم جبرية الكينونة ، ولكنها – منذ البدء – كانت بذرتها تنطوي على بصيرة ، ومرونة ، واستعداد للبذل ، وقدرة على رصد المتغيرات والتعامل معها .. ضمنت لها أن تمتد جذورا ، فتتأصل ، وتنجب فروعا فيمتد ظلها وتقبل عليها جماعات متنوعة ، تتواعد وتتوافق ، وتنصرف حاملة أقباساً من إبداع جديد في الشعر والفكر والحضارة .
ولهذا كله شروط هي موضع اهتمام هذه الورقة ، نعرض ها باختصار ( اضطرارا ) اطمئنانا إلى توثيق المصادر وتوافر التفاصيل المحفوظة في مكنون ” المؤسسة ” .
لسنا بحاجة إلى شرح مفهوم ” الإحياء ” وحدوده ووسائله ، ولا تحليل مصطلح ” الثقافة ” وأنواعها ، وأهم ما يمكن أن يفضي به هذا المطلب الأولي سيكون حاضرا في سياق ما سنعرض له من قضايا تاريخية وحاضرة ومستقبلة ، مما يتطلب أن نستحضر المطلب الوطني ( الكويتي ) والعربي (القومي) والديني (الإسلامي) والعالمي (الإنساني ) .
من وراء هذا كله ، وقبله ، شخص صاحب المؤسسة وراعيها ( عبد العزيز سعود البابطين ) ، وكما ذكرت في كتابي ” الكويت والتنمية الثقافية العربية(3) ” : إن الكويت ليست أغنى دول النفط ولا الأكثر عددا وقدرة ، ولكنها ” الأقوم ” في رسالتها الثقافية ، المحافظة على روح العروبة في لغتها وأدبها ، الحريصة على إضاءة التاريخ الإسلامي وقيم الأخلاق، المنفتحة إنسانيا على دعوات التقدم والاستنارة والمناهج العلمية ، المجافية للتعصب والتصلب المذهبي والاستعلاء العنصري . هذا ما تدل عليه مطبوعات الكويت بدءا بمجلة العربي (صدرت عام 1958) وحتى عالم المعرفة ، وعالم الفكر ، والمسرح العالمي .. إلخ . إن ” مؤسسة الجائزة ” تمضي في هذا المحتوى العام لرسالة الكويت الثقافية في حدود نشاطها الخاص ووسائلها المتجددة لإبلاغ رسالتها ، وإذا كانت رسالة الكويت الثقافية بوصفها الذي قدمنا قد شقت طريقها إلى قلوب من توجهت إليهم ، وعقولهم ، وغاب عنها وجه الاعتراض الرقابي في جميع الأنحاء وعلى امتداد الزمن ، فإن نشاطات ” مؤسسة الجائزة ” قد بلغت الغاية نفسها ، فاستجاب لها – بدءا – آلاف من الشعراء الذين أمدوها بأشعارهم وسيرهم وصورهم لتصدر معجمها الأول عن ” الشعراء العرب المعاصرين ” ، فكان هذا أول استفتاء عام على توجهها ، وثقته في رسالة المؤسسة الثقافية ، وقد حرص راعي المؤسسة على إعلان هذا .. أن يحقق التواصل والتكامل مع رسالة الكويت الثقافية التي آمن بها ، واقتدى ببصيرة حكامها ، فكان من كلمته في افتتاح ” دورة معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين ” (أكتوبر 2008 ) :
” وهذه الرعاية دليل ساطع على بصيرة حكام الكويت ، حيث أدركوا بحدسهم العربي الأصيل قيمة الثقافة كتجسيد لروح الجماعة ، وكيف تتجاوز الدولة بالثقافة حدودها، هكذا بالفعل الثقافي الجاد ، أصبحت الكويت ممثلة لأمتها تتجاوز حدودها الأرضية لتلتقي بأبناء أمتها على امتداد التراب العربي ، وتتجاوز حدودها الزمنية لتتحاور مع سدنة التراث على امتداد الزمن العربي “(4)
في البدء كان الشعر
حين نمعن التفكر في شعار المؤسسة منذ يومها الأول لممارسة نشاطها يتجلى ” الشعر ” ، شريطة ” الإبداع ” قرين ” الجائزة ” . فهذه الأركان الثلاثة هي الدعائم التي قام عليها التصور المبكر ، والمستمر ، لنشاط المؤسسة ، التي مهما توسعت مجالات عملها فإن ” الشعر العربي ” يبقى الركيزة والهدف ، ومن حقنا أن نستعيد صورة واقع الشعر العربي – تسعينيات القرن الماضي ( العشرين ) حين خطت المؤسسة خطوتها الأولى للإعلان عن وجودها . من المؤكد أن الشعر ( العربي ) لم يكن في أحسن أحواله ، كان الكبار ( السياب وصلاح عبد الصبور ) قد تحولوا إلى تاريخ ، وكان الأحياء ( نزار ، ونازك ، والبياتي ، وحجازي ) في حال أقرب إلى الصمت الشعري . كما كانت نداءات ” عصر الرواية ” وإعادة النظر في مقولة : ” الشعر ديوان العرب ” تغري الأقلام الباحثة عن فرصة ما ، وفي هذا المناخ الضبابي تعلن مؤسسة الجائزة عن إيمانها بالشعر ، وتتخذ من القاهرة مقرا ومرتكزا لهذا الإعلان !!
البدء المنحاز إلى الشعر له سببه الخاص الذي لا يصح إغفاله ، الماثل في أن صاحب المؤسسة وراعيها شاعر(5) . وهو شاعر أصيل الانتساب إلى الشعر قبل أن يخرج إلى الناس بديوانيه ، فتصوره للثقافة شعري في جوهره ، ومؤسسته للإبداع الشعري ذات تشكيل سيمفوني : يبدأ بالأداء المنفرد ، ثم تتكاثر وتتداخل الحركات في تناسق يهز النفس طربا وامتاعا وإشباعاً . أما اختيار ” القاهرة ” مركز للانطلاق فقد كان اختيارا موفقا في جوانبه التاريخية والجغرافية والعملية .
على أن إيثار الشعر دون غيره من أجناس الأدب – حتى وإن حمل حرارة الهوى الشخصي – فإن التحليل الموضوعي كان ظهيرا قويا لهذا الاختيار ، يقول منشيء المؤسسة وراعيها ( كاشفا عن هدف قومي يتجاوز الحنين والفخر إلى استعادة الثقة وبناء الأمل ) : إن ” بريطانيا تفخر بشاعرها العظيم شكسبير ، وفرنسا بشاعريها بودلير وهوجو، وروسيا تعتز بشاعرها بوشكين ، وأسبانيا بشاعرها لوركا ، وباكستان تعتبر محمد إقبال من أكبر مؤسسيها والمبشرين بإنشائها من خلال شعره ، وإيران تتيه على الدنيا بعمر الخيام وحافظ وسعدي الشيرازي . أفلا يحق لأمة العرب أن تفخر بسلسلة ذهبية من شعرائها العظام من امرئ القيس .. والمتنبي والمعري ، وحتى أحمد شوقي والشابي والأخطل الصغير والسياب ؟ وهي سلسلة لم تنقطع منذ أكثر من خمسة عشر قرنا ؟! ” ، وكذلك يشير البابطين – في كلمته هذه – إلى حق الأمة العربية في أن تفخر مع عنترة وعمرو بن كلثوم ، فتخرج من دائرة أحزانها !! وهذه إضافة نفسية مهمة ، ويضارعها في الأهمية إشارته إلى أهمية أن ينتشر الشعر العربي بين امة المثقفين والقراء ، فلا يبقى حضوره قاصرا على الدارسين والأكاديميين(6) .
وإذا كانت هذه الورقة التي نحن بصدد إنجازها تذكر ” الثقافة ” ولا تذكر “الشعر ” تحديدا ، فإن من معاني الشعر : المعرفة والعلم ( ومنه : ليت شعري ، أي : ليتني أعلم ) ، وهذا التوسع في معنى الشعر هو ما يعضده المأثور العربي في مقولة إن ” الشعر ديوان العرب ” ، وما تستعيده كلمات رئيس المؤسسة – في مقدمته المشار إليه – أن الشعر سجل العرب الموثوق الذي تغلغل في أدق شؤونهم فدونها وحفظها ، باعتبار الشاعر صاحب وعي متقدم بما وهبه الله من القدرة على الإبداع والشفافية ونفاذ البصيرة .
على أننا – من جانب آخر – سنرى كيف تفجرت ينابيع الثقافة والمعرفة وأنواع الفنون ، وأقيمت أسواق للأدب ، وللكتب بأنواعها ، من الشعر وحول الشعر ، فكان عمادها، الملائم بين أطرافها ، الموحد والملتقي لفروعها .
كان البدء بالشعر توفيقا من الله سبحانه ، ونفاذ بصيرة وصدق حدس أتاح للبداية الرهيفة أن تستحصد وتقوى وتتأصل بقواها الذاتية ، وفي هذا تلتقي الخبرة الكويتية الخاصة مع الخبرة العربية العامة في ضرورة الاهتداء إلى ” صيغة ” يتوافق الناس عليها، ويتقبلونها عن رضا وسماحة ، إذا أريد للمجتمع أن يتوحد على مفهوم عام للاستنارة والتقدم . لقد كان للكويت تجربة خاصة في هذا الاتجاه ، إذ عانت العثرات والشقاقات في مضمار التواصل مع قيم الحداثة وتحقيق التقدم . وقد ذكر مؤرخ الكويت الشيخ عبد العزيز الرشيد – في كتابه المؤسس : ” تاريخ الكويت “(7) أن الشيخ محمد رشيد رضا – تلميذ الإمام محمد عبده وأحد أبرز مريديه في الدعوة إلى تجديد ( المعرفة ) بالدين والشريعة ، كان قد زار الكويت ، وأخذ يدعو إلى منهجه التجديدي فوجد متحمسين كثر ، ولكن فتوى صدرت عن شيخ يدعى ” العلجي ” – وهو أحسائي يتردد على أتباعه في الكويت – تحكم على الشيخ رشيد رضا بالكفر واستباحة دمه . ويذكر خليفة الوقيان ( نقلا عن عبد العزيز الرشيد ) أن هذه الأزمة الثقافية الاجتماعية جرت عام 1911 ، ونستطيع أن نتصور فداحة الموقف والتهابه حين يقول الرشيد نقلا عن بعض أتباع العلجي: إن قتل ثلاثة من أهل الكويت ثمن لدخول الجنة بغير حساب : الشيخ يوسف بن عيسى القناعي ، والشيخ الشاعر صقر الشبيب ، والمؤرخ عبد العزيز الرشيد نفسه !! (8) .
وهنا نضيف أمرين :
الأول : أن هذا الصدام حول تحديث الثقافة ، وتجديد الخطاب الديني في الكويت ، كان حاضرا في إقامة مشروعاتها المبكرة ( قبل ظهور النفط ) مثل إنشاء مدرسة حديثة أو ناد للأدب ، أو مكتبة .. إلخ . بل إن خليفة الوقيان يدين الصورة الثقافية الراهنة ( في الكويت ) حتى تقول عبارته : ” أصبح التوجه الثقافي الرسمي للدولة من خلال بعض أجهزتها : الإعلام والأوقاف والتربية ، يتجه نحو تقبيح الحياة وتنفير النشء من الدنيا ، وتصويرها بأنها ممر مليء بالآثام ، ولذلك فإن استعجال الموت خير من طلب الحياة والبقاء ، ومن ثم العمل ، والإسهام في تنمية المجتمع . وحين نتساءل عن دور مؤسسات الدولة واستراتيجيتها الثقافية لتنمية الإنسان ، واستثمار طاقاته في البناء ، وإعداده لمواجهة تحديات العصر ، فلن نجد جوابا . فالأمور متروكة للاجتهادات الفردية من جهة ، والخضوع لابتزاز من يملكون الصوت المرتفع من جهة أخرى(9).. ” !! – ونرى – في مراجعة هذه الغضبة – أن ” الاستراتيجية الثقافية العامة ” غائبة على المستوى العربي العام ، فالكويت لا تنفرد بهذا – بل نرى – ما سبق أن قلناه – إن الرسالة الثقافية التي ترعاها الكويت وتنفذها وتلتزم بها أمام كل المستجدات من الأحداث – لا تزال الأكثر أصالة ووعيا ورعاية للقيم الإنسانية والمطالب المستقبلية . من ثم فإن كل ما أخذه ( الشاعر ) خليفة الوقيان على نشاط بعض التوجهات لعله يحتاج تصويبا وتوجيها تربويا دون أن يعلق إصلاحه على ” استراتيجية ثقافية ” – لم يعرفها أي قطر عربي ، ولا يتوقع أحد كيف تكون أو متى تكون ؟(10)
الثاني : أنه منذ مطالع القرن التاسع عشر ، وحتى هذه المرحلة التي نعايشها ( طوال مائتي عام تقريبا ) ، قد تطلع مفكرون ذوو قدر في علمهم ومكانتهم بين شعوبهم ، كلهم مسلمون ، وبعضهم عرب ، تطلعوا إلى وضع مشروعات لتأسيس نهضة ( حركة إحياء وتجديد ) فكرية ثقافية دينية حضارية ، ربما جمع أكثرها بين النهوض وتحرير الوطن من الاستعمار الغربي ، واكتفى بعض منها ببث الدعوة إلى تجديد الفكر وتنمية الثقافة ، ولكن أحدا من هؤلاء لم يستطع أن يحقق مشروعه بحيث يأخذ فرصته كاملة فيبلغ مداه ، وتجني الأمة ثمراته . لقد واجهوا – جميعا ، على التقريب – معارضة من مواطنيهم أو قطاع ضخم منهم ، ولم تكن السلطة السياسية ( الوطنية ) أو القوى الاستعمارية ( بالطبع ) لتنصرهم وتيسر لهم حرية التواصل مع جماهيرهم ، فلقي أكثرهم ربه ، بعد عمر قصير أو طويل ، وقد أفعم إحباطا وألما ، يتهدده شعور بأن مشروعه – الذي لم يعط فرصة للعمل بحرية – مرتبط بشخصه وليس له من نصير، فإذا تولى هذا .. انقضى أمر ذاك !!
لا نجد السياق ملائما لأن نتوسع في هذا الاتجاه ، وقد يكفي أن نذكر بالعشرة الذين أرخ لهم وعرّف بمبادئهم الإصلاحية وتوجهاتهم الفكرية : أحمد أمين ، في كتابه : ” زعماء الإصلاح في العصر الحديث ” ( نشر عام 1948 ) وهم حسب ترتيب ذكرهم في الكتاب(11) :
- محمد بن عبد الوهاب .
- مدحت باشا .
- السيد جمال الدين الأفغاني .
- السيد أحمد خان .
- السيد أمير علي .
- خير الدين باشا التونسي .
- علي باشا مبارك .
- عبدالله نديم .
- السيد عبد الرحمن الكواكبي .
- الشيخ محمد عبده .
لقد مضت عقود من السنين تفصل بيننا وبين آخرهم رحيلا ، ولعل هذه المسافة تأذن بنظرة ” موضوعية ” – لا أقول : للتعرف على شخصياتهم وحقائق أفكارهم ، فقد تعودنا أن نختلف على هذا أشد الاختلاف مهما توافرت لدينا المعلومات وتكشفت الأسرار والظروف ، ولكن أرى أن هذه النظرة الموضوعية المطلوبة ينبغي أن تتجه إلى قياس جدوى هذه الدعوات والأفكار ، وما آلت إليه على يد الشانئين أو الأنصار !! ماذا بقي منها، وما مدى استطاعته أن يكون أداة بناء لمطالب الحياة اليوم ، وأداة تفاعل لمطالب الحياة في المستقبل .
لن تغيب عن أفهامنا اعتبارات : إذ ليسوا في جملتهم من العرب ، وإن كانوا جميعا مسلمين ، فهنا أربعة من الترك والأفغان والهنود – كما استجدت أسماء ذات قدر ومكانة وتأثير ( الشريف حسين ، وعبد العزيز آل سعود ، وجمال عبد الناصر ) ولهؤلاء جميعا أعمال عظيمة ، وليس التساؤل عن هذه الأعمال ، بل عن قدرتها على تأسيس حياة جديدة، وقد أثار انتباهي ما عرض له مالك بن نبي في كتابه الذي نحن بصدده : ” مشكلة الثقافة”(12) وهو إعجابه المنقوص بمبدأ ” عدم الانحياز ” الذي اجتمع عليه عبد الناصر ، ونهرو ، وشو إن لاي ، وكيف أنه أوجد رابطة معادلة أو متحفظة على الانحياز إلى المعسكر الغربي، أو إلى المعسكر الشرقي ، وأقام تكتلا جديدا ، أما النقض فقد جاء من جهة أن هذه الرابطة ظلت ” سياسية ” بين ثلاثة من الزعماء ، ولم يكن لها اهتمام بالمستوى الثقافي العام ، الذي يعمل في التقريب بين هذه المجتمعات ، ولغياب التقارب أو التوحد الثقافي كان من اليسير فك الارتباط السياسي وكأنه لم يكن !!
لعلنا نقترب الآن من الإجابة على السؤال الافتراضي : لماذا كان البدء بالشعر ؟ وللجواب بقية ، ولكنها بقية تأتي في جواب سؤال افتراضي آخر : إلى أي مدى يعّد الشعر ” ثقافة ” ، بالمعنى الاصطلاحي العلمي ، الذي يحصر ” الثقافة ” في إطار علم الاجتماع ، إذ هي – من هذا المنظور – سواء كانت ثمرة الفكر – حسب المفهوم الغربي ( اليميني )، أو ثمرة المجتمع – حسب المفهوم اليساري أو الاشتراكي – صورة سلوك متكيف بموروث متراكم من العقائد والتقاليد والعادات والأفكار واللغة والتعليم(13) . إن هذا الفرز لمكونات الثقافة يكشف عن مستوى من التطابق في المكونات التي هي بذاتها حاضرة ماثلة في الشعر ، مع قيد واحد : أن الثقافة – بهذا المعنى الاجتماعي – سلوك ، أمّا الشعر فهو فن قولي ، محدد بشروطه ، تستوعبه الجماعة ، فينتشر بدوره في أثناء مقولات الجماعة ( الإنسانية ) وعقائدها وعاداتها ولغتها وأفكارها وكافة موروثاتها . ومن هذه الجهة – بصفة خاصة ، أي قدرة الشعر على ممازجة كافة الحالات السابقة الإشارة إليها ، كان المدخل الشعري إلى إحياء التراث ، وإلى إحياء دوافع النهضة ، وإلى إضاءة المسالك إلى تحقيق هذه النهضة .. كان المدخل الأكثر قبولا ، وأمانا ، وترحيبا ، وإثارة ، وإشباعا ، وإمتاعا لدى الجمهور ، وكان المدخل الأقل استفزازا وإثارة للتوتر والتحفز لدى أصحاب السلطة ، الذين يكتفون – عادة – بقراءة العناوين الكبيرة ، وهي عادة عناوين مسالمة ، حتى وإن انطوت على مقولات متمردة أو غاضبة ..
هناك إضافات مضيئة في هذا السياق ، الذي طرحنا فيه ( عبر كتاب أحمد أمين ) عشرة أسماء كبيرة لزعماء الإصلاح ، وفيما رأينا ونرى ، أن هذه المشروعات جميعا لم تكن طريقها سالكة ، وأن أكثرها أحبط ، وأن ما تحقق من بعضها لم يكن الجانب الأمثل لصنع النهضة واستعادة شخصية الأمة .
- يقول مالك بن نبي : إن الثقافة تتحدد بعناصرها المستمدة من الروح الأخلاقي والجمال ، ” على أن القيمة الجمالية يجب أن ينظر إليها خاصة من الوجهة التربوية ، فهي تسهم في خلق نموذج إنشائي متميز يهب الحياة نسقا معينا ، واتجاها ثابتا في التاريخ ، بفضل ما وهب من أذواق وتناسب جمالي “(14)
[ هل نلاحظ كيف بدأ الفيلسوف الجزائري بتحديد الثقافة ، وانتهى بأن ألقى بأهم مقاليدها بين يدي الفن والشعر خاصة ، بفضل ما وهب الشعراء من أذواق ومن قدرتهم على تحقيق التناسب الجمالي ؟ ]
ويقول أيضا : ” قد يحدث أن يخطئ الفتى المسلم في تقديره للمشكلات والأشياء ، فهو غالبا ما يخطئ عندما يعتقد أن الذي ينقصه في وضعه الراهن إنما هو الصاروخ ، أو على الأقل : البندقية التي يؤدي بها – كما يتوهم – واجبه العاجل .
فضميره هنا قد أصيب بانحراف ؛ لأنه يحسب حساب حضوره الفذّ وسط عالم يشعر بأنه لا مكان له فيه ، ولكنه يفسر أصل دائه تفسيرا خاطئًا حتى يعزوه إلى نقص ( أشياء ) كثيرة في حياته ، على حين أن ما ينقصه هو ( الأفكار ) !!(15)
[ الأفكار ، وليس الأشياء ، هي ما نحتاج إليه لتحقيق النهضة ، بعبارة أخرى . الثقافة هي المقدمة الأولى لتحقيق التقدم ، والشعر هو العنوان الرئيسي والمدخل المرضيّ عنه طريقا إلى المقدمة . كم نشعر بالحاجة إلى استيعاب هذا المعنى ولمحاولة تصحيح ما يضطرم به الوطن العربي ، والعالم الإسلامي من نزاعات دامية تقوم على الاستعلاء بالأشياء ، وإهمال الأفكار ]
ويقول أخيرا كاشفا عن مفارقة مثيرة : ” إن تراث ابن خلدون قد ظهر في العالم الإسلامي ، ومع ذلك لم يسهم في تقدمه العقلي والاجتماعي ، لأن هذا التراث في ذلك العصر كان يمثل فكرة لا صلة لها إطلاقا بالوسط الاجتماعي ” كما ذكرنا مالك بن نبي من قبل أن علماء الأزهر في مصر ، وعلماء الزيتونة في تونس كانوا – في جملتهم معارضين لدعوات محمد عبده المجددة !!
[ وهنا يحق لنا أن نطيل النظر في مغزى البدء بالشعر ، حرصا على التواصل مع الوسط الاجتماعي ، ثم التوسع في طرائق الثقافة ومستويات خطابها وهدافها ]
- وفي المحور الفكري نفسه يقول الفيلسوف زكي نجيب محمود :
” حين تتناقض طاقة الخيال ، يتراجع – بهذا التناقض – المثل الأعلى الذي يعمل من أجل تحقيقه ، وهذا المثل / الهدف هو الذي ينسيك مشاق الطريق “(16)
[ وهذا رصد حيّ وصادق للربط بين قوة الخيال وسمو الفكر الذي يسعى إلى تحقيق المثل الأعلى ، فنحن – بهذا – لم نغادر دائرة الشعر ومكانته في البنية الثقافية / الاجتماعية العامة . على أن في هذا الاقتباس نوعا من الأنس لصاحب المؤسسة الذي يبذل جهد الطاقة من أجل إبلاغ مؤسسته ومجتمعه هذا المثل الأعلى ]
ويقول أيضا :
” إن أية فكرة علمية لا تكتمل وظيفتها إلاّ إذا جاءت خطوة مع غيرها من خطوات تكون هي ” الوسائل ” المؤدية إلى نتيجة مطلوبة لتغيير الموقف المراد تغييره .(17)
[ وهذا كلام في صميم المنهج عامة ، واستراتيجية الإصلاح والتغيير خاصة ، فالحقول المعرفية ، وإن بدت في خطوط منفصلة ، متوازية أو متقاطعة ، أو مربعات .. إلخ ، فإنها في مرحلة عملها لا تنفصل أو لا يمكن عزل بعضها عن بعض في واقع الحياة العملية ، كما في عمليات الذهن القائمة على الفرز والتركيب دون توقف ، بما يعني – فيما نحن بصدده – أن ديناميكية التوسع في أنشطة المؤسسة تجاه وسائل العناية بالشعر ، ثم بالفكر العام : السياسي والحضاري ، ثم بالثقافات الأخرى – كما سنرى – هذا التوسع أملاه قانون معرفي مهيمن ، ولو ظلت قضية المؤسسة أن تشجع الشعراء وتمنحهم الجوائز ، ما بلغت ما بلغته اليوم وما يعد به مستقبلها من تغيير وتجديد واستنارة ، بل ربما تراجع نشاطها – حال انحصاره – فأدى إلى انحسار قد تحجب فيه جائزتها ذات يوم لأنها لا تجد الشاعر الذي يستحقها ] .
ويقول زكي نجيب محمود أيضا ، عن حدود الإحياء ومغزاه :
” إذا ما طالبنا أنفسنا بإحياء الماضي إحياء يسري به في جسم الحياة الحاضرة ؛ وإن ذلك المعنى المبهم ليأخذ في الظهور حين نتصور محاكاة الأواخر للأوائل ، على نحو يجعلها محاكاة في ” الاتجاه ” ، لا في خطوات السير ، محاكاة في ” الموقف ” لا مادة المشكلات وأساليب حلها ، محاكاة في ” النظرة ” لا في تفصيلات ما يقع عليه البصر ، محاكاة في أن يكون العربي الجديد مبدعا لما هو أصيل ، كما كان أسلافه يبدعون ، دون أن تكون الثمرة المستحدثة على يدي العربي الجديد هي نفسها الثمرة التي استحدثها العربي القديم ، محاكاة في ” القيم ” التي يقاس عليها ما يصح وما لا يصح … هكذا تكون حالنا إذا ما استعرنا من الأقدمين ” قيمة ” عاشوا بها ، ونريد اليوم أن نعيش بها مثلهم ، لكن الذي نختلف فيه وإياهم هو المجال الذي ندير عليه تلك القيمة المستعارة “(18)
[ هنا يستقر البرهان على أن البدء في نشاط المؤسسة بالشعر كان فيه حكمة وبصيرة ، وإن زكي نجيب محمود في كتابه الذي نقلنا عنه النص السابق ” قيم من التراث ” بدأ منظومة القيم التي عني بها ، باللغة العربية ” لأن أول ما يميز العربي – بداهة – هو أن لسانه عربي ” ، ولا أحد يماري في أن الشعر خلاصة اللغة العربية وبهاؤها ورونقها ، فضلا عن محتواه الذي اكتنز أسرارها النفسية وتاريخها : مسراتها وأحزانها ، مفاخرها ومكامن قوتها ، وأسباب تدهورها…إلخ . كما أنه في تحديده لإحياء التراث لا يدعو إلى استعادة المشهد ، بل إلى ” تجريد ” المعنى فيه ، يريد من إحياء تراث الآباء أن يسري في حياتنا الحاضرة ” سريان الزيت في الزيتونة ” ، ويقول : ” ولقد يسهل على بعضنا – أحيانا – أن يطالبوا الشاعر في يومنا بأن ينظم على غرار ما نظم الأقدمون ، أو أن يحكم القاضي في الناس بما كان يحكم به قضاة الأمس البعيد ، ولكن ماذا عساهم أن يقولوا في علماء اليوم وبين أيديهم من المسائل والتجارب ما لم يحلم به أحد من السابقين – ولست أريد بالسابقين – أولئك الذين عاشوا منذ كذا قرنا من الزمان ، بل أريد من عاش منهم في القرن الماضي أو الذي سبقه !!(19) ]
القول فيما بين الشعر وإحياء الحركة الثقافية من تكامل عضوي :
لدينا أربعة مبادئ ” علمية ” نسترشد بها في تعقب حركة ” النشوء والارتقاء ” التي سارت عليها ” مؤسسة الجائزة ” ما بين حفلها الأول بالقاهرة ( 1989 ) وحفلها الراهن بمراكش (2014 ) ومسيرتها عبر خمسة وعشرين عاما بما زرعت فيها من علامات . إن المثل / المثال المشاهد ، والموعود ، هو الحبّة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ، ومثل المصباح في الكوة ، يرسل ضوءه إلى مختلف الجهات(20) ، أما المبادئ الثلاثة فقد أشرنا إلى أولها ، وهو أنه لا شيء يولد كاملا ، وإنما يبدأ على قدر من التلقائية والبساطة ، ثم تتهيأ له الأسباب الموضوعية التي توجهه إلى طريق الاكتمال . والثاني : أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ؛ فإذا تحدد هدف المؤسسة المبكر في منطوقها المبكر أنها ” تعني بالشعر دون سواه من الأجناس الأدبية ” فإن العناية بالشعر قد تبدأ بمنح جائزة سخية لأجود قصيدة ، أو ديوان أو شاعر ، ولكن هذه العناية بالشعر تستوعب الثقافة العربية ماضيا وحاضرا ومستقبلا ، ولا شك في أن العناية بالشعر ماضيا ( = تراثا ) يفتح الطريق إلى تحقيق نصوص هذا الشعر التراثي ، وشرحها ، والتعريف بشعرائها .. إلخ ، أما العناية براهن الشعر ( = حاضرا ) فله نقاط اهتمام أخرى ، وكذلك مستقبلا . وقد عملت المؤسسة في كل المحاور الثلاثة ، لم تسبقها حركة إحياء أو اعتناء بالشعر إلى ما أنجزته ، وتسعى في استكماله ، فنجد ” معجم الشعراء ” يمتد في اتجاهين مستوعبا الماقبل ، وجاهزا لتلقي المابعد ، كما سنرى . أما المبدأ الثالث فإن علماء تاريخ اللغات يقرون بأن اللغة العربية من أقدم اللغات الحية التي تعود جذورها إلى اللغة السامية ( الأم ) ، واللغة العربية التي نعرفها ( نكتبها ونقرؤها ) تحتفظ بوصف الأقدم ، والأطول حياة ، حتى حال اتخاذ الشعر الجاهلي نقطة ابتداء !!
وأسباب هذا الامتداد تستند إلى دوافع مقدسة ( دينية ) وحضارية ( تاريخية ) لا ينتقص منها أن تتعدد اللهجات العامية بتعدد أقاليم الأمة العربي ، ولا ينتقص من بهاء الشعر العربي ورونق ديباجته عبر العصور وإلى يومنا ، أن تحاول طوائف من الشعراء أن تقترب من حياة الناس ، في لغتهم اليومية ، ومجازاتهم المستحدثة ، وإيقاعاتهم المولدة أو المسترفدة ، فينظموا الموشحات ، والمواويل ، إلى أن يصلوا إلى الشعر النبطي والقصيدة العامية .
وأخيرا يأتي المبدأ الرابع ، وهو أن الثقافة الحبيسة أو المغلقة على نفسها في حدود وطنها تشبه الغرفة المغلقة المحددة بجدرانها ، تظل تلوك مقولاتها ، وقصارى طاقاتها في تجنب ما سبق ترديده أن تعيد إنتاجه بعبارة مختلفة ، أو تقلب معانيه كأن يتحول المدح إلى هجاء ، أو إلى رثاء .. وهكذا ، ويختلف الأمر بالنسبة للثقافات المفتوحة على العالم ، ولهذا السبب كان الشعر الجاهلي محدود الأغراض محدود الخيال ، فإذا قورن بالشعر العباسي أو الأندلسي وقد انتشر العرب بين أمم الأرض وتعرفوا على حضاراتها فقد توسعوا في أغراض الشعر ، وفي مباني القصائد ، وفي صور الخيال ، وفي الإيقاعات كذلك ، وبالمثل فإن المدن التي تقع على البحار المفتوحة هي أكثر تفننا وتقدما وثقافة من المدن المعزولة وإن تكن في الإقليم نفسه ، وتحت السلطة ذاتها ، ولأن الثقافة العربية عاشت التجربتين فإنه لم يكن بدّ من تعقب منابعها ومصباتها ، وتفحص روافدها على مستوى خارطة الثقافة الإنسانية .
ثم نعود إلى السؤال ( حجر الزاوية ) في هذه الفقرة ؟
كيف اتجهت أنشطة ” مؤسسة البابطين ” إلى إحياء الشعر في ذاته ( نصوصه ) والشعر من حيث هو مرتكز وواسطة عقد دراسات أخرى لا محيد عن إحيائها في مستواها التاريخي ، والتهيؤ لها وإعمالها في مناهجها المستحدثة ؟
وهنا نشير إلى مسألة / موقف نتخذه عن عمد ، ونستثمره فيما بعد ، وهو أننا نقتصر في قراءتنا لجهود ” مؤسسة البابطين ” في إحياء الثقافة العربية – على الأنشطة التي تشارك فيها جماهير المثقفين ، والراغبين في الثقافة بوجه عام .
أولا : الدورات :
هذه الدورة التي نتنسم عبيرها اليوم ، بمدينة مراكش ذات العراقة التاريخية والتميز الثقافي تحمل الرقم الرابع عشر ، كما تحمل اسم ” أبي تمام الطائي ” – ولا نفصل في هذا ودلالته ، فبحوث الدورة ستفي بهذا المطلب على أكمل وجه . ومن المهم أن نتعقب أسماء الشعراء في تسلسلهم وقد حملت الدورات أسماءهم ، وربما حددت إطار البحوث التي تجري حول فنهم الشعري ، أو تبحث في مستجدات أزمنتهم .
لقد استقر الأمر على أن تعقد كل دورة بعد عامين من سابقتها ، وأن ينتقل مكان الانعقاد إلى قطر مختلف ، ولكن الدورة الأولى ( 17 مايو 1990 بالقاهرة ) والدورة الثانية ( 17 أكتوبر 1991 بالقاهرة كذلك ) خالفنا في هذا ، كما لم تحمل إحداهما اسم شاعر ، بما يعني أن إشهار “مولد ” المؤسسة ، وإعلان الجوائز وتسليمها لمستحقيها كان القصد الأول . وفي أعقاب هذه الدور الثانية بدأ تحليل الموقف ، ونقد التجربة ، واستثمار النجاح، فكانت الدورة الثالثة بمثابة منح الوليد الجديد اسما ، والارتفاع بحجم الجوائز ( وقد بدأ هذا بالدورة الثانية ) . فقد عقدت هذه الدورة الثالثة تحت اسم : ” محمود سامي البارودي ” ( وتم التجاوز عن شرط العامين إذ عقدت في ديسمبر 1992 ، وكذلك عقدت في القاهرة مثل سابقتيها ) . كما تم ” تثبيت ” محاور الجوائز :
- جائزة الإبداع لشاعر . [ عن جملة نتاجه الشعري ]
- جائزة الإبداع لناقد الشعر .
- جائزة أفضل ديوان شعر .
- جائزة أفضل قصيدة .
هذه الأركان الأربعة هي التي تحدد هيكل المنافسة للحصول على جوائز المؤسسة ، وهي مستقرة – مع اختلاف محدود – منذ الدورة الأولى وإلى اليوم . أما دورة البارودي فيمكن أن تعد ” الدورة النموذج ” التي اكتملت أركانها ، ومن ثم تستحق أن تكون الخطوة الأولى ، الأقوى ثباتا ، في اتجاه ” مؤسسة البابطين ” إلى إحياء الحركة الثقافية العربية . فلأول مرة لم تتوقف الاحتفالية عند توزيع الجوائز وإلقاء كلمات من الفائزين ، لقد أقيم ما أطلق عليه ” الندوة المصاحبة ” – وهي ذات محورين : الأول عن شعر البارودي – شعار الاحتفالية – والآخر عن أهم قضايا الشعر المعاصر . عن شعر البارودي بحث يوسف خليف في : شعر البارودي بين التراث والمعاصرة ، ومحمد فتوح أحمد في : معارضات البارودي في ضوء الدراسات النقدية الحديثة ، ومحمود علي مكي في : مختارات البارودي، وعبد القادر القط في : البارودي بشير الاتجاه الوجداني في الشعر العربي الحديث . أما المحور الآخر ، فقد بحث فيه : رجاء النقاش : تطور المضمون في القصيدة العربية المعاصرة ، وبول شاؤول : علاقة القصيدة المعاصرة بالفنون الأخرى ، وعبدالله الغذامي : التشكيل اللغوي في القصيدة العربية المعاصرة ، ونعيم اليافي ، في : الصورة في القصيدة العربية المعاصرة .
وهنا ننبه إلى : أن هذه الدراسات النقدية التي انقسمت ما بين جلاء فن البارودي الشعري ، وخصائصه في ذاته ، وبالنسبة للعصور السابقة عليه التي كونت ثقافته ، وبين قضايا الشعر المعاصر ، أي بعد رحيل البارودي بقرن كامل ( تقريبا ) هو في هذه القسمة كشف لمسيرة الشعر العربي منذ العصر العباسي الثاني ( بافتراض أنه العصر الذي نال إعجاب البارودي ، فوقفت اختياراته عليه ) ، وحتى زمن انعقاد هذه الندوة . وكما نرى في أسماء الباحثين ، فإنهم – دون استثناء – علماء مشهود هم بالتميز في النقد ، مع سعة الثقافة ، ودقة التوثيق . وقد كلف هؤلاء جميعا بإعداد بحوثهم قبل انعقاد الندوة بزمن كاف، بعد الحصول على موافقاتهم ، وما يستتبع هذا من نفقات .
لقد استقرت الندوة عنصرا ثابتا ، ويمكننا أن نلاحظ الاختلاف في موضوعاتها بما يصب في دائرة الثقافة ، والتراث ، والعالمية .. فقد تقاطرت الدورات ، والندوات المصاحبة / أو الموازية ، على هذا النسق :
الدورة الثالثة : محمود سامي البارودي – القاهرة – 1992 م .
والندوة المصاحبة عن شعر البارودي ، وعن القصيدة المعاصرة .
الدورة الرابعة : أبو القاسم الشابي – فاس – 1994 م .
الندوة المصاحبة : أربع جلسات عن شعر الشابي : تأثره وتأثيره ، وثلاث جلسات عن الخطاب الشعري المعاصر ، وفي كل من هذه الجلسات السبع عرض بحثان .
الدورة الخامسة : أحمد مشاري العدواني – مدينة أبو ظبي – 1996 م .
الندوة المصاحبة : جلستان عن شعر العدواني ، في الأولى طرحت قضية الشكل ، وفي الأخرى : المضمون ، وفي الجلسة الثانية شهادة ناقد ، ثم شهادة شاعر .
ثم أربع جلسات : اثنتان عن عدد من شعراء الخليج واليمن ، من أهمهم : خالد الفرج ، ومحمد محمود الزبيري ، وإبراهيم العريض ، وخليفة الوقيان ، وسيف الرحبي ، وقاسم حداد ، واثنتان عن مرجعية القصيدة العربية المعاصرة في المشرق العربي ، وفي المغرب العربي ، ومصر والسودان ، ثم الخليج .
الدورة السادسة : الأخطل الصغير – بيروت – 1998 م .
الندوة المصاحبة : جلستان ، في كل جلسة بحثان عن شعر الأخطل الصغير ، وجلستان عن قراءة القصيدة : الحرة ، والرومانسية ، والتقليدية . ولأول مرة تعقد جلسة خاصة لعرض ورقة كتبها مبارك الخاطر ، وعرضت على هامش الندوة ، وكان موضوعها : مقدمة في بواكير العلاقات الثقافية .. بين بلاد الشام والخليج العربي من 1900 – 1950 .
الدورة السابعة : أبو فراس الحمداني ، والأمير عبد القادر الجزائري – الجــزائر –
2000 م .
وكانت هذه أول دورة تجمع في عنوانها بين شاعرين ، أميرين ، وقد انقسمت بحوث الندوة ( أربع جلسات ) بين دراسة شعر أبي فراس وشعر عصره وهو غزير ، ودراسة الشعر الجزائري في عصر الأمير عبد القادر ، مع دراسة عن شعره القليل .
الدورة الثامنة : علي بن المقرب العيوني ، وإبراهيم طوقان – المنامة ( عاصمـــة
البحرين ) – 2002 م .
وفي هذه الدورة تكرر الجمع الاحتفالي بين شاعرين ليست بينهما رابطة عضوية أو تراسل فني .
وكذلك منحت جائزة الإبداع في مجال الشعر لشاعر رحل ( إبراهيم العريض ) تقديرا لدوره إبان حياته ( توفى في مايو 2002 ، أي قبل عقد الندوة بأربعة أشهر ) .
أما الندوة المصاحبة ( ثلاث جلسات ) فقد فاز فيها ابن المقرب وشعراء شرقي الجزيرة بجلستين ، وكانت الأخيرة قسمة بين شعر طوقان ، وشعر المقاومة بوجه عام .
الدورة التاسعة : ابن زيدون – قرطبة ( إسبانيا ) – 2004 م .
وهي من الدورات المفصلية ، كما سنرى ، وتضاهي دورة البارودي في الأهمية ، وتتجاوزها في آفاق الرؤية .
وإذ استأثر ابن زيدون – وحده – بشعار الدورة ( مع إقرار المشاركة في دورتين سابقتين ) فإن الازدواج فرض نفسه على الندوة المصاحبة ، فكان البدء بندوة الحوار الحضاري ( ست جلسات ) عن صورة الآخر ، والأديان الثلاثة ، والعلاقات الاقتصادية، والثقافة ، والتطرف ، والثقافة والعولمة ، والأقليات .
أما الندوة الأدبية ( ست جلسات أيضا ) فكانت عن شعر ابن زيدون، في زمانه ، وأثره الحاضر ، واستحضار الأندلس في الشعر الإسباني المعاصر ، وفي الشعر البرتغالي .
الدورة العاشرة : شوقي ولامرتين – باريس ( فرنسا ) – 2006 م .
عود إلى المزاوجة في الشعار ، وتم الاختيار على أسس التوجه ، وتعد هذه الدورة استثمارًا للنجاح الذي حققته دورة ابن زيدون في قرطبة .
ألقى رئيس المؤسسة ، والرئيس الإيراني محمد خاتمي ( ضيف الدورة ) وغيرهما أيضا كلمات غاية في الأهمية .
وقد مضت الندوات في مرحلتين / شقين :
أولا : ندوة الثقافة وحوار الحضارات : ( ثلاث جلسات ) عن : التعددية الثقافية في عالم متغير – محور الإصلاح والتنمية – محور المشترك الحضاري والثقافي .
ونلاحظ هنا : الالتفات الواضح لكلمة ” الثقافة ” واتخاذها مرتكزا لحوار الحضارات .
ثانيا : الندوة الأدبية : ( ثلاث جلسات ) : المشترك الثقافي – محور شوقي – محور لامرتين .
الدورة الحادية عشرة : دورة معجم البابطين – الكويت – 2008 م .
وهي أول دورة تعقد جلساتها في المدينة / المقر للمؤسسة ( وموطن منشئها وراعيها ) .
وقد حافظت على ” الشكل ” السائد : ندوة حوار الحضارات ، ثم الندوة الأدبية ، كما سيطر التوجه إلى الثقافة ، التي ألقيت إليها مقاليد حل الفرقة المحتدمة بين ” الشرق الإسلامي ” و ” الغرب الأوروبي ” .
على أن هذه الدورة صاحبها نشر عدد من المطبوعات المهمة : دواوين وأعمال شعرية كاملة ، ودراسات تدعم اتجاه حوار الحضارات . مما يلفت الاهتمام عنوان الندوة المصاحبة الأولى : ” في حوار الحضارات والتعايش بين الثقافات والأديان ،عالم اليوم: ثقافات ومصالح ( ثلاث جلسات ) عن : المشهد الثقافي العالمي والحضارات السائدة فيه – وقراءة نقدية له – وصراع المصالح وتأثيره في المشهد الثقافي العالمي – وحوار الثقافات طريقة إلى حل القضايا – ودور المفكرين ومؤسسات المجتمع المدني في حوار الثقافات .
أما الندوة الأخرى عن المعجم ( معجم القرنين ) فقد عرضت للمنهج الذي اتبع في الترجمة لكل شاعر ، وأسلوب الاختيار من شعره ، ومعياره ، والشعر والهوية ، وإرهاصات النهضة ، وقيم المأثور الحاضرة في قصيدة القرنين .
الدورة الثانية عشرة : خليـــل مطران ، ومحمـــد علي / مــــاك دزدار – ســـراييفو
( البوسنة ) – 2010 م .
وهنا عود إلى المزاوجة بين شاعرين لم يعرف أحدهما الآخر ، وإن تلاقيا على بعض الملامح الفنية . كما واكب الدورة صدور عدد من المطبوعات المهمة ، عن الشاعرين : مختارات ، ودراسات نقدية ، والبوسنة في الشعر العربي المعاصر .. إلخ .
وكذلك انقسمت الندوة المصاحبة إلى ندوتين :
حوار الحضارات : التباين والانسجام في نظام عالمي مختلف ، أربعة بحوث ( في جلسة واحدة ) آخرها عن : البعد الثقافي في حوار الحضارات .
أما الندوة الأدبية فقد نالت ثلاث جلسات ، الأولى عن شعر محمد علي / ماك دزدار ، مع الاهتمام بمكوناته الثقافية ، والثانية عن المشترك الثقافي العربي البسنوي في العصر الحديث ، والثالثة عن دور الاستشراق البوسنوي في التعريف بالأدب العربي .
الدورة الثالثة عشرة : الحوار العربي الأوروبي في القرن الحادي والعشرين : نحو
رؤية مشتركة – مقر البرلمان الأوروبي – بروكسل (بلجيكا) – 2013 م.
وهنا نلمس تغيرات جذرية :
- فلأول مرة لا تحمل الدورة اسم شاعر ، وإنما تحمل عنوان قضية ، والقضية ليست مستجلبة من خارج السياق ، وإنما أسست لها ندوات حوار الحضارات ، التي تعاقبت منذ دورة ابن زيدون ( التاسعة – 2004 ) أي أن التمهيد لهذا الطرح المباشر المعمق احتاج إلى عشر سنوات عقدت فيها أربع ندوات مصاحبة للدورات .
- تخلت هذه الدورة عن الأوراق البحثية ، يعدها باحث ويعقب عليها باحث آخر أعد بحثه سلفا ، ثم يتوالى من يرغب من حاضري الجلسة . هذه المرة تحدد الباحثون ، ولكن لطرح رؤاهم في إطار عنوان الجلسة ، من ثم تعاقبت ثلاث جلسات تحت عناوين : إعادة التفكير في الديموقراطية – وسائل التواصل الاجتماعي .. فضاء جديد للديموقراطية – التعليم والمواطنة : أدوات أساسية للقرن الحادي والعشرين .
أما أصحاب الرؤي المطروحة فأغلبهم ممن شغلوا مناصب سياسية ، ومارسوا إصدار القرار في دولهم ،من العرب ومن غيرهم .
وقد تكلم في الافتتاح أو الختام أو كليهما ، بدأتها توكيا صيفي نائب رئيس البرلمان الأوربي ، ثم الممثل الأعلى لتحالف الحضارات في الأمم المتحدة ( رئيس البرتغال السابق ) ثم كلمة رئيس مجلس الأمة ( الكويتي ) وفي الختام تكلم رئيس المؤسسة .
كما صدر بيان ختامي ..
كانت الكلمات جميعا تؤكد ، كما كان البيان الختامي يقرر الحرص على تحقيق الأهداف المعلنة المحددة للدورة ، وهي : إيجاد أرضية مشتركة ونقاط التقاء وتفاهم بين شعوب العالم ، وتحقيق التفاهم بين بني الإنسان على اختلاف مشاربهم .
* * *
التحليل الرأسي للدورات :
حرصنا على تسجيل عناوين الدورات ، وتقديم توصيف مختصر للمكونات المميزة لكل دورة على حده ، ونادرا ما كنا نلجأ إلى الربط أو الموازنة . لم يكن القصد مجرد التوثيق ؛ فهذه المعلومات موثقة على نحو أكثر نظاما وتفصيلا في كتاب أصدرته المؤسسة وأعادت طباعته في هذه الدورة ( الرابعة عشرة ) بعنوان : ” سنوات من العطاء الثقافي ” ، وإنما كان القصد أن نستحضر هذه الركائز لنعيد قراءتها فنكشف عن أثر التجريب واكتساب الخبرة عبر مسيرة الدورات ، وما صاحب هذه المسيرة من مكتسبات هي في صميم ” إحياء الحركة الثقافية العربية ” الذي تسعى هذه الورقة إلى جلاء صورته ، والتأكيد على الجوانب الإيجابية التي قد لا يعتنى بإبرازها ، وكأنها مجرد أدوات ، أو إجراءات تنظيمية ، أو ضرورات . ربما أشرنا إلى بعض من هذا فيما سبق ، ولكننا – هنا – نستخلص الضوابط والمكتسبات ، التي تتجاوز ما سطرته أقلام الباحثين ، فإن الثقافة العربية ، وإحياء الثقافة العربية ليست عبارات مسطورة في سياقات البحوث أو عناوينها وحسب ، إنها – فيما ينبغي أن تكون – حاضرة باقتناع عملي في كل قرار ، وكل خطوة ، وكل نسق .
- سبق عرفنا أن الدورة الأولى ، وكذلك الثانية كانت لا تتجاوز أن تكون ” احتفالية ” لتوزيع الجوائز ، وطبيعي أن عمليات الترشح والفرز والتصنيف واختيار المحكمين وتحديد الفائزين ( وهي عمليات ليست هينة بأية حال ) هي التي كانت تسبق الاحتفالية ، ولكن : بدءا من الدورة الثالثة تغيرت الصورة ، وتحولت الاحتفالية إلى دورة تثقيفية منظمة ، منقسمة في بحوثها بين ما هو مختص بالشاعر المحتفى به ( البارودي ) وإن كان يطرح من منظور نقدي حديث وحداثي ، وما هو متسع للشعر المعاصر في قضاياه الحاضرة .
هذه النقلة في تطوير مفهوم الاحتفال بأحسن شاعر ، وناقد ، وديوان ، وقصيدة ، من مجرد الإعلان عن الفائزين ومنحهم الجوائز ، إلى عقد مهرجان ثقافي ، معرفي، متخصص ، تضفي عليه الشخصيات المتمرسة بالبحث في الموضوع ، يتبعها مريدوها وتلاميذها والمتطلعون إلى مكانتها ، والراغبون في ودادها ، فينتج من هذا محفل ثقافي تعبوي ، يتجاوز بصورته العصرية ، المنظمة ، المهيأة ، أسواق الأدب في متخيلها المأثور ما بين عكاظ الجاهلي ، والمربد الأموي ، وقد استطاعت ” مؤسسة البابطين ” أن تضع ثوابت الاحتفاليات الثقافية التي تستحق عن جدارة أن تعلن أنها ترعى الإبداع في كل جوانبه .
- لقد كانت جائزة الإبداع في نقد الشعر ملازمة لجائزة إبداع الشعر ، وهذا الربط الحصيف المستنير تحقق منذ إنشاء المؤسسة ولازم مسيرتها ، ويمكن النظر إلى أن بحوث الندوة المصاحبة ( وهي نشاط نقدي خالص لوجه الشعر إلاّ في حالات نادرة ) على أنها توسع وإضافة إلى جائزة النقد ، كما ينظر إلى الأمسيات الشعرية التي يتبارى فيها الشعراء من جميع الأعمار والمستويات والتوجهات – على أنها توسع وإضافة إلى جائزة ( جوائز ) الشعر ، وتنشيط ” كوادر ” في موقع ” الجاهزية ” للتقدم للحصول على جوائز المؤسسة فيما يأتي ..
- وقد حرصت الدورات على تحقيق التنوع ، والتوازن ، والملاءمة ، في مجال اختيار الباحثين ، فمع الحرص على التخصص وسلامة المنهج يواكبه حرص آخر على تنويع الباحثين بحيث لا تبدو المؤسسة – من حيث لم تقصد – ذات انتماء إقليمي أو مذهبي أو سياسي ، ( وهذا التجرد من كافة نزعات المرحلة أشار إليه رئيس المؤسسة في افتتاحياته ، معبرا عن حرص المؤسسة على تجنب الأيدلوجيات السياسية ، واختلافات العقائد الدينية ، والنزعات المذهبية )(21) وكذلك التنوع في رئاسة الجلسات ، وإن تكن ” رمزية ” أكثر منها ” عملية ” .
وفي ندوة الحوار الحضاري ، حين تكون القضايا موضع البحث ذات طرفين : عربي ، وغربي ، وحتى في الندوة الأدبية حين يكون الشاعر المحتفى به له صورتان : عربية ، وغربية ، مثل : ابن زيدون ، ولامرتين ، ومحمد علي / ماك دز دار ، ( وسعدي الشيرازي في سياق آخر : الملتقيات ) فقد حرصت المؤسسة على تجنب الصوت الواحد ، وأن تنفرد ( الرؤية العربية ) بتوجيه الرأي في الموضوع أو الشخصية ، من ثم كان الحرص على أن يتحقق التنوع في كل جلسة دون إخلال بمبدأ التنوع والاختلاف ( وليس شرطا أن يؤدي الاختلاف إلى خلاف ، فهذا مرهون بفكر الباحثين ومناهجهم ) وبهذا يتحقق – عمليا – أهم مبادئ حوار الثقافات ، وأولها : اللقاء على أرضية ( موضوع ) مشترك ، والالتزام بمنهج علمي معلن ، وتوثيق المعلومات ، وتكون المعرفة – وليست الغلبة – هي الهدف المشترك .
- وفي كافة احتفالات المؤسسة : ( الدورات ، والملتقيات ) وحتى في مشاركتها في احتفالات ثقافية تستدعيها مناسبات وطنية أو اجتماعية ، فإن المؤسسة تحرص على إقامة معرض للكتب يتيح الحصول على مطبوعاتها بالمجان .
- وكذلك تحرص المؤسسة على إغناء احتفالاتها ( سواء في الدورات أو الملتقيات كما في الحفل التقليدي الذي يقام في شهر مارس من كل عام تحت عنوان : ” ربيع الشعر ” وهذا الإغناء له وسائل متعددة ، تسعى إلى اجتذاب ومخاطبة المستويات الاجتماعية والفكرية المتفاوتة ، بحيث يصل إلى كل مستوى ما يطلبه أو تتوق إليه نفسه ، فمع معرض الكتب ، تقام أمسيات شعرية ، وأمسيات للغناء الشعبي وما يصاحبه من عزف ورقص ، وحتى في هذا السياق الشعبي لم يكن وقفا على الفرق الشعبية الكويتية ، فقد شاركت فنون لبنان ، وسورية ، وتونس وغيرها في مثل هذه الأنشطة .
- وتتأكد الرغبة في مد الجسور المعرفية ، والسعي إلى نيل الثقة من مداخلها وبوسائلها العملية ، وذلك بالحرص على ثلاثة أمور :
الأمر الأول : توجيه الدعوة إلى كبراء البلد المضيف للدورة ، أو الملتقى ، ممن لهم مصداقية فكرية ورصيد شعبي من التوافق ، وهذا التوجه يختلف عن التقليد المألوف وهو حضور رئيس الدولة المضيفة أو من ينوب عنه في حفل الافتتاح ، فقد حضر الرئيس محمد خاتمي افتتاح ملتقى سعدي الشيرازي ( طهران – شيراز 2000م ) بصفته رئيس الجمهورية الإيرانية الإسلامية ، ولكنه شارك في دورة شوقي ولامرتين في باريس بعد ذلك بست سنوات (2006م) بصفته الشخصية مفكرا وصاحب رؤية حضارية وثقافة عالية .
الأمر الثاني : الحرص على أن تتواصل ” المؤسسة ” مع الجهة المناظرة لها ، أو القريبة من نهجها وأهدافها في البلد المضيف للدورة ، فتتعاون معها على أداء مهمتها ، إذ أن هذه الجهة المناظرة – بالضرورة – تملك إمكانات للحركة وقدرة على الفعل من خلال خبرتها بأرضها ومجتمعها:
- فقد أقيمت احتفالية أبي القاسم الشابي بمدينة فاس بالتعاون مع جمعية ” فاس سايس ” المغربية .
- وأقيمت احتفالية أحمد مشاري العدواني بمدينة أبو ظبي بالتعاون مع المجمع الثقافي .
- وأقيمت دورة أبي فراس الحمداني والأمير عبد القادر الجزائري بالجزائر ( العاصمة ) بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصال والثقافة الجزائرية ، واتحاد الكتاب الجزائريين (كما كانت دورة ابن زيدون تقام في جامعة قرطبة )
- وكانت دورة شوقي ولامرتين في باريس بتعاون فني ومعنوي مع منظمة اليونسكو .
الأمر الثالث : إصدار الكتب التكريمية ( للأحياء ) ، والتذكارية ( للراحلين ) عن العاملين الذين أثرى وجودهم خطة المؤسسة في إحياء الثقافة العربية في كافة وجوه أنشطتها . وقد بدأ التكريم بإصدار كتاب عن عبد العزيز السريع ، الذي شغل موقع أمين عام المؤسسة عددا من السنين ، وقد حرره أصدقاء المحتفى به ، وافتتحه رئيس المؤسسة بكلمة وفية منه .
بعد ذلك صدرت كتب تذكارية وتكريمية عن : عز الدين إسماعيل ، وأبو القاسم كرو ، ومحمد عبد المنعم خفاجي ، وعدنان الشايجي ، وعبد العزيز جمعة ،وكان لكل منهم أثر خاص في خدمة المؤسسة .
- ومن المهم أن نراقب ديناميكية التحرك بين موضوعات الدورات ، وأماكن إقامتها ، وكيف كانت القاهرة حاضنة وسكنا للبدايات ( ثلاث دورات متعاقبة ) حتى إذا نبت ريش القوادم أصبح الطيران في الأجواء الأليفة مطلبا وغاية ، فإذا ما استحصدت الأجنحة واستوعبت التجربة كانت الوثبة الأولى خارج الديار : إلى أقرب الجيران بالجغرافيا والتاريخ ( طهران : سعدي الشيرازي – 2000 م) ثم إلى الجار التاريخي ( قرطبة – 2004 م) ، ومنها إلى باريس – ( 2006 م) وحتى لا يكون مطنة التغريب أو استقطاب حوار الحضارات لاهتمام المؤسسة ، تكون انعطافة دالة في اختيار سراييفو وشاعرها محمد علي ( 2010 م) لتكون الوثبة الكبرى إلى أقصى الأرض : بروكسل ، مقر الاتحاد الأوروبي (2013 م) وفيه تتحدث ” مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري ، ليس باسم الكويت ، وإنما باسم الأمة العربية ، والحضارة العربية ، والثقافة العربية ، في حوار ثقافي علمي صريح ، مواجهة مع أوروبا الموحدة . وتمثيل هذه المؤسسة الكويتية للأمة العربية وتوجيه الخطاب باسمها أوضح ما يكون في وثائق هذه الدورة .
- وقد كان في بينيات الثقافة موضع رعاية منذ استقر نهج الدورات ، فقد كان البارودي يقول الشعر بالعربية والتركية ، وكان العدواني ينظم الموزون المقفى ، كما يشكل القصيدة ذات التفعيلة ، ويصنع الشعر النبطي وينظم الأغاني ، وقد عرض الباحثون إلى هذه الجوانب جميعا . وكانت هذه المرونة في تحقيق الأمانة البحثية التي أذنت بتقديم جائزة التفوق في مجال شعر التفعيلة (22) منذ الدورة الثانية ( 1991 م) جاهزة لأن تستوعب شعر الشيرازي ( العربي والفارسي ) وشعر ابن لعبون ( النبطي ) والشعر المترجم للامارتين ، ولمحمد علي / ماك دز دار ، وكما أن هذه المساحات البينية المتأثرة بمختلف الثقافات تفتح الطريق إلى مجاوزة المرتكز العربي في المكان إلى القفزة التي جسدتها دورة قرطبة ، فإنها هي التي فتحت الطريق إلى محور جديد هو ” الحوار بين الحضارات ” أو : الحضارة العربية في مقابل – وليس في مواجهة – الحضارة الغربية ، وما لبث هذا المحور أن أخذ مداه التمهيدي المشبع في ” قرطبة ” ثم في فرنسا ، لينفرد بالاهتمام ، إذ يتحول فيه ، أو ينتهي البحث العلمي فيه إلى قرارات في بروكسل ( 2013 ) وفي الكلمة الختامية التي ألقاها ” رئيس المؤسسة ” يثبت حق المؤسسة في ريادة هذا التوجه الثقافي الحواري مع أوروبا ، فيقول :
” لقد أقامت مؤسسة البابطين لحوار الحضارات سلسلة من ندوات الحوار الحضاري ، في عدد من الدول الأوروبية ، وأنشأت منظمة للحوار الحضاري .. ليتعرف كل طرف إلى الطرف الآخر على حقيقته ، لا على الصورة المتخيلة أو النمطية(23) ” ، من ثم أعلن البيان الختامي ” تأسيس الهيئة الدولية للحوار والتوافق ” التي تمثل الضمير الإنساني في جميع بقاع العالم ، يقوم عليها نخبة من المثقفين والمفكرين والسياسيين المنشغلين بحياة الإنسان وكرامته ومصيره “.
أما التقدير الخاص الذي عبر عنه نائب رئيس البرلمان الأوروبي في كلمته الختامية ، تجاه ” مؤسسة البابطين ” فقد نبه إلى أنه وجه الشكر مرات إلى القائمين على أعمال المؤسسة ، وهذا التقدير ” جدير بمؤسسة ذات مكانة عظيمة مثل مؤسسة البابطين التي تتعهد منذ سنوات عدة القيام بمستلزمات الحوار بين الثقافات والأديان المتعددة .
وفيما يخص المحور الثقافي وأثره في تغيير مستقبل العالم ، يقول نائب رئيس البرلمان الأوروبي : ” إنني مقتنع تماما ، منذ زمن طويل – أن إجراء الحوارات الثقافية بمقدوره أن يمثل الدعامة الأساسية لبناء عالم جديد وأفضل ، اكرر ذلك ، وأنا مقتنع تماما بالأهمية القصوى التي يلعبها التلوث الثقافي ” الثقافة السلبية ” في تشكيل كل واحد منا “(24) .
حين يصبح ( الهامش ) موازيا ومنافسا للمتن !!
لعله من الواضح ( الآن ) بطريقة لا لبس فيها أننا لا نكتب تاريخا للمؤسسة ، ( فهو مكتوب موثق ) ، ولا نعرّف بالمتداول المألوف عند مانحي جوائز الإبداع الأدبي والفكري في الوطن العربي ، فشروط الجوائز مشهرة ، ويعلن عنها في الصحف كل موسم ، والكتب المطبوعة تتصدر واجهة المعرض المصاحب لكل دورة . بل أجازف فأزعم أنني – في هذه الورقة – لم أوجه اهتمامي إلى تقصّي صور وروافد وأساليب ” مؤسسة البابطين ” في إحياء الحركة الثقافية العربية . بقدر ما وجهته إلى تحليل الصورة ، وتفسير الروافد ، والكشف عن أبعاد الأساليب في اتجاه إحياء الحركة الثقافية العربية . وإذا كنا أبدينا اعتناءً واضحا في رصد الدورات الأربع عشرة : زمانا عبر ربع قرن ، ومكانا ما بين القاهرة وبروكسل ، وتنوعا في الموضوعات والمحاور المصاحبة – فما ذلك إلى لأن هذه الدورات هي صانعة المجرى الرئيسي للنهر الثقافي الذي حفرته المؤسسة ويرتوي من زلاله ملايين البشر من أبناء الأمة العربية ، وجهات أخرى مذكورة . ولأن هذا المجرى النهري الرئيسي كان المهم والمغذي لكل ما قام على شاطئيه من أنشطة مبهرة .
* * *
ثانيا : تنويعات على اللحن الأساسي
أ : الملتقيات
وقد ( اخترعت ) المؤسسة خط ” الملتقيات ” الذي اتجه إلى الشعراء ، كأنما استبطأ انتظار حلول موعد الدورة ( كل عامين ) كما سبق له أن استبطأ الاكتفاء بشاعر واحد شعارا لكل دورة فتسامح في تجاور شاعرين ، ( لأدنى ملابسة بينهما ) ، وقد سمح هذا ” الانفلات ” المحسوب من قيود الدورات ، وضوابطها الصارمة ، بمرونة أكثر في الاختيار ، وفي تنويع مستويات الخطاب الثقافي ، ويمكن ملاحظة هذا بمجرد قراءة عناوين الملتقيات :
- ملتقى العيون الشعري – مدينة العيون – المغرب – 1997 م .
- ملتقى محمد بن لعبون – الكويت – 1997 م .
- متقى سعدي الشيرازي – طهران – شيراز – 2000 م .
- ملتقى الرحيل والميلاد ( وجمع بين الشاعر عبدالله الفرج ( الكويتي ) وأمين نخلة ( اللبناني ) – الكويت – 2001 م .
- متقى الكويت الأول للشعر العربي في العراق – الكويت – 2005 م .
- ملتقى محمد عبد المنعم خفاجي ، وعدنان الشايجي – القاهرة – 2009 م .
- ملتقى الشعر من أجل التعايش السلمي – دبيّ ( الإمارات العربية المتحدة ) -2011 م .
ليس من الإنصاف أن نضع هذه الملتقيات في ” هامش ” نشاط الدورات ، وإن لم تكن حاضرة منذ البدء ( الدورة الأولى 1990 ) وقد اقترنت إقامتها بصدور الطبعة الأولى من ” معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين ” وقيام المؤسسة بتوزيعه ( إهداء ) على التجمعات الثقافية في العواصم والمدن العربية . وإذا كانت الكويت ( العاصمة ) قد فازت مكانا بثلاثة ملتقيات ( من السبعة ) فإنها – بالمكان – قد نالت حقها ( المهضوم ) في الدورات ، أما التكوين الثقافي للملتقى ، فإنه بذاته من الناحية الحيوية ، ومن التنوع مثل صدور مطبوعات جديدة ، وإقامة معرض للكتب ، ولكنه يتفوق على الملتقيات في الاهتمام بالإنشاد وإلقاء الشعر ، وإعطاء الفرصة لشعراء الصف الثاني الراحلين من حيث الاهتمام بحيواتهم ، وإعادة طبع إنتاجهم الشعري ، والدراسات التي تناولتهم .
ب: مهرجان ربيع الشعر
ويعقد في شهر مارس من كل عام ، وهو أقرب إلى تكوين ” الملتقيات ” إذ يمنح فرصة أوسع لإنشاد المواهب الشعرية الجديدة ( الشابة ) ، كما يمنح فرصة كاملة لأن تكون الكويت ( العاصمة ) مزدانة كل عام باحتفالية شعرية ، فقد بدأ المهرجان الأول في مارس 2008 م ، واستمر في الموعد ( مارس ) كل عام دون انقطاع ، واستعاد إلى حاضر الشعر العربي أسماء أخفاها زحام الشعراء مثل عبدالله زكريا الأنصاري ، وعبدالله سنان ، وأحمد السقاف وغيرهم من الكويت ، ومثل الخريّف من تونس ، وشاعر البراري من مصر.
على أنه – في سياق مهرجان الربيع – أقيم في شهر مارس 2013 م ” ملتقى عبدالله سنان وشاعر البراري محمد السيد شحاتة ” وبينهما الكثير من أوجه التشابه السلوكي والفني ، كما أقيم في شهر مارس 2014 م ملتقى – آخر – باسم ” محمد الفايز وعمر أبو ريشة ” ، وبينهما الكثير من أوجه التشابه خاصة فيما يتعلق بفن الغزل ، والعلاقة بالحياة جملة ، وبهذا اجتمع ” مهرجان ربيع الشعر ” ، و ” مسار ” الملتقيات بقصد إغناء الاحتفاليات التي تختص بها مدينة الكويت ، وإكسابها بريقا تستحقه باعتبارها أهم عواصم الشعر العربي في هذا العصر .
وهنا يمكن أن نقول إنه منذ قرنين من الزمان ( وربما منذ ثمانية قرون فقد أشار ابن خلدون في سيرته الذاتية إلى شيء مما نشير إليه ) كانت القاهرة قلب الثقافة العربية ، كانت القلب = مركز الدائرة ، ومن حولها الأطراف ، وكانت القلب = المنطقة الأكثر حياة وتأثيرا في تطلعها إلى التجديد وكثرة مبدعيها .
وكانت مناطق الأطراف ( ومنها دول منطقة الخليج ) بطبيعة الموقع ، ونمط الحياة البدوية ، وصعوبة الاتصال بالعالم الخارجي ( الأوروبي خاصة ) تعيش في حيز الصدى الذي يصلها من المنطقة ( القلب ) . لقد تغير الوضع الآن ، بالجهود الرائعة التي بذلتها وتبذلها الكويت في تنمية وتجديد الثقافة العربية ، ورصد الميزانيات الضخمة للتأليف ، والترجمة ، والنشر بأسعار في متناول القارئ البسيط ، والطالب الذي يشتري الكتاب من مصروف جيبه الخاص الذي نعرف مقداره . وقد مضت ” مؤسسة البابطين ” في الاتجاه نفسه ، وإن التزمت بدائرة الإبداع الشعري وما يتطلبه إحياء وتجديد وتشجيع هذا الإبداع عن مساندة ومتابعة علمية ، من ثم حدث التوازن الثقافي بين القلب والأطراف ، فأصبح الجهد مشتركا ، والحوار ممتدا ، والغايات واحدة أو متقاربة جدا .
ونعود إلى مهرجان ربيع الشعر ، فنقول إنه في مهرجان ربيع الشعر ( السنوي ) تحقق توازن بين ثلاثة مطالب تلتقي عند هدف أساسي هو أن يكون الشعر حاضرا دون انقطاع في حياتنا الثقافية ، وان يكون لمقر المؤسسة نصيب مستحق في كل عام . أما المطالب الثلاثة فأولها : إعطاء فرصة واسعة لشباب الشعراء للإنشاد ، ومواجهة الجمهور، وسماع انطباعات النقاد ، وثانيها : استمرار الاهتمام بشعراء الصف الثاني من الراحلين أو الأقل ( نجومية ) في زمانهم ، وثالثهما : استضافة شاعر كبير من ذوي الحضور الجماهيري ليقدم باقة من أشعاره . وقد تحققت هذه المطالب الثلاثة .
وإذًا ، فإننا لا نعمد إلى إحصاء أوجه نشاط المؤسسة في مجال الثقافة ، ولكن نعنى بإظهار خصوصية هذا النشاط من حيث انه مبتكر لا يقلد ولا يتعقب خطى تجارب سابقة ، ومن حيث أنه موجه إلى الجمهور العام حريصا على مخاطبة كافة مستوياته الاجتماعية والثقافية ، مقدما لكل منها ، ومستعينا بعناصر من صميمها – على تفاوتها – في توجيه الرسالة ، وفي تلقيها على السواء . وفي الفقرة الآتية – الأخيرة – من هذه الورقة ، سنقدم تحليلا غير تقليدي ، أو تعليلا إذا شئت ، لما يعيشه الوطن العربي الإسلامي من أزمة ثقة ، وتشعب في الأهداف إلى حد التنافر بين قطاعاته أو جماعاته ، وكيف أن هذا في جوهره يعود بأزمة المجتمع إلى أزمة في الثقافة : في المفاهيم وفي أساليب العمل الممكنة والمشروعة لبلوغ هذه المفاهيم ، وسنرى كيف أن ” أزمة الثقافة ” تفتح الطريق إلى الجمود والتخلف والتنكر للمستقبل ، إذ يتحول ” الماضي ” إلى ” مستقبل ” وهذا ضد طبائع الأشياء ، وضد ما يكتنز العقل الجمعي من خبرات التجريب ، فهذا التجريب هو الملوّن الأساسي والفاعل في العقل ، والعقل يدرك أن من المحال أن يصبح الماضي مستقبلا نسعى إليه ، ليس لمخالفة هذا لقوانين الزمن وحدها ، وإنما لأن التاريخ لا يعيد نفسه ، وأن الأحداث ، حتى وإن تشابهت في ظاهرها ، أو تقاربت ، فإنها ، في جوهرها ، ينطوي كل منها على شروطه المميزة له ، والتي لا تجعله – بأية حال – مجرد ” صورة طبق الأصل “يمكن استعادتها بالوسائل التي صنعتها في سياقها الزمني الماضي أو القديم .
* * *
القول فيما للثقافة من أثر في تكوين الإنسان
لا تزال لدينا أسئلة عالقة ، ربما أكثر من تلك التي حاولنا أن نجيب عليها !! منها : هل كان الأوفق أن تكون هذه الفقرة بمثابة المدخل لما سبق ذكره ، بدلا من أن تكون في الختام ؟ وهل ترانا قد حصلنا على تعريف المتلقي – وليس لنا أن نصادر حكمه فنسأله إذا ما كان قد وجد فيما ذكرنا مقنعا أم لا – بدور ” مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري ” في إحياء الحركة الثقافية العربية ؟
مهما يكن الجواب ، فهذا ما جرى ، ولا أملك ، وقد انتهيت منه – إلاّ أن أنسب إليه كما ينتسب إليّ ، وأن أوضح سبب اختياري ، ليس من موقع الدفاع بل من موقع الاقتناع والرؤية الخاصة .
إن كتاب التعريف بالمؤسسة ، في طبعته الثانية أضاف كلمة واحدة إلى العنوان في الطبعة السابقة : ” سنوات من العطاء الثقافي ” ووصف العطاء بأنه ثقافي هو الإضافة المقصودة ، وفيه مغزى عميق على علمنا بأن العطاء ” المالي ” الماثل في الجوائز السخية ، وفي الحرص على عدم حجب الجوائز ما أمكن ( ولم تحجب غير جائزتين على مدار ربع قرن منح فيه ما يتجاوز عدد المائة من الجوائز ) ، وفي إصدار المطبوعات ، التي تلاحق المناسبات ، فضلا عن تخصيص المنح الدراسية لطلاب من شرقي آسيا ، ومن أقطار أفريقيا ، وبناء المدارس ، وعقد دورات لتعليم العروض العربي ، والنحو .. إلخ .
ويبقى معجم / معاجم البابطين : ” للشعراء العرب المعاصرين ” ، وقد طبع ثلاث طبعات ، يزيد عدد الشعراء مع صدور كل طبعة ليلاحق الأسماء المستحدثة ويمنحها علامة الحضور في عصرها ، ويشجع فيها الموهبة الكامنة ، أما ” معجم شعراء البابطين للقرنين التاسع عشر والعشرين ” ، فقد تجاوز قدرات معاجم الشعر والشعراء منذ عرفتها العربية ، حتى ظهور طبعته الأولى (2008) في خمسة وعشرين جزءا .. على أنه ( وقبل أن يجف عرقه ) بدأت المؤسسة تأخذ أهبتها لإصدار ” معجم البابطين لشعراء العربية في خمسة قرون ” ( 1301 – 1800م ) هذه المعاجم ، في تتابعها دون توقف ، على ما هي عليه من دقة التوثيق ، والحرص على تحديث المعلومات ، وحسن اختيار نماذج الشعر ، وتوصيف خصوصية كل شاعر ( وهم آلاف ) والتعريف بما أبدعه ، وبما كتب عن شعره من نقد(25) ، مع المستوى الطباعي الراقي ، الذي لا يضاهي ، لا نسأل في : كم أنفق راعي المؤسسة من حر ماله ، فقد يصعب الحصر ، أو لعل عبد العزيز سعود البابطين نفسه لا يحبذ هذا ، ولا يريد أن يأخذ به خبرا ، وقد رأيناه يشارك بشعره في الملتقيات ، وفي مهرجانات الربيع ، فلا تجد اسمه يفتتح قوائم الشادين بأشعارهم ، أو يكون ختامهم ، وإنما هو شاعر في وسطهم ، لا يمنح نفسه شارة خاصة ولا يلفت إليه الأنظار بأية وسيلة . وهذا أمر يدركه أصحاب الفكر الواعي والعاطفة الراقية بالفطرة . وهو من خواص ” المثقف الحقيقي ” ، الذي ترتّب مشاعره على تقديره الإنسان بما هو إنسان ، بصرف النظر عن جميع المكتسبات ( المضافة ) !! ولا أزال أذكر مواقع جلوسنا في طائرة خاصة حملتنا من القاهرة إلى دمشق ، لتحملنا مجددا إلى طهران في ” ملتقى الشيرازي ” ، فقد كان راعي المؤسسة آخر الصاعدين إلى الطائرة ، ومقعده في آخرها ، شأن المضيف المثقف الذي استوعب آداب أمته العربية وهذا شأن ثقافي/عملي له أثره الحميد في جمهرة المشاركين ..
لقد سكتت هذه الورقة عن أنشطة متعددة تدخل في صميم ” إحياء الحركة الثقافية العربية ” وكل واحد منها : مثل المطبوعات التي أجيد اختيار موضوعاتها وقدمت إلى القارئ العصري محققة مدققة ، مشروحة ، ومثل المعارض التي تغتنم كل مناسبة لتجدها فرصة لتقديم هذه المطبوعات إلى كل راغب فيها ، دون ثمن . ومثل المعجم ، وهو المعجم الوحيد في تاريخ الشعر العربي ، منذ كانت معاجم الشعر ، وإلى اليوم ، الذي يمتد من جانبيه : زاحفا إلى شعراء الزمن الماضي قرنا بعد قرن ، حتى يكتشف منابعه ، وممتدا إلى شعراء الزمن الآتي ، حتى يلاحق كل ما يستجد في رواقه الممتد الجاهز لاستقبال كل ما يأتي ، وقدمت ترجماته ( وهي آلاف ) وفق نسق موحد ، ومعيار ثابت يحتكم إلى الفن الخالص ، وليس إلى الشهرة في أيٍّ من اتجاهاتها ، أو الإعجاب المرحلي مهما كانت دوافعه .
إن ” الثقافة ” هي العنصر الحاضر والثابت في كل ما تمارسه ” المؤسسة ” من أنشطة ، وهذا الحرص على الثقافة قد يحمل – في طياته – الرغبة في تجنب السياسة بصراعاتها وانحيازاتها غير الثابتة وغير المأمونة ، وتجنب قضايا العقائد والأديان ، وهي بالضرورة والمشاهدة والشهادة عبر القرون ، لا تخلو من دوافع الخصومة والاختلاف ، والانحياز لفريق للرد على فريق ) ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة * ولا يزالون مختلفين ، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ((26) ، أما الثقافة فهي اهتمام بالإنسان فيما هو به إنسان ، فإذا كان التوجه إلى الثقافة العربية فإن هذا يعني أن اهتمامها الأول بالإنسان العربي ، بما لا يناقض الأهداف الإنسانية في أي مكان أو عصر أو جنس ، لأن ” الثقافة ” تعتصم بالقيم ، والقيم لا تتناقض : هل يتناقض العدل مع الحرية ؟ هل نتصور تناقضا بين السلام وإرادة الخير ؟! هذا – إذًا – هو مرتكز التوجه الثقافي لدى ” مؤسسة البابطين ” من ثم حرصنا على رصد أنشطة الدورات والملتقيات ، وندوات ربيع الشعر ، وكل ما يأخذ طابعا احتفاليا يجتمع حوله الناس ويتفاعلون مع الموضوعات المعدة سلفا ، وبإمكانهم الإعلان عن رأيهم فيها في الساعة ذاتها ، فهنا تلتقي ثقافة المادة المقدمة ، مع ثقافة الأداء ، وثقافة التلقي ، حيث تتم دائرة المعرفة ما بين : المرسل والرسالة والمرسل إليه ، ويحكم على وسيلة الأداء ، ويقاس ردّ الفعل في الموقف ذاته ، وفي اللحظة ذاتها !!
هذا برهان ” المؤسسة ” الذي يعلن عن سمو الرسالة ورقيّ الوسيلة معا ، فإذا لاحظنا أسلوب اختيار أعضاء أمانة المؤسسة ، والعدل في القسمة بين الأقطار العربية ، ولاحظنا ديموقراطية اتخاذ القرار ، والحرص على التنقل بين العواصم والمدن ( على مساحة العالم ) ورأينا كيف ” اكتشف ” معجم الشعراء العرب المعاصرين مجتمعا شاعرا مثل ” موريتانيا ” لم يكن لنا به علم ، وكيف عرفنا بشعراء جزر القمر ، وشعراء يكتبون أشعارهم بالعربية في بلاد لا تتكلمها .. أدركنا المعنى الحقيقي ، والمدى الرائع الذي استحضرته وسائل ” المؤسسة ” وضخت في شرايينه دماء العربية بكل موروثها الثقافي التاريخي الرائع .
في عبارات مسكوكة تاريخية أو حديثة تتجلى قيمة الثقافة ، بأنها حقيقة الإنسان نفسه ، فإذا قال سقراط لمحدثه : تكلم حتى أعرفك . فإن أوائلنا العرب قالوا : المرء مخبوء تحت لسانه ، والمرء بأصغريه : قلبه ولسانه !! والآن تتداول عبارة : قل لي ماذا تقرأ أقل لك من أنت !!
هذه حقائق وجودية ( حقائق الإنسان بما هو موجود – كائن اجتماعي يعيش بين الناس ولا يستطيع الحياة دون تبادل وسائل المعيشة معهم ) بما يعني أن العمل في اتجاه تقارب المفاهيم ، وتوسعه مساحة التسامح ، ترتيبا على احترام مبادئ التعايش ، وطبيعة الاختلاف لعوامل موضوعية وتاريخية .. إلى آخره ، كل هذا الجهد الثقافي هو جهد في سبيل الرقيّ بالإنسان ومن ثم الحفاظ على سلامه الروحي ، وبنائه العقلي ، وإيمانه بخيرية الحياة والوجود .
نعود في هذه الفقرة الأخيرة إلى إحدى إضاءات مالك بن نبي في كتابه : ” مشكلة الثقافة ” ، يقول : ” من الواضح أن الضمير الإنساني في القرن العشرين لم يعد يتكون في إطار الوطن أو الإقليم ، هذا مع اعترافنا بأن أرض المولد التي يعيش عليها الناس تمدهم بالبواعث الحقيقية لمواقفهم العميقة . غير أن الضمير الإنساني في القرن العشرين إنما يتكون على ضوء الحوادث العالمية التي لا يستطيع أن يتخلص من تبعاتها ، فإن مصير أي جماعة إنسانية يتحدد جزء منه خارج حدودها الجغرافية ، فالثقافة أصبحت تحدد أخلاقيا وتاريخيا داخل تخطيط عالمي … ” (27) .
ولنا على هذا القول إضاءات قد تكون مطلوبة :
- إن مالك بن نبي ألف كتابه ” مشكلة الثقافة ” عام 1959 – أي في منتصف القرن العشرين ، مع هذا فإنه فطن بوعي وقوة إلى سطوة الثقافات الأخرى ( المتقدمة بوسائلها القادرة على التخطي والاقتحام ) وقدرتها على تشكيل الضمير ومن ثم التحكم في التصورات والأفكار ، فما بالنا – ونحن نجتاز العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ، وقد ارتفعت منذ عقدين دعوات ” العولمة ” بادئه بحرية الاقتصاد ، زاحفة ومتطلعة إلى حرية الثقافة ، وتملك من وسائل التوصيل والإبهار ما يتجاوز قدرتنا على إبطاء الأثر أو إبطاله أو التصدي له بالتفنيد والرفض ، كيف ستكون صورة الضمير ( العالمي ) ، ومن ثم ( العربي ) في الزمن القريب ؟!
- ونعيد ” قراءة ” الدورات والملتقيات ، التي عقدتها ” المؤسسة ” خارج إطار الوطن العربي ، ما بين إسبانيا ، وفرنسا ، وطهران ، والبوسنة ، وبلجيكا ، وكيف كانت هذه الملتقيات : موضع تقدير عظيم من قيادات المؤسسات السياسية والثقافية في تلك الدول . ونقرأ ما ترتب على اللقاء بين منشئ المؤسسة وراعيها ، وشخصيات هذه الدول من إنشاء كراسٍ وتخصصات لدراسة اللغة العربية وآدابها ، وتخصيص منح دراسية في مستوى طالب الجامعة ، وما قبلها . وليس أقل في الأهمية أن نشير إلى ما ترتب على هذه اللقاءات الثقافية ، المتحررة من أغراض السياسة وألاعيب الاستعلاء السلطوي ، من تقارب وتفاهم وثقة واحترام . كثيرا ما دلت قيادات أوربا على الضنّ به على العرب ( شعبا ) وعلى قياداتهم أيضا ، لعوامل متعددة ، ولكن : حين امتدت إليها يد المؤسسة بتاريخها وتجربتها الثقافية الجليلة، وتوجهها الإنساني ، ورغبتها الحقيقية في سيادة السلام والاحترام المتبادل القائم على التفاهم عبر الحوار والسعي إلى تقارب الثقافات – فازت ” المؤسسة ” بما لم تستطع جهات رسمية ( عربية ) عديدة أن تحققه !!
هل من المبالغة أن نقول إن الثقافة هي العامل المؤثر في أن يسود السلام الاجتماعي ، أو أن يتعرض هذا السلام للقلائل ؟ وأن الثقافة هي المسؤولة عن تنمية الرغبة في التقدم والتفكير في المستقبل ، أو الهرب إلى الماضي وعبادته ، أو الغيبي والاكتفاء به ؟ وأن الثقافة هي الرابط أو المادة اللاصقة ( اللحام ) الذي يربط سبائك أي مجتمع هو بالضرورة من قطاعات أو محاور أو مناطق أو أعراق بينها فروق ، وأن تشرذم الثقافة الواحدة وتمزقها إلى ” ثقافات ” هو المقدمة للاحتراب أو على الأقل : التنابذ وضياع الهوية ؟
في دراسة ذات مغزى نجد على صحتها دلائل مما نعيشه راهنا ، وهي بعنوان : ” عن الأساطير التأسيسية لتيارات الإسلام السياسي ” . يرى الكاتب(28) أن دعوات / أفكار المدينة الفاضلة على نبالتها لم تتحقق على أرض الواقع مطلقا ، وكذلك دعوات الأديان . تقول العبارة الاستهلالية في الدراسة : ” رغم نبلها ، لم تكن الأفكار اليوتوبية ، أي تلك الباحثة عن عوالم مثالية ، فاعلة في التاريخ الإنساني ، إذ لم يستطع المؤمنون بها أن يحققوها على الأرض ، بل يمكن القول إنها استخدمت ، كالأديان أحيانا ، ركيزة لفرض الهيمنة السياسية ، بدلا من أن تلعب دورها الأصلي ، كمصدر إلهام للضمير البشري ، يسهم في حصر نزعات الشر والقبح في التاريخ الإنساني الطويل(29) .
ثم يعرض الباحث لأهم ما تضمنت المدن المثالية بدءا من أفلاطون ، ومرورا بيوتوبيا توماس مور ، ومدينة الله للقديس أوغسطين ، كيف انطوت هذه المدن المتخيلة على استعباد العبيد والنساء والأطفال بدلا من مكافحة الرق ، وكيف احتقرت الفكرة الديموقراطية .. إلخ ، وفيما يخص القديس أوغسطين فإنه فصل بين المدينة السماوية والمدينة الأرضية ، وبالطبع فإنه قدم مدينة السماء ، مختصرا لهذه المدينة السماوية في الكنيسة ، والمدينة الأرضية في الدولة التي هي مدينة الإنسان ، وربما مدينة الشيطان ، ” تلك التي لا تملك أية سجايا أخلاقية خاصة بها ، ومن ثم فإن ما يحدد كونها مدينة الإنسان أو الشيطان إنما هو قدرتها على العمل في خدمة الكنيسة “(30) وإذ يمضي الباحث ( صلاح سالم ) في إبراز أهم ملامح ” اليوتوبيات ” المتعاقبة تاريخيا ، تلك الملامح الحالمة ، الشاطحة وراء تصورات نظنها مثالية ، على أسس دينية أو مبادئ اشتراكية .. إلخ ، فإنه يصل إلى ( الإسلام السياسي ) دون تفصيل أو فصل بين تياراته وأنماط تفكيره ، ودرجات اعتداله أو تشدده ، فإنه ( الباحث ) يرى أنها جميعها تنتهي إلى غاية واحدة تهيمن ذات مرحلة من مراحلها ” فالظاهرة برمتها تنهض على منطق واحد في النهاية ، وهو أن ثمة إمكانية لأن يشرف المقدس ( مباشرة ) ، أي بنفسه ، على تفاصيل حركة ( الدنيوي ) ، ولا يكتفي بتقديم التوجيهات وإلهام الغايات فقط ، وأن يبقى في الوقت نفسه مستقلا عن هذا الدنيوي ، فلا يصير ( مدنسا )(31) . ويقدم الباحث شرحا يعتمد على ممارسات مشاهدة تستند إلى مبادئ وأقوال هي نقيض لها ، ومع هذا تأبى أن تناقش شرعية وسلامة العلاقة بين المقدمات والنتائج ، فيقول :
” وهكذا لا يكون عجيبا أن تقود أكثر الأفكار نبلا وطهارة ، في لحظة معينة ، إلى أقبح الأفعال وأكثرها دناءة في لحظة أخرى تالية ، فباسم الله ، نور السموات والأرض ، يتم قتل الأطفال بلا معنى أو ذنب وهم أحباب الله ، ويجري التنكيل بالنساء وهم رعايا الله ، والتمثيل بالجنود القائمين على الحدود وهم المجاهدون حقا وفعلاً في سبيل الله . والأعجب من ذلك أن يقع ذلك بيدي شخص يدعي أنه أكثر إسلاماً من العوام ، وأكثر حرصا على طاعة الله ، والكارثة أنه قد يكون صادقا حقا فيما يعتقد عندما استبطن اعتقاده هذا ، غير أن المسافة الزمنية الفاصلة بين انبثاق الفكرة في ضميره ، وتحركها نحو ذراعه ، عبر قنوات إرادته وتربيته وتثقيفه ، قد امتلأت بشتى أنواع الآفات ، وكل أشكال المدنس من كهانة بادية لدى أمير ، ومصالح دنيا تحولت إلى شر مستطير ، ومصاعب واقع وآلام حياة ورغبات بشر ، وأهواء حكام تصوغ شبكة معقدة تتوه فيها الحقيقة ، وتنطمس الروح ، ويتحول معها الحب المفترض أنه من روح الله ، إلى الحقد الذي هو نفسه الشيطان . ومن حركة الروح على الطريق من الحب المقدس إلى الحقد المدنس ، تتصاعد المواقف وتتطرف الأفكار وصولا إلى لحظات الانفجار “(32)
يرتب الكاتب هذه المفارقة والتناقض بين الإيمان النظري ، والسلوك العملي طرح قضايا الوطن والمواطنة ومفهومها بين الديني والدنيوي ، ومفهوم الهوية الدينية وكيف يكون استدراجا إلى الانفصال عن تيار الحضارة وحركة التاريخ ، وغير هذا مما يؤدي إلى أن يعيش الفرد ، وتعيش الجماعة – المتعلقة باليوتوبيا الحالمة بإمكان تحققها على أرض الواقع – معزولة عن العالم ، كأنما تعيش تاريخها الخاص قسرا ، أو : خارج التاريخ الإنساني العام !!
وقد نجد تفسيرا آخر لهذه المدن الحالمة بتصورات يراها أصحابها أنها تحقق للإنسان ( الأرضي ) حياة ( سماوية ) يحلمون به دون أن يعنّوا أنفسهم بالتفكير بأن أحلام النوم قد تتحقق ، أما أحلام اليقظة فإنها غير قابلة للتحقيق !! (33) .
هذا ما ينبغي الالتفات إليه والاهتمام به : أن المؤسسة لا تصدر في غايتها بالثقافة العربية عن مفهوم تقليدي جامد ، متقولب في صيغ متوارثة لا يستطيع أن يتجاوزها . كانت المؤسسة تهتبل المناسبات لتضخ مزيدا من التنوع الثقافي أينما حلت ؛ ففي ” ملتقى الرحيل والميلاد ” : ضمن إسهامات المؤسسة في احتفال الكويت باختيارها عاصمة للثقافة العربية ( العام 2001 ) امتد احتفال المؤسسة بهذه المناسبة على مدار العام : فأصدرت المفكرة الشعرية ، وأقامت أمسيتين شعريتين عن فهد العسكر ومحمود شوقي الأيوبي ، وأقامت مسابقة شعرية ، وأصدرت ديوان مختارات شعرية في خمسة مجلدات شملت جميع الأقطار العربية ، كما أصدرت نسخة كاملة من ديوانيْ المحتفى بهما في الدورة : أمين نخلة وعبدالله الفرج … والمعنى أوالمغزى أن هذه المؤسسة لا تجد مجالا لاجتذاب المواطن العربي ، في أي قطر كان ، إلى تلقي منتجها إلاّ سعت إليه وأغرته بالإقبال عليها، وهذا هو العلاج الناجع الذي عجزت عن تحقيقه الأجهزة الحكومية العاملة في مجال الثقافة، على الرغم من تنوعها واعتمادها على كوادر من الموظفين جرارة ، ومتمرسة ، ولو شاءت لفعلت ، ولكن سعيها ، هو ما أدى إلى وجود أولئك المنابذين لمجتمعاهم ، الراضين بالخروج من التاريخ اقتناعا أو ثمرة لثقافة العزلة ، والسعي إلى تحقيق الأساطير المستحيلة .
في قرطبة ( عام 2004م ) أعرب رئيس جامعتها في خطاب الافتتاح عن شكره لثقة مؤسسة البابطين بجامعة قرطبة ، معلنا استعدادها للتعاون مع البلدان العربية في مجال التعليم والبحث ومختلف النشاطات الثقافية ، والمبادرات التي تحث على الحوار والتقارب من أجل السلام والتقدم .
هنا لابد أن نلاحظ رغبة التوسع النابعة من تقييمه لجهد ” المؤسسة ” التي تولت الأمر كله ، ففي كلمته يشير إلى استعداد جامعته للتعاون مع الدول العربية ( !! ) ، كما يضع الحوار المشترك ( المتوقع ) في إطار السلام والتقدم .
وفي باريس ( عام 2006 م ) يقول السيد محمد خاتمي متحدثا عن توجهات ” مؤسسة البابطين الثقافية “، وعنايتها بالحوار بين الحضارات:
” … ليس من العبث أن يكون عالم الأدب هو البناء الهيكلي لفهم العالم والحياة ، وهو مخزون القيم الإنسانية المهمة التي تظهر بأشكال مختلفة خلال المراحل التاريخية .
إن اعتبار رجال الأدب العظام ضمن كبار المصلحين الأنبياء الإلهيين مبالغة لا تخلو من لطف . إنها توصيف لمرحلة أخرى من الخلقة – يبدو وكأنها – يجب أن تنفّذ بيد البشر . ولهذا السبب فإن الأدبيات تعتبر مظهرا للنخب العلمية ، وجسرا بين عالم الواقع والقيم العامة الإنسانية المطلقة ، وبين الشخص الذي يجسّد العالم الإنساني . إن الأخلاقية العالمية قد ولدت وانتشرت مع الأدب بوجوهه المتنوعة ، وانتقلت بين الأجيال .
إن التفاهم حول العالم ، ومع العالم ، هو حصيلة الأدب ، وبتعبير أدق هو رسالة الأدب . إن اعتبار أدب كل قوم هو مرآة أولئك القوم ، والكتاب الذي يدون وقائعهم المهمة في حياتهم التاريخية ينبع من هذه الحقيقة ، ويشكِّل جانبا من بناء الأدب الشامخ ، ويمثل الوجه المفهوم لظاهرة تسمى البشر “(34)
وفي افتتاح دورة معجم البابطين ( الكويت 2008م ) يقول : دولة الأستاذ فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان ( السابق ) عن النشاط الثقافي والحوار الحضاري الذي تقوده المؤسسة : ” إن مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري الزاهرة حققت الكثير عندما هدفت منذ قيامها لصون الموروث التاريخي والحضاري وتطويره ، بما يدفع إلى الإسهام والاستلهام ، لكن الأزمنة الحديثة التي شهدت انقلابات هائلة في حياة الأمم حاولت تنحية الشعر والخطابة عن مركز الصدارة بوضع الاقتصاد والسياسة في واجهة الاهتمام ، ثم أظهرت الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة وتداعياتها على صعيد النمّو والاستقرار أن البشرية بحاجة للرؤية الشمولية التي تمزج الثقافة بالاقتصاد والسياسة للنجاة من هذه التداعيات ، وأن المؤسسة أصبحت أكثر شمولية في النظرة عندما أفردت موضوعا ثانيا لأنشطتها الدورية إلى جانب الشعر ، يتعلق بالحوار بين الثقافات والحضارات والأديان ” (35).
أما عن صدور ” معجم البابطين لشعراء القرنين التاسع عشر والعشرين ” – بصفة محددة ، فيقول عنه الأمير الحسن بن طلال ، رئيس منتدى الفكر العربي ، في عمان: ” هذا العمل المعجمي الموسوعي يشكّل علامة فارقة في كمه ونوعه . ومثل هذه الأعمال التي تشكل الطفرات هي دنيانا الثقافية والفكرية التي نحن أحوج ما نكون إليها ، طفرة كهذه تجبّ آلاف ، بل ملايين الأعمال المتشرذمة المتناثرة ، فلا يوثق هذا العمل الشعر فحسب ، وإنما ينعش النفوس أيضا ، ويبث فينا روح العزم وروح البهجة التي كدنا أن نفقدها في زمن الانكسار “(37)
ويقول عبد العزيز سعود البابطين ، في افتتاح دورة ابن زيدون ( قرطبة 2008م ):
” ونحن في مؤسسة جائزة عبد لعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري – وهي من مؤسسات المجتمع المدني – كان مطمحنا – منذ أولى خطواتنا قبل عقد ونصف من الزمن – أن نتحرر من التحيزات السياسية والمذهبية التي تمزق النسيج الاجتماعي، وأن نجعل من المؤسسة ساحة يتجاذب فيها المثقفون العرب – على اختلاف اتجاهاتهم – أطراف الحوار للنهوض بالشعر العربي ، وبالثقافة العربية ، وقد استطعنا أن نتجاوز الجدران العازلة لنقيم لحمة ثقافية تؤسس للحمة سياسية مستقبلا ” (37).
وهذه إضافة أخرى – أخيرة – لا نقول عن أهمية الثقافة والمعرفة كما بثتها ” مؤسسة البابطين ” لأقصى مدى توصلت إليه ، بل عن أن مستقبل الأمة العربية واستحقاقها أن تكون حاضرة بقوة في واقع هذا العصر مرهون بنشر هذه الثقافة ، بالتنوع والحيوية والإيمان الذي نعهده فيها منذ كانت .
* * *
الهوامش والمصادر والمراجع
- نتبارك بذكر هذه الآية الكريمة في صدر هذه الورقة ، وهي الآية رقم 61 من سورة ” الصافات ” .
- هذا البيت متداول في مثل ما نواجهه ، وهو لشاعر مجهول اسمه خِراش ( بكسر الخاء ) خرج للصيد ، فواجه سربا من الظباء ، ولكثرة وجمال ما تجمع حوله تردد في أيها يصيد ، فضرب مثلا لمن تكاثرت من حوله الأهداف ، فأخذ يتنقل بينها .
- نشر كتاب ” الكويت والتنمية الثقافية العربية ” في سلسلة ” عالم المعرفة ” التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – رقم 153 – سبتمبر 1991 – ينظر – بصفة خاصة – القسم الثالث ( ص185 – 275 ) بعنوان : ” تناغم الأداء ” .
- نصّ الكلمة في كتاب : ” سنوات من العطاء ” – ص56 .
- صدر للشاعر عبد العزيز سعود البابطين ديوانان : ” بوح البوادي ” عام 1995 ، و ” مسافر في القفار ” عام 2004 – ولا نشك في وجود قصائد أخرى من الشعر النبطي ( الشعبي باللهجة الخليجية ) لم يجمعها ديوان بعد ، وإن أنشد بعضا منها في بعض المناسبات والمواقف وكثيرا ما ينشد في احتفاليات المؤسسة من شعره الجديد .
- عبد العزيز سعود البابطين : من مقدمته لكتاب : ” سنوات من العطاء ” ص3 ومن الواضح في هذا الاقتباس أن الهدف القومي هو المسيطر على التوجه ، وفيه تتماهى الكويت في انتمائها العربي وسعيها إلى إحياء الصفحات الزاخرة مما يمكن أن يعد من التاريخ المشترك، إذ يعرف هؤلاء الشعراء جميعا بأنهم المعبرون عن الوجدان العربي ، وثقافة اللسان العربي .
- ” تاريخ الكويت ” كتاب ألفه الشيخ عبد العزيز الرشيد عام1926، والشيخ من تلاميذ ومريدي الشيخ محمد رشيد رضا ، الذي زار الكويت ووجد في أبنائها ترحيبا بنزعته المجددة ، كما وجد معارضة شديدة من فريق آخر .
- خليفة الوقيان ( الدكتور ) : إبحار مع القلم : مختارات من كتابات صحافية – ط أولى – الكويت 2013 ص21 .
- المرجع السابق – ص458 .
- في مجال الاستراتيجية الثقافية – تحديدا – هناك مشروع مكتمل ، كانت ترعاه جامعة الدول العربية ، وأخذت الكويت – بقيادة الأستاذ عبد العزيز حسين ن وزير الدولة المثقف – مسؤولية تنفيذه ، وقد اكتمل في ست مجلدات نشرت تحت عنوان : ” الخطة الشاملة للثقافة العربية ، منذ عام1984، ثم أرسلت إلى النسيان ، فلم يطبقها أو يطبق بعضا منها أي قطر عربيّ ، مع أن نخبة رشيدة مع مثقفي هذه الأقطار هي التي وضعتها .
- أحمد أمين : زعماء الإصلاح في العصر الحديث . وقد مضى ولده الدكتور جلال أمين على خطة أبية يكتب عن العظماء ، ويكشف عن مناحي تميزهم الفكري ، وفي هذا الاتجاه ألف من بين كتبه الكثيرة : ” شخصيات لها تاريخ ” و ” كتب لها تاريخ ” و ” شخصيات مصرية فذة ” وغيرها .
- مالك بن نبي : مشكلة الثقافة – ترجمة عبد الصبور شاهين – دارا لفكر – دمشق ط12 ص29-31 .
- مالك بن بني : المصدر السابق – ص109 .
- مالك بن نبي : المصدر السابق : ص117 .
- مالك بن نبي : المصدر السابق – ص47 .
- زكي نجيب محمود : قصة نفس – ط ثانية – دار الشروق – القاهرة 1983 – ص16 .
- زكي نجيب محمود : قصة عقل – ط أولى – دار الشروق – القاهرة 1983 – ص113 .
- زكي نجيب محمود : قيم من التراث – ط أولى – دار الشروق – القاهرة 1984 – ص7 .
- زكي نجيب محمود : المصدر السابق – ص6 .
- الإشارة هنا تستهدي ما جاء بالآية الكريمة : ) مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ، في كل سنبلة مائة حبة .. ( الآية 261 من ” سورة البقرة ” ، والآية الكريمة : ) مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة … ( الآية 35 من ” سورة النور ” .
- سنوات من العطاء – ص39 .
- فاز بهذه الجائزة الشاعر السوري حسان عطوان ، عن ديوانه : ” معمودية الدم ” يراجع : ” سنوات من العطاء ” – ص18 .
- ينظر نص كلمة رئيس المؤسسة في ختام جلسات الحوار مع البرلمان الأوروبي في بروكسل (2013) في كتاب : أعوام من العطاء الثقافي – الطبعة الثانية ص69 .
- تنظر مقتطفات من كلمة نائب رئيس البرلمان الأوروبي في المصدر السابق نفسه وبخاصة ص69 .
- في دورة معجم البابطين ( الكويت 2008 ) قدم كاتب هذه الورقة دراسة مقارنة عن معجم القرنين ومعاجم التراث . وأتشرف بأنني كتبت ترجمات ألاف من شعرائه ، وقدمت توصيف أشعارهم بإجمال ودقة ما أمكنت العبارة ، في حين نهض الدكتور محمد فتوح أحمد باختيار ما ينشر من قصائد المترجم له ، ومراجعتها . والدراستان في كتاب ” دورة معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين – الذي أصدرته المؤسسة – الكويت 2010 .
- الآية 118 والآية 119 من سورة هود .
- مالك بن نبي : مشكلة الثقافة ( مصدر سابق ) – ص121 .
- كاتب المقال: صلاح سالم ، عرفته المطبوعة بأنه كاتب ومفكر بجريدة الأهرام – القاهرة. والدراسة بمجلة ” شؤون عربية ” – مجلة قومية فصلية ، تصدر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – العدد 158 ( صيف 2014 ) – ص148 – 159 .
- المقال السابق – ص148 .
- المقال السابق – ص149 .
- المقال السابق – ص152 – والكاتب – فيما نرجح – يعبر عن مقولة سائدة ، خلاصتها أن العمل الديني ( المقدس ) ينبغي ألا يلتحم ولا يتداخل مع العمل الدنيوي ( المدنس ) وإلاّ أصابه رشاش من دنس الدنيوي ، الذي يعبر عنه بالسياسي .
- السابق – ص152 – 153 .
- يصف كربن برينتون ، في كتابه : ” تشكيل العقل الحديث ” – يصف جمهورية أفلاطون ، ويوتوبيا توماس مور بأنهما من صنع فيلسوفين ميتافيزيقيين ، مثاليين ، ثم يقول : ” وهما رجلان من ذوي العقلية المرهفة ، راودهما أمل في أن تسمو الروح على الجسد … ولكن كلا منهما له نزوع استبدادي ، يؤمن بالإذعان الكامل للسلطة ، ولا يدرك – كما هو واضح – تغيّر العلاقات البشرية كعملية مطردة ، ناهيك عن التطور . ويبدو أن أكثر من تصدوا لابتداع مدينة فاضلة ( يوتوبيا ) كانوا من ذوي مزاج سلطوي ، على الرغم من أنهم ، بما في ذلك كارل ماركس ، سطروا على الورق فكرة تلاشي وزوال الدولة كمثل أعلى نهائي ، أو هدف آخر فوضوي بعيد ” .
ينظر : تشكيل العقل الحديث ، لمؤلفه كرين برينتون – ترجمة شوقي جلال – الهيئة المصرية العامة للكتاب – مهرجان القراءة للجميع 2001 – ص43 .
- سنوات من العطاء – ص46 ، 47 .
- سنوات من العطاء – ص55 .
- سنوات من العطاء – ص57 .
- ينظر نص كلمته في حفل الافتتاح – سنوات من العطاء – ص39 .