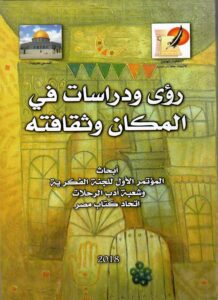التعريف بالتقدم الشريف .. رحلات هيكل باشا خلال أوروبا
التعريف بالتقدم الشريف
رحلات هيكل باشا خلال أوروبا
محمد حسن عبدالله
(1) محاولة تقديم ..
في مأثور مبادئ النقد الأدبي عبارة ترى أنه باتساع ثقافة الناقد وعمقها وتنوعها، تكون قدرته على تحليل الأعمال الأدبية التي يعرض لها ، أكثر مما تكون شاخصة في تلك الأعمال ذاتها !!
ألحت هذه العبارة على الذاكرة طوال قراءتي لكتاب “ولدي” الذي صنعه الدكتور محمد حسين هيكل (باشا) بدافع أُسري خالص ، وخاص ، غير أنه قدم من خلاله مشاهد، وصوراً ، وأفكاراً تدل على غزارة معارفه ، كما تدل على تطلعه أن يقدم إلى متلقي كتابه – مهما كان توجه اهتمامه – إضاءات متنوعة ، تتسم بالعمق ، والدقة ، والجدة ، بقدر ما تدل على وعي الكاتب بمرامي ما يكتب ، وأثره المتوقع في قارئه ، وفي هذا دليل على حدة وعيه بالحياة عامة ، وحياة مواطنيه في مصر خاصة ، كما يدل على صفاء روحه ، ونقاء ضميره ، وسنجد عليهما دلائل في كل فقرة من فقرات هذا الكتاب ، الذي نحاول أن نلتقط من مادته الغزيرة ما يمكن أن تعنيه (رحلة) مثقف مصري إلى مدن ومناطق ذات تاريخ ، وذات جمال ، وذات حضور في عصرها ، يستحق أن نتعرف عليه ، وأن نتطلع إلى نموذجه !!
تتشكل مادة كتاب “ولدي” من أوصاف ، وتعقيبات ، وتداعيات ، وتوثيق لمشاهدات الدكتور هيكل في ثلاث رحلات (صيفية) إلى القارة الأوروبية ، اصطحب فيها زوجه ليسري عنها ، إذ ألمت بها حالة نفسية قاسية ، عقب فقدهما لولدهما الوحيد ، الذي نعاه المؤلف في صدر كتابه ، مسجلا اسمه ، وتاريخ ولادته ، وتاريخ رحيله ولما يبلغ السادسة من العمر ، وما أحاط بهذا الفقد من الآلام ، حدس “هيكل” هداه إلى أن علاج زوجته الوحيد في ” التغيير” ، والانشغال بأجواء مختلفة أو مناقضة ، فكان هذا الكتاب يحمل عنوانه الغريب (أو الطريف) إذ لا يدل على محتواه ، وقد شرح المؤلف ذلك ، واقترح في مقدمته أن لو كان عنوانه “خلال أوروبا” ، غير أنه لم يفعل . وقد وُصف الكتاب – ترتيبا على محتواه – بأنه كتاب “سياحة” ، وهذا مصطلح جديد في وصف أدب الرحلات . ولعل دلالة (السياحة) تختلف عن دلالة (الرحلة) فربما كانت السياحة تحمل معنى العبور أو المرور السريع ، بخلاف الرحلة التي قد توحي بامتداد الزمن ، وإن اجتمعا في أن “العودة” إلى الوطن هي المآل في الحالين ، بعكس (الهجرة) التي تعني الانتقال والإقامة في موطن جديد .
إن حياة الدكتور هيكل الثقافية ، وممارساته العملية ، هي وحدها – فيما نرجح – التي تساعدنا على الإمساك بزمام سيل المرئيات ، سواء كانت تلك المرئيات مدينة في تكوينها الشامل ، وحجمها ، أو ضاحية من ضواحيها ، أو قصراً من قصورها ، أو تمثالا صغيراً في احد هذه القصور . فقد عُني “هيكل” بكل ما وقعت عليه عينه ، وبكل ما تحرك في وجدانه ، أو استدعته ذكرياته ، وجادت به المعلومات ، والأفكار ، والتأملات المنتشرة في مساحة مداها (260 صفحة) ، يمكن أن توصف بأنها (كبيسة) – على الرغم مما يبدو في بعض صفحاتها من تكرار الأوصاف لتكرار المشاهد ، وتقارب صورها ، وبخاصة فيما يتعلق بطبيعة أوروبا ، وما تزخر به من بحيرات وجبال ، وقمم ثلجية ، فضلا عن العمران القديم ، والتعمير المتجدد .. إلخ .
محمد حسين هيكل ، من قرية (ميت غنام) مركز السنبلاوين – دقهلية ، ولد سنة 1888 ، وقام برحلاته الثلاث إلى أوروبا ما بين يوليو 1926 ، ويوليو 1928 ، وكانت الرحلة – في كل مرة – إبان العطلة الصيفية ، في حدود ثلاثة أشهر تقريبا ، غير أن الكاتب ، الذي كان أثناء تلك الرحلات الثلاث رئيساً لتحرير مجلة (السياسة الأسبوعية)- التي تصدر عن حزب “الأحرار الدستوريين” – قد أطال التفكير في خطة التحرك من البدء إلى الختام ، كما أضمر طريقته في الكتابة عن الرحلة ، ومن ثم – على الرغم مما أشرنا إليه من تكرار الأوصاف – فإنه كان يضع قارئه أمام مشاهد جديدة في كل رحلة . وقد عبر عن ذلك – في مفتتح رحلته الثالثة – بقوله : ” أتدري لماذا جعلت “جنوا” فاتحة طريقي إلى أوروبا هذا العام ؟ قد أذكر لك سبباً له قيمته على بساطته ، ولكنه في الحقيقة ليس كل السبب !! ذلك أني رأيت أن أغير – ما استطعت – الثغور التي أصل عن طريقها أو أغادر منها أوروبا ، لكي أرى من هذه الثغور وأقف من الطرق التي تتصل بها على ما يزيدني بأوروبا معرفة ، ويصور بلادها علماً “(ص208) وإن كان لا يستبعد سببا إضافياً ذكره في هذه الرحلة الثالثة بذاتها : وهناك (إجراء آخر) ألزم نفسه به ، فساعده على أن يظهر كتابه في هذا النسق الفني/الأدبي/المعرفي الشائق ، إذ لم يكن يحرر مادته في مواقع المشاهدة ، وإن كان يسجل بالصورة ، وبالكلمة الموجزة أسماء الأماكن ، والمشاهد ، وعناوين الفنادق ، وأوصاف المشاهدات ، ثم – بعد العودة بزمن قد يطول – يتفرغ لصياغتها صياغة فنية أدبية راقية ، على النحو الذي نتلقاها به ، وقد تتسع المسافة بين الرحلة والكتابة عنها – في صورتها التي نتلقاها – حتى تبلغ ثلاث سنوات!! (ص258) . وربما تقاصرت عن هذا المدى الطويل ، كما تدل تعبيرات أخرى .
وقد ننهي هذه المقدمات بإشارة عابرة إلى أهم ما ييسر لنا المعرفة بالكاتب وبمحتوى الكتاب ، فقد تخرج هيكل في مدرسة الحقوق الخديوية (1909) وحصل على الدكتوراه في القانون من جامعة السربون (1912) – اشتغل بالمحاماة ، ثم بالصحافة (رئيسا لتحرير السياسة الأسبوعية) ، كان عضوا في لجنة وضع دستور 1923 ، ونائبا لرئيس حزب الأحرار الدستوريين فيما بعد ، ثم رئيسا لهذا الحزب ، ووزيراً للمعارف ، وللشئون الاجتماعية ، ورئيساً لمجلس الشيوخ . و”هيكل” مؤلف – ما يُعد في عرف كثير من النقاد– الرواية الفنية الأولى : ” زينب” التي أضاف إلى عنوانها : ” مناظر وأخلاق ريفية ” .
في ختام هذا التعريف المختصر نضيف أمرين : أنه ختم حياته – بعد اعتزال السياسة بقيام ثورة 1952 ، وإلغاء الأحزاب والألقاب في مصر – بكتابة رواية : ” هكذا خلقت” وهي رواية تقدم نموذجاً من النساء فريداً ، يذكرنا بـ (مدام بوفاري) لمؤلفها جوستاف فلوبير [ وقد عرضت لها في كتابي “الواقعية في الرواية العربية” ] – الأمر الثاني : أن ما كتب بمنهجه الفريد في وصف الرحلة ، يتجاوز هذا الكتاب الذي نعرض له، فمن قبله ألف كتاب : “عشرة أيام في السودان” بمناسبة حضوره افتتاح (خزان سنار) عام 1926 ، ثم تأليفه كتاب : ” في منزل الوحي” ، وقد وصف فيه رحلته لأداء فريضة الحج عام 1936 . على أن الكتاب الذي نعرض له يبقى الأكثر تعبيراً عن مكنون ثقافة المؤلف ، وتنوع معارفه ، وحضور تداعياته ، وقوتها ، وعمقها .
وقبل أن نصاحب هيكل في رحلاته الثلاث المثيرة إلى أوروبا في مسالكها المختلفة، نذكر أمرين انعكسا على محتوى كتابه : الأول : أن رحلته إلى بعض أقطار أوروبا لم تكن الأولى ، فقد عرفنا أنه أقام في باريس ثلاثة أعوام ، وأنه كان – إبان عطلاته الدراسية – يتجول حول فرنسا( وقد ذكر ذلك فيما كتب عن “زينب” ) ، بما يعني أنه لم يكن تحت وطأة المشاهدة الأولى ، مما أتاح له الكثير من التدقيق والتأمل ، مستفيداً من المسافة الزمنية – التي أشرنا إليها – بين الرحلة والكتابة عنها في توثيق المعلومات ، واستدعاء المتشابهات ، وإجراء بعض المقارنات ، كما سنرى .
الثاني : أنه في وصف مشاهداته ، ورصد تداعيات أفكاره ورؤاه ، لم يكن يشغل نفسه كثيراً بالمقارنة بين حال أوروبا في تقدمها وتطلعها إلى المزيد من الرخاء والقوة والرفاهية ، وما يعاينه من مشاهداته وتجاربه في مصر ، التي تراوح في مكانها أو تحاول أن تحسن من أوضاعها ، في نطاق قدرات محدودة (فقد ذكر “هيكل” أن مدينة برلين ، وهي مدينة حديثة لم يكن مر على تأسيسها مئة وخمسون عاماً ، تنفق بلديتها على إدارتها وعمرانها ضعف ما تنفق الميزانية المصرية على مصر في جملتها !!) . وتعنينا هذه الملاحظة المتعلقة بانصراف اهتمام “هيكل” عن إجراء المقارنات بين ما يرى وما ترك خلفه في مصر ، لما لها من أثر فني إيجابي ، لقد حدثت هذه المقارنات نادراً ، في سياقات محددة سنقف عندها ، ونرى أنه كان موفقاً في إخلاصه التركيز على مشاهداته هناك ، دون أن يفسد المشهد بأن يذكر شبيهه أو نقيضه ، مما يشتت الصورة. فقد كان حريصاً على أن يقدم (درسه الحضاري) إلينا في رونقه ، وبهائه ، وهالات إغرائه ، أو إغرائنا به ، دون أن يعكر (التلقي) بمشاعر الأسى والتحسر ، ومن ثم ظلت (الحالة الجمالية) سائدة على مشاعر المتلقي ، وتخيلاته..وحتى أمنياته لبلاده !!
(2) مرتكزات الرؤية ..
ستكون موازنة على قدر من الطرافة ، وإثارة الدهشة ، أن ” نوازن” بين رحلة الشاعر العربي القديم ، ورحلات الرحالة العرب والمسلمين فيما بعد ، وبين رحلة هيكل باشا. الشاعر القديم منذ عصر الجاهلية كان يرحل إلى الممدوح حقيقة ، ثم أصبح وصف الرحلة تقليداً ، فكان ” يرحل في شعره ” ، ومن ثم أصبح وصف الصحراء ، والليل ، ومناجاة الراحلة (الناقة) .. إلخ ، طقسا من طقوس القصيدة العربية ، وفي عصر الدولة الإسلامية كانت الرحلة للاكتشاف ، وقد لا تكون مقصودة لذاتها (للهدف المعرفي) وإنما تحدث لغرض التجارة أو السفارة أو الدعوة الدينية ، وسيرتبط مدى هذا الاكتشاف المحدود بحركة الرحالة ، وقدرته على التواصل مع المجتمع ، والرغبة في جمع المعلومات ، وفي هذا كله تتضاءل المحصلة عن صنيع هيكل في رحلاته الثلاث . فكما ذكرنا – في العبارة الافتتاحية – أن هذه القدرة على الوصف ، والتحليل ، ورصد الفروق .. إلخ ، ترتبط بالطاقة الثقافية التي يختزنها المؤلف، وهكذا سنجد أنفسنا – تحت ضرورة تصنيف محتوى كتاب “ولدي” نتوقف عند ما يراه هيكل (رجل القانون) ، وهو غير ما يراه هيكل (السياسي) ، ويختلف عما يراه هيكل (المفكر الاستراتيجي) ، وما يراه هيكل (المثقف العام) أو هيكل (الناقد) ، أو ما يستدعيه (الطالب في السربون) مستفيداً من معلوماته ومشاهداته في زمن مضى ، أو (الفلاح القديم) في كفر غنام ، أو (مؤلف “زينب”) .. بل سنجد في بعض أوصافه وبعض اقتباساته ما يدل على شخصية شاعر ، وقدراته في تكثيف اللغة ، وبناء الصور ، وتشكيل المشاهد .. إلخ .
لقد زار “هيكل” عدداً غير قليل من أهم مدن القارة الأوروبية ، ومناطقها المشهود لها بنوع من التميز الجمالي ، وكان يمكن أن تكون هذه المدن ، وتلك المناطق مرتكزات للرؤية ، إذ أنه عُني بوصفها (طبيعة وعمراناً) ، والتعريف بأهم منشآتها ، وصناعاتها ، وعظماء رجالها … إلخ ، غير أننا نفضل أن يكون مدخلنا إلى محتوى كتابه يتسق وإمكاناته الثقافية ، والفكرية ، والنفسية، ويحقق الهدف الذي توخاه في وصفه لتلك المشاهد ، وإن لم يسفر عنه بعبارة قاطعة أو مكشوفة ، وهو التعريف بالمنجز الحضاري الغربي ، وأسباب تقدم أقطاره على ما بينها من تفاوت أو خصوصية ، فلسنا نشك في أن رعاية ” هيكل ” لصحة زوجته في أزمة الفقد التي هزت كيانها ، كانت هدفا رئيسا ومعلنا، غير أن هذا الهدف لم يكن يتطلب منه أن (يعاني) تأليف هذا الكتاب ، وإذاً فإن “المحكي له” في كتاب (ولدي) ليس الزوجة المكلومة بفقد ولدها الوحيد ، وربما كذلك ليس قراء ” السياسة الأسبوعية ” وحسب ، وإنما يتسع ” المحكي له ” ليشمل أهل مصر : حكامها ، ساستها ، علية القوم فيها ، سائر مواطنيها ، في زمن التأليف وما بعده من الأزمنة ، إلى يومنا هذا وما بعده .. فكلنا معنيون بمصير هذا الوطن ، وتائقون لأن يتحقق له التقدم الذي يليق به . ولكن (الوسائل) – من عصر “هيكل” وربما إلى اليوم – تعجز عن اكتشاف الطريق إلى (الغايات) . ومن ثم عُني هيكل – عبر مشاهداته – بتسجيل كل ما أمكنه استيعابه من مظاهر وأسباب نهضة القرن العشرين في هذه الدول الأوروبية التي سلك إليها ثلاث مسارات متخذاً السفن والقطارات وسيلة للتنقل ، فلم يركب الطائرة إلا لمسافة محدودة في رحلته الأخيرة . أما البحار والسكة الحديدية فقد أتاحت له أن يشاهد على مهل ، وأن يصف بروية ، وأن يفصّل لأنه يقدم خبرته إلى ذلك (المحكي له) الذي عرفناه (وهو نحن) . وهكذا تعددت وتدرجت المرتكزات حسب التكوين الفكري ، والوجداني ، والنفسي ، لهذا الحاكي الفريد .
أولا – رجل القانون :
نعرف أن “هيكل” تخرج في مدرسة الحقوق بالقاهرة ، وحصل على الدكتوراه في القانون من السربون ، واشتغل بالمحاماة ، فهذا المرتكز عميق الغور في نفسه ، وهو يتجاوز ضفاف ذكرياته أيام التلمذة في السربون . إن تنبه “هيكل” إلى القانون والحقوق ، ودورهما في السلام المجتمعي وتحقيق التقدم ، يلون مادة كتابه في جملتها ، ومع هذا فله التفاتات خاصة نشير إلى أهمها :
- فقد كان أول ما أثار اهتمامه واسترعى نظره في مارسيليا ، ذلك القصر الفخم الذي كُتب على بابه (قصر العدالة) ، فهو محكمة مارسيليا الكبرى ” هو مأوى القانون ورجاله ، والعدالة وطالبيها ، ومعبد كهنة الحرية والنظام في هذا العصر الديمقراطي ، الذي سما بحرية الفرد إلى مكان القداسة العليا ، فلا رقيب عليها ، ولا حسيب إلا أن يحاول الفرد الاعتداء على حرية غيره ، فإذا فعل ألقت عليه سلطة القانون يدها ، وجاءت به أمام هؤلاء الكهنة ، وهم أفراد من أمثاله ، لا امتياز لهم فيما وراء جدران هذا المعبد عليه ، فطبقوا عليه القانون الذي ارتضى ، لا القانون الذي يُفرض عليه ولو على كره منه “. هذا المعنى جدير بأن يقام له هذا القصر ، بل هذا المعبد الرهيب الجليل . فالعدل القائم على أساس الحرية الصحيحة هو أسمى المعاني الجديرة بالتقديس والإكبار . والناس ما استمتعوا بحريتهم ، وما قام العدل بينهم ليكفلها ، ويحميها ، جديرون بأن ينالوا كل ما يمكن أن يكون في الحياة من سعادة ، وأن ينهضوا بالحياة وبالإنسانية إلى مرتبة الكمال التي ترجو الإنسانية بلوغها – (ص26 ، 27) . فكما ترى : نبه هيكل إلى وجود القصر الفخيم، وقرأ اللافتة ليعرفنا به ، ثم انصرف عن “المبنى” (وهو الشاخص المشاهد ، والأثر المهم) إلى “المعنى” فأفاض فيه كاشفاً عن قيمة العدالة ، ومكانة القاضي ، وحدود تفرده وسلطته ، وأهمية إقرار العدل في رعاية التقدم . فنحن إذا أمام سائح أو رحالة من نوع خاص ، لا يكتفي بالشواخص ، وإن احتفى بها احتفاءً واضحاً ، بقدر ما يُعنى بما تمثله من منظومة القيم البناءة للمجتمع ، وللتقدم . وكذلك يتوقف أمام قصر العدالة في لوزان (ص76) . أما ذكرياته حين ساقته جولاته إلى الحي اللاتيني (باريس) ، ووقف بباب كلية الحقوق ، حيث درس القانون ، فتذكر أساتذته العظام ، مثل: العلامة جاوسون (ص43) ..فإنها تكشف عن مدى عناية فرنسا بالعلوم الإنسانية ، والثقافة ، ومن هذه العناية فخامة المنشآت ، وإحاطتها بالحدائق المترامية .. إلخ .
ثانيا – رجل السياسة :
ونعرف أن “هيكل” كان قريباً ، وأثيراً عند فيلسوف الجيل (أحمد لطفي السيد) ، إذ كان لطفي رئيسا للجامعة المصرية ، وهيكل أحد مبعوثيها ، وقد تأثر به تأثراً قوياً في متجهه السياسي/الثقافي (كما كانت قرية لطفي “برقين” قريبة جداً من “كفر غنام” قرية هيكل ، حتى لقد ظننت أن بينهما درجة قرابة) على أن قرابة العلم وتعارف الأرواح أقوى أثراً من تقارب الجدران !! وإذاً فإن حزب الأحرار الدستوريين هو السياق المناسب لعقلٍ حر ، مثل : لطفي وهيكل (وطه حسين من بعدهما) . ومع أن العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين كانت زاخرة بالتقلبات السياسية ، والمذاهب المتعارضة (في أوروبا) – قبيل الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918) وفي أعقابها ، فإن “هيكل” لم يُستدرج إلى خوض أسواقها ، أو مصطلحاتها ، وصراعاتها ، من ثم ظل استدعاؤه للسياسة مرتبطاً بمشاهداته لأنواع من التغير والتطور التي شهدتها مدن أوروبا التي زارها ، أو شهدتها حدود بعض تلك الأقطار التي اتسعت أو انفصلت ترتيبا على نتائج تلك الحرب العالمية الأولى ، وإن اشار “هيكل” إلى هذه التغيرات وما ترتب عليها ، وبخاصة في أقطار شرق أوروبا (النمسا والمجر وتشكوسلوفاكيا) لقد كان اهتمامه بالعمران أقوى ، وقد يرى أن “قراءة” أحد القصور ، أو القلاع ، دلالات سياسية وحضارية ، هي في معياره أكثر أهمية من البكاء على اللبن المسكوب (تغييرات الحدود) . فقد وقف أمام قصر (فرساي) في فرنسا ، وقصر(وندسور) بانجلترا ، وقصر (يلدز) في الآستانة ، وقصر (الملك) في رومانيا ،.. وغيرها من القصور في مدينة البندقية ، والمنشآت الفخمة المناظرة ، فكانت قراءته السياسية لها تُفرق بين قصر مأذون للشعب بمشاهدته ، وربما بدخول أبهائه ، وقصر يُحال بين الشعب وبينه ، وقصر تخلى عنه حاكمه فجأة لأنه طُرد بقوة الثورة ، فعجز الوارثون عن إدارة القصر ، وقصر تخلى عنه سيده بعد أن رتب أموره في إدارته ، فاستبقى جماله … هذه القصور جميعاً شاهدها “هيكل” وقرأها قراءة سياسة واعية ، تكشف عن كيف أن الشعب الذي بنى القصر بعرقه وبماله ، يتعامل مع هذا البناء في مختلف ظروفه ، وسياقاته السياسية . أما ما يهم السائح المشاهد من وصف الفخامة في المداخل والقاعات والأقبية والساحات والأبهاء ، وأنواع الزينة والحدائق ، والتماثيل .. إلخ ، فقد وفاه حقه تماماً في كل منشأة دخلها ، يستوي في هذا: القصر ، والمسجد ، والكنيسة ، والكلية ، والحديقة ، والجبل وقمة الجبل ، وكأنما كان يسجل هذه التفاصيل شديدة الحساسية والطرافة ، بكاميرا من نوع خاص ، لعلها ذاكرة هذا المثقف الكبير !!
ثالثا – المفكر الاستراتيجي :
تلتقي ثقافة رجل القانون ، وممارسة السياسي عند المفكر الاستراتيجي ، وهذا الجانب العميق لم يكن يُرتَجل أو يُقحم في السياق ، وإنما كان – مثل سابقيه – انبعاثا لمشاهدات وخبرات مثارة بالمشاهدة الوقتية ، وفي هذا المرتكز (تومض) صورة “مصر” ليعبر من خلال رؤاه الاستراتيجية عن جانب من أمنياته لوطنه ، فحين تأخذ بمجامع قلبه ووجدانه المنشآت الرائعة في باريس ، فيتساءل : “ومتى أقيم قوس النصر؟ ومتى شُق الشانزلزيه ؟ ومتى أقيم القصران الكبير والصغير ؟ ومتى مُهد ميدان الكونكورد ؟ ومتى نُسقت حدائق التويلري ؟ وكم من الأجيال أقامت قصر اللوفر ؟ نعم ! كم اقتضت هذه المجموعة نرتع خلالها ونستمتع بجمالها ، من زمان وجهد وعبقرية ؟ (ص40)” . وتمضي فقرة قصيرة – في ذات الصفحة – ليقول هيكل : “حقاً ! إن الوطن ليس هو هذه الأرض التي نحفظ منذ صغرنا حدودها ، ونعتبر شركاءنا عليها إخواناً وأعواناً ، بل إن للآباء ، والأجداد ، وللمقابر ، وللرفات حظاً من الوطن أعظم من حظ أرضه ، وهذا الحظ هو الذي يجعل بقعة من الأرض وطناً ، ويجعل الوطنية روحاً ، ويجعل لنا بهذا الروح إيمانا نفتديه بمهجنا ، وأنفسنا …” .
لا نملك أن نتعقب رؤى “هيكل” الاستراتيجية فيما يتعلق برؤية العالم (ص45) ومدرسة العلوم الحرة (ص45) ، وقرية المسنين (ص63) وغيرها .. وغيرها ، ولعله فيما يتعلق بقرية المسنين خاصة (قرية ويتلي في الجنوب الإنجليزي) ، يعد أول من نبه – في مصر – لاستحقاق المسنين الرعاية الخاصة من الدولة ، ومن الأثرياء على السواء، ولعله في ملاحظته العابرة بأن عامل ” المصعد ” في أحد أبنية برلين كان بذراع واحدة ، عرف “هيكل” أنه فقد الأخرى في الحرب ، ومن ثم يكشف هيكل لنا – عبر هذه الملاحظة – عن حق مصابي الحرب في الرعاية ، والحصول على عمل مناسب !!
رابعا – هيكل المثقف :
دون أن نسرف على هذه الصفحات بتبيان مفهوم “الثقافة” من الوجهة التاريخية، ومدى تداخلها كمرادفة للحضارة ، أو تعبيرها عن الاستنارة ، فإننا نكتفي بأن نساير القول بأن المثقف هو الذي يجمع المعرفة النسبية بتخصصات مختلفة باستطاعته أن يوفق بينها في الاستخدام ، والاستنتاج ، وتنسيق الغايات .. إلخ . وقد كان “هيكل” مثقفاً واسع المعرفة بعلوم شتى متواشجة (غير متصادمة) في إدراكه ، وفي استخدامه لها .
وقد رأينا في (رجل القانون ، والسياسي ، والمفكر الاستراتيجي) ما يؤكد هذا ، بل نقول : إن كتابه (ولدي) ثمرة مباشرة لثقافة رصينة ، متوائمة ، ذات طابع تقدمي ، وإنساني ، لم تتخل عنه في أية لحظة . فحين يوازن بين أحياء مدينة باريس ، من حيث الفخامة ، والمحتوى ، فإنه ينحاز إلى (الحي اللاتيني) الذي يضم الجامعة والمعاهد العلمية ، ودور العرض المسرحي والأوبرا ، وما إليها . مع أن الحي المقابل تشمخ في سمائه قصور ملوك فرنسا من آل البوربون وغيرهم .
وقد عُني “هيكل” بمفردات الثقافة ، وتجلياتها ، فلم ينزل بمدينة ذات شهرة بالفن المسرحي إلا وكان ارتياد المسرح أول مقاصده ، وأهم شواغله في المساء ، ونستطيع أن نعرف من خلاله ماذا كان يُعرض في باريس ؟ وفي لندن ، وفي بودبست .. إلخ . كما عرض لعدد غير قليل من الروايات ، ترتيباً على مشاهداته لتماثيل مؤلفيها ، مثل : جان جاك روسو ، وفولتير ، وديماس ، وغيرهم (في فرنسا) ، وكذلك فعل في كل مدينة ذات عراقة ، ولها مؤلفات في هذا الاتجاه ، كما عُني بحضور حفلات الموسيقى – على أنواعها – وله رأي محدد في موسيقى ما بعد الحرب العالمية الأولى ، والموسيقى الشعبية ، وقد وضح شغفه بالسماع في حرصه على الإنصات للفرق الموسيقية ، حتى أثناء رحلته في السفن التي سافر بها ، فضلا عن رصده لموسيقى الطبيعة التي تتجاوب أصداؤها لكل ذي حس دقيق ، حين يصعد إلى القمم الثلجية الجبلية ، أو يركب القطار يجتاز به الأنفاق والأنهار ، وحتى (التليفريك) الذي وصفه دون أن يستخدم هذا المصطلح، اكتفاءً بذكر أنه صندوق معلق ، يسحب بالجنازير ليصعد أو لينزل .. إلخ . كما أن له عناية خاصة بوصف النقوش والرسوم والتركيبات الزجاجية (الفسيفساء) في المساجد والكنائس العالمية ، وفي قصور الملوك ، ومن يتشبهون بهم ، فأنت في صحبته كأنك ترى ، وكأنك تسمع ، وكأنك تقرأ ، في آن واحد !!
لا تغيب حاسة (الناقد) عند “هيكل” ، ولا تقف عند حد القراءة ، فقد (قرأ) مصير قصر (يلدز) في تركيا بعد زوال الخلافة ، في مقابل قصر (فرساي) في فرنسا بعد زوال الملكية ، وقصر (وندسور) في انجلترا في عصر الديمقراطية . وكذلك فعل مع قصور أخرى يصعب رصدها ، كما فرق بين الطرب الغربي ، والطرب الشرقي (ص128 ، 129) . وقد تلمح – في ثقافة هيكل عبر تعقيباته على مشاهداته للمنشآت الفخمة كالقصور والقلاع والحصون – نزعة إلى العدل بالمفهوم الاشتراكي الإصلاحي ، وبخاصة حين يعقب على قصر الملك في رومانيا ، الذي بنته الجماهير ، وهو محرم عليها (ص149) وحين يعرض لانحلال دولة الترك ، عبر مشاهداته لآثار الآستانة : قصورها ومساجدها وتكاياها وزواياها .. إلخ (ص132) ، وترحيبه بنهضتها الجديدة ، التي قادها أتاتورك (وقد ذكر في سياق ملاحظاته على ما جرى في تركيا من تغير في عصر أتاتورك، أن النساء تصلي في المسجد إلى جوار الرجال ، دون فاصل ” لأن أولئك وهؤلاء سواسية أمام الله ، فيجب أن يكونوا سواسية في بيت الله” (ص130)) يذكر هيكل هذا دون تعقيب !! وفي صياغة الكتاب جانب طريف لا علاقة له بالرحلة في ذاتها ، وإنما علاقته بألفاظ الحضارة ، وفاعلية تعريب المصطلحات الأجنبية. وفي هذا المستوى يستخدم : الأتوموبيل ، والأتوموبيلات ، وحاجب (بواب) الفندق ، ويعبر عن الملابس التنكرية بالملابس الخفية ! ، وعن (الفصال) الذي يمارسه الباعة فيقول : إن البائع يمارسك بدلا من يفاصلك أو يفاصل معك ، أما (الأسنسير – وهكذا يكتبها) فإنه يضع إلى جانبها كلمة: الصاعد .. إلخ .
خامسا – رائد التنوير :
وهذا المحور في شخصية “هيكل” لا ينفصل عن هدفه الثقافي ، وتفكيره الاستراتيجي ، غير أنه يتميز بأن رغبته في التنوير ترتبط بمشاهداته في أنحاء أوروبا ، وفي تداعياته الفكرية ، والنفسية . فـ”هيكل” (سائح من نوع خاص) قطع المسافات ليرى ويسمع ويستمتع مثل أي سائح ، غير أنه يتجاوز هذا المدى الشخصي في حرصه على أن يُعرّف إلى قارئه أهم عناصر التقدم ، ومظاهر التمدن في دول أوروبا ، يصنع هذا غير متمحل ، فاستعداده الثقافي واسع المدى ، وذكرياته غزيرة جداً ، والمشاهد أمامه تثير إعجابه (لنفسه) كما تثير أفكاره التي يحرص على تقديمها لقارئه تمكينا لدعوة التنوير ، التي قادها أستاذه ” لطفي السيد ” ، ومن قبله الإمام ” محمد عبده ” ، و ” قاسم أمين ” ، وفي موازاته ” طه حسين ” !!
لقد ذكر (جان جاك روسو) غير مرة (ص 28 ، 84 ، 87 ، 100) ، وتمهل عند (موليير) بمسرحياته ، وذكر (كلود برنار) ، وممن عاصر – حين كان طالبا بالسربون : (دور كايم) و (برجسون) ، و (لانسون) ، و (كروازيه) . كما يُعنى عناية خاصة بفن المسرح – كما ذكرنا ، ويحرص على مشاهدته في أية عاصمة شُهرت به، وبخاصة مسارح باريس (ص47 ، 50 ،51) ومن الطريف أن ينحاز إلى المسرح ، ويعلي من شأن (أوبرا باريس) ومسارحها ، غير أنه يرى أن فن الأوبرا أرقى من فن المسرح (ص47 ، 48 ، 51 ، 52) ، وحتى في فيينا شاهد مسرحية :” مدام بترفلاي” ، كما ذكر (هنري بورجيه) وروايته : ” مناظر من حياة الغجر” ، واستعاد ما كتبه (جول ليمتر) عن لامرتين ، وما كتبه (إدوار شوريه) عن موسى ، وفي فرانكفورت يُعنى بأعلامها فيزور بيت (جوته) ويصفه ويُعرّف بمنحاه الفكري ، ويذكر (بسمرك) موحد ألمانيا ، و(جوتنبرج) مخترع المطبعة . وإذ تمخر به السفينة – في رحلته الثانية – البسفور ، فإنه يذكر (بيير لوتي) و (كلود فارير) اللذين تغنيا بجمال البسفور ، وجباله ، وأقماره ، وتاريخه أكثر مما تغنى بها أي تركي . ويحاول أن يعلل لانصراف الترك عن الشعر . كما يمتدح العرب القدماء ، الذين حولوا صحراءهم ، وجبالهم ، وإبلهم إلى شعر .
سادسا – “هيكل” الفلاح :
وكما نعرف فإن “هيكل” ربيب قرية من قرى محافظة الدقهلية ، ولم ينقطع عنها ، وحين أخذ موقعاً في البرلمان فإنه كان (نائبا) عن دائرتها ، وحين شاقه الوطن إبان بعثته إلى فرنسا ، كتب رواية “زينب” ووصفها بأنها (مناظر وأخلاق ريفية) كما وضع قناعاً على اسم مؤلفها ، فهي (بقلم : مصري فلاح) . وسنجد هذه النزعة الريفية حاضرة في مشاهد متعددة ؛ إذ يتحمس ويطري حياة القرية حتى يقول ” ولنا في حياة المزارعين من أهل ريفنا ” .. إلخ (ص22) ممجداً حياتهم الحرة الطليقة ، بل يذكر “شيوخ قريتنا” يجتمعون في المساجد قبل الفجر لقراءة الورد ، حتى يحين أداء الفريضة ، فيصلون ثم ينصرفون (ص71) ، وعجائز القرية (ص72) ، كما يذكر رواية “زينب” صراحة (ص42،43) وفيما بعد (ص158) ، يقول : ” وقديما كان البدر لي صديقا” وهذه العبارة موجودة في سياق رواية “زينب” . وإذ يشاهد ميداناً واسعاً في مدينة ميلانو ، فإن حاسته الريفية تقدر سعته بخمسين فداناً (!!) (ص99) . على أنه حين يعلي من قيمة الموسيقى وعمقها رواجها في الغرب ، يتحسر على موسيقى “دلوكة أبي الودع” في قرى الريف المصري (ص201).
وقد ذكرنا آنفاً أن “هيكل” حرر مشاهداته ، والتعليق عليها من نزعة المقارنة ، أو الموازنة مع مشاهداته ، وممارساته في مصر ، ورأينا أن هذا المنزع كان في صالح إشباع الوصف وصدقه ، وخلوصه لأداء وظيفته الفنية ، غير أنه – في حالات محددة – كان يستدعي المقارنة ، وبخاصة فيما يتعلق بالأمور المتصلة بالسياحة ، والمؤثرة في رؤية الأجانب للمصريين .
فقد ذكر “مسلة الأقصر” وكيف نعاملها ، في مقابل عناية الغرب بآثاره ، وقارن بين ملاهي “بودابست” و” ملاهي مصر” ورأى أن لبودابست رونقاً ليس للقاهرة (ص166) ، ووصف حياة القرويين في أوروبا ، في مقابل حياة القرويين في مصر ، وبينهما فرق شاسع ، وكذلك البيت الذي يعيش فيه كلٌ منهما ، ونسقه . و”هيكل” يرى بحق أن مصر بلاد غنية ، ولكن بمعنى ما يردده النُساك : “أن القناعة كنزٌ لا يفنى” . ومن ثم يعجب أن هذا الفلاح المصري الذي تتصبب ثروة مصر من عرق جبينه ، لا يعرف منزله سريراً ، ولا كتاباً ، ولا شيئاً من معاني النعمة الإنسانية ، بل هو بالوجار أشبه منه بالبيت ، وللحيوان فيه من أسباب الحياة مثل ما للإنسان ، أو خير مما للإنسان (ص 172 ،173) .
ويدخل في نطاق مقارنات هيكل المهمة ، ما توصل إليه من خلال مشاهداته وتأملاته ، فربما اختصر صفة كل مدينة في كلمة أو في عبارة . فـ” ميونيخ” مدينة البيرة ، و “البندقية” مدينة الدانتيل والزجاج الملون ، و” فيينا” عزيز قوم ذل ، و “النمسا” شعب رزأه الصلح أكثر مما رزأته الحرب ، و”برلين” عاصمة حديثة تعلي من شأن الضخامة حتى الألمان أنفسهم ضخام الأجسام ، أما “باريس” فهي خلاصة الإبداع البشري، هي عالم ، بل في كل ناحية من باريس عالم (ص52) .أما مقبرة “جنوا” فإنها أشهر من جنوا ذاتها. وقد تكون المسافة بين “باريس” و “لندن” ساعة بالسفينة ، ولكن التفاوت كبير ، فكأن “المانش” يفصل بين عالمين مختلفين . وله تعليل علمي على طبائع دول حوض البحر المتوسط في مقابل دول شمالي أوروبا .
* * *
وبعد ،،
فقد وصف هيكل نفسه أو نفسيته بأنه محب للحياة ، يؤدي واجبها ، وأرى أن هذا الكتاب يحمل برهان صدق لهذه العبارة الجامعة . إذ قدم – عبر مئة يوم تقريباً ، قضاها متنقلا بين جهات أوروبا – وصفاً جمالياً لكل ما شاهد من روائع المنجز الإنساني ، مقرراً في كل مرة أن “الإنسان” هو كلمة السر في صناعة التقدم ، وفي بناء الأوطان – على السواء – وأن الحياة هبة الخالق – سبحانه – ينبغي أن تنفَق في العمل ، والعمل وحده ..العمل الدؤوب ، الذي يهدف إلى ترقية الحياة ، وتنمية القدرات الإنسانية .
[ نشرت هذه الدراسة ضمن كتاب المؤتمر الأول للجنة الفكرية وشعبة أدب الرحلات – اتحاد كتاب مصر ]