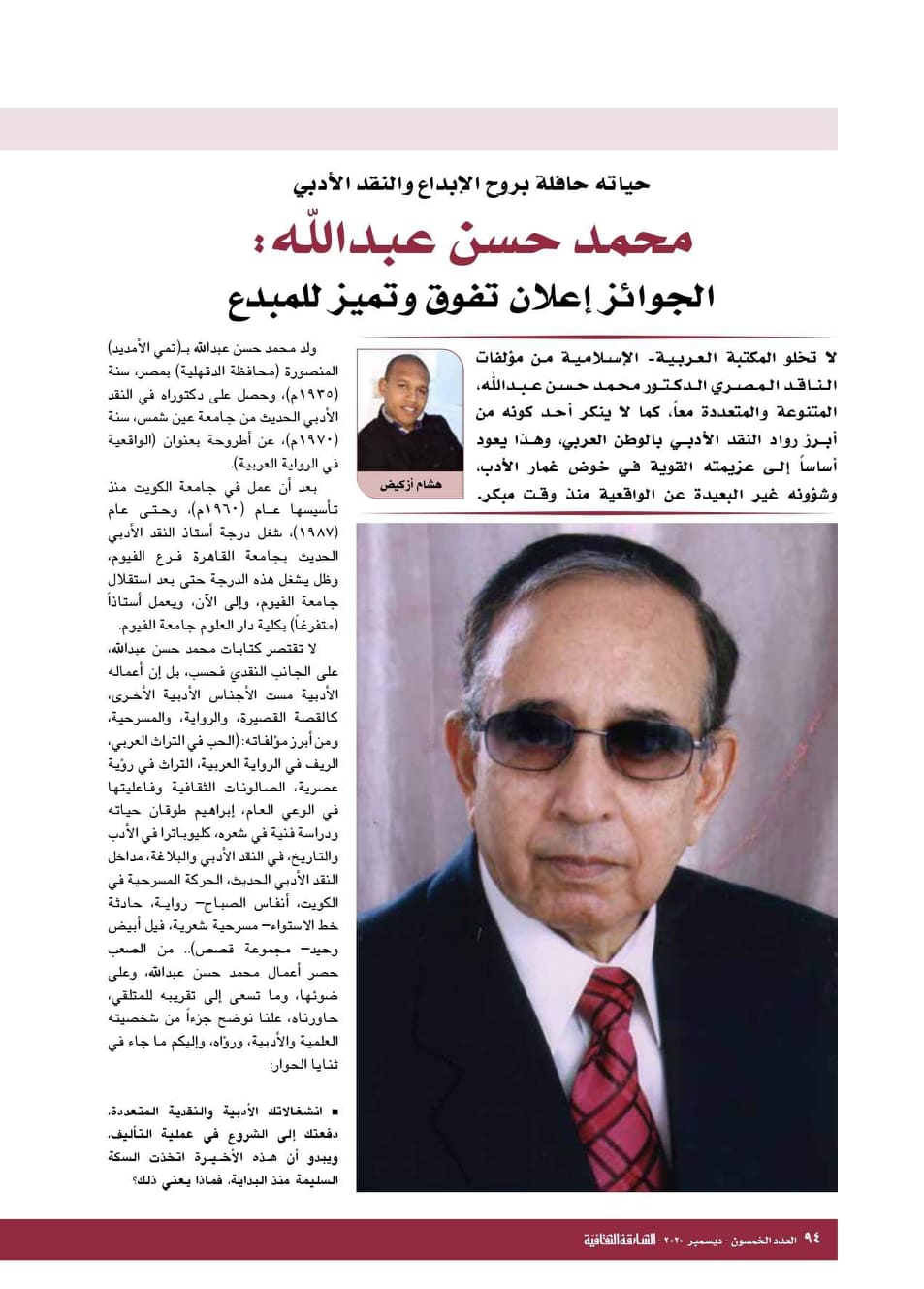حوار مع مجلة الشارقة الثقافية
- انشغالاتك الأدبية والنقدية المتعددة، دفعتك إلى الشروع في عملية التأليف، ويبدو أن هذه الأخيرة اتخذت السكة السليمة منذ البداية، فإلى ماذا يعزو ذلك؟
– يبدو أننا لابد أن نستعين بإقرار مبادئ أساسية، فيما يتعلق بقضية التأليف، وأولها ما يمكن اعتباره: الاستعداد الفطري، أي أن النفس مجبولة على حدة الملاحظة، والتفطن للفروق، وقدرة الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات، فنحن نعرف أن الوعاء الفارغ لا يحتوي غير الهواء، فإذا امتلأ بمعارف متنوعة فلا سبيل أمامه غير أن يفيض، أي ينتقل من مرحلة الاستقبال إلى مرحلة الإرسال، مع إبقاء موجة التلقي مفتوحة دائماً، وجاهزة للتوسع والتنوع، والتمييز بين الامكانات الجمالية لكل نوع (أو شكل فني). مع هذا لا أستطيع أن أجاريك في مجاملتك، وتسامحك بوصف ما كتبت بأنه يمضي في السكة السليمة، غير أني أقول : إن تجربة الكتابة كانت موازية لتجربة التلقي والتنوع، وقد أدلي هنا بأمر طريف- فقد حفظت القرآن الكريم وأنا صبي، وفي ذات الوقت كنت أقرأ الانجيل، أو الأناجيل إذا شئت، وأقرأ سفر التكوين، وبقية أسفار التوراة، مما أكسب ضميري قدرا من الرحابة، والنزوع الإنساني، والانتباه إلى الفروق، والبحث عن دوافعها وتجلياتها، وهكذا استمرت عملية التلقي موازية لعملية التأليف إلى اليوم.
- عملية التأليف في الجانب الأدبي، تقتضي من المؤلف أن يكون مبدعا، وأن يعانق كل ما تزخر به المكتبة العربية من الإنتاجات، لكن في الوقت نفسه، فإن هذه العملية تتطلب إعمال الرؤية التي من خلالها يمكن للإبداع الأدبي أن يجد قبولا لدى المتلقي أو القارئ، ومن خلال تجربتك الإبداعية، ما موقع الرؤية في كتاباتك وما هي متطلبات تحقيقها، وهل القراءة عنصر هام في حضورها؟
– كما سبقت الإشارة: لا تأليف قبل احتشاد الذاكرة بالمعارف، حتى يتم الفيضان، وقد لعبت (الظروف) دوراً مهماً في توجيه عملية التأليف من ناحية الموضوع، كما من ناحية الشكل الفني المختار، وإن كان هذا الأخير يستمد حتميته من الاستعداد الفطري (العصبي/النفسي) فقد تعلقت مبكراً بروايات محمد عبد الحليم عبدالله، صاحب : بعد الغروب، شجرة اللبلاب، شمس الخريف، غصن الزيتون، وظل موضع إعجابي المفرد إلى أن سطعت شمس نجيب محفوظ، وقرأت “بين القصرين” حين كانت تنشر فصولاً في مجلة (الرسالة الجديدة/رئيس تحريرها: يوسف السباعي – 1953)، فهجرت القراءة الرومانتيكية إلى الواقعية، ومن ثم تصارع الملمحان: الرومانتيكي والواقعي فيما كتبت من روايات وقصص قصيرة، بل إنهما ماثلان متواجهان في أطروحتي للدكتوراه (1970 – من جامعة عين شمس)، وكانت بعنوان : “الواقعية في الرواية العربية” ، فلما عملت في الكويت، مدرسا في التربية، ثم في جامعة الكويت إبان تأسيسها 1966، اجتذبني الموضوع الكويتي، وكانت الأرض خلاءً تقريباً، فبدأت بوضع ببلوجرافيا للموضوعات الأدبية والنقدية، ثم عقبت بكتاب : “الحركة الأدبية والفكرية في الكويت” .. وهكذا .
- شاركت في العديد من الملتقيات الثقافية والفكرية في مناطق عدة، فهل تساهم في صقل شخصية الكاتب المبدع، وما آثارها على المستقبل الأدبي؟
– الملتقيات الثقافية والفكرية ضرورة، فهي بمثابة “السياحة” بالنسبة للمعرفة، والمسبار الكاشف عن العمق أو السطحية. الملتقيات العربية ضرورة تتجاوز الثقافة والفكر إلى الألفة والخبرة المتبادلة، وتأكيد الذات العربية (المشتركة) الموحدة، فإذا تطلعنا إلى المستوى العالمي ظلت ضرورة المشاركة واجبة، إذ تكشف لنا الملتقيات العالمية عن جديد دال على اتجاهات التفكير، واجتهادات الإبداع التي يحول بيننا وبينها بعد المسافة، أو الجهل باللغة، بما يعني أن مشاركة أدباء المغرب أو الجزائر أو تونس، ومفكريها، على سبيل المثال في مؤتمر فرنسي يجيدون لغته أكثر مما نجيدها، واتبع ذلك بترجمة (النوادر) التي لم نتعرف عليها بالدرجة المفيدة، سيكون هؤلاء الأدباء قد أدوا لأمتهم العربية خدمة معرفية جليلة، شريطة أن تكونا لروح السائدة في الترجمة ملتزمة بالأمانة العلمية، وعاكسة لمعرفة أدبية رصينة وشاملة، فهذا هو ما يحقق أهداف الوساطة اللغوية عبر الترجمة. أما إذا كان هدف حضور المؤتمر دعائياً مظهرياً أو مادياً ، فالاعتذار عن عدم حضوره، أو عدم الترجمة أولى وأقوم سبيلا، لأنه -على الأقل- لا يؤدي إلى التحريف والتسطيح .
- من خلال مشاركتك في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزية، هل ما تقدمه لهذه الجهات يمكن أن نعتبره من سبل فرض الأدب وجوده في الحياة ؟
– هيا نبدأ من حقيقتين: أن المعرفة بالأدب والترقي بالذوق وتقويم اللسان حق لجميع الناس، مهما اختلفت مستوياتهم الثقافية وأعمارهم – والحقيقة الأخرى أن وسائل الإعلام، المسموعة والمشاهدة لا تزال أداة التوصيل التي باستطاعتها أن تقتحم البيوت (حتى غرف النوم) ، وتصحبك، أو باستطاعتها حتى وأنت تنطلق بسيارتك في الطريق، ومن ثم فإن التعامل مع الأدب بتوصيله من خلالها يبقى غاية عزيزة لدى كل مشتغل بالفكر أو بالأدب مهما كانت نزعته، ما دامت مقبولة من الأجهزة المشرفة على أدوات التوصيل . إننا – في مصر – نتذكر إلى اليوم (أقصد جيلي، وأنا في الخامسة والثمانين) أحاديث : طه حسين، والعقاد (المسائية) وحتى أحاديث : فكري أباظة في ركن المرأة، وأحاديث شيخ الأزهر محمود شلتوت ، وهذا يؤكد على أن موهبة الإلقاء، والقدرة على اجتذاب آذان المستمعين كانت ولا تزال عميقة التأثير في المتلقي .
- حدثنا عن بعض الصالونات الثقافية بالعالم العربي وخصائصها، وكيفية تأثيرها على الوعي العام، بحكم اهتمامك بهذه المسألة التي كانت محور هاما في كتابك الموسوم “الصالونات الثقافية وفاعليتها في الوعي العام”
– الصالونات الأدبية ذات جذور عميقة في التاريخ العربي، والتراث الإنساني على السواء، وهي وجه من أوجه الغريزة المجتمعية في النفس الإنسانية التي تأبى الانفراد (صنو التوحش) ، ولعل صالون (سكينة بنت الحسين – رضي الله عنها وعن والدها وجدها) يمثل حضورا خاصاً، متحرراً وعفيفاً، ومؤثراً في التراث العربي المبكر (العصر الأموي)، غير أن الصالون في بواكير النهضة العربية الحديثة كان من حظ الأرستقراطية بالنسب أو بالثقافة، أو بهما، فكان الصالون – في هذا الإطار – مساوقاً للتطلع الديمقراطي، وضرورة الحوار وإعلان الرأي . على أنني لم أتحمس كثيراً لصالون العقاد، فهذا الجبل المعرفي كان (ينفرد) بالحديث وبالأجوبة المسكتة وبالتوصيات في أية مشكلة، أما مشاركة الآخرين فكانت غالباً تقف عند دور : المستمعين والمعجبين !! الصالون الآن ضرورة ديمقراطية وديموجرافية، فالمدينة مترامية المسافات (مثل القاهرة) أصبح التنقل بين أحيائها صعباً جداً ومكلفاً، وهذا ما حملني على أن أقيم في بيتي (بضاحية المعادي) صالوناً ثقافياً في الجمعة الأخيرة من كل شهر، كان للرواد دور أساسي في تشكيل المحتوى إبداعاً ونقداً، وكنت أحول دون الانحراف أو الإنجراف في قضايا السياسة، وأمور العقيدة لأنها تفرق أكثر مما تجمع – فيما لو أثيرت – ولأن الناس بعامة لا يذهبون لحضور الصالونات للاستنارة الدينية ، أو الترشيد السياسي .
- ننتقل الآن إلى حقل الرواية العربية، في اعتقادك هل الرواية العربية تشهد تطورا مقارنة بوضعها في الماضي؟
– تطور الأشكال الفنية، وأساليب الأداء استعداد فطري وطبيعي، فكل قديم كان جديداً في حينه ، وبصفة عامة فإن فن الرواية العربية لا يزال في موقف المتلقي والمستلهم لفنون هذا الشكل في أنحاء مختلفة من العالم !! وحتى (الواقعية السحرية) التي لنا فيها – عبر حكايات ألف ليلة وليلة- نشأت وازدهرت في بعض أقطار أمريكا الجنوبية، وقد استلهمناها عبر ماركيز، وبورخيس ، وأضرابهما دون أن (نجرؤ) !! على استلهام ألف ليلة وليلة شكلا أو مضمونا بمبادرة خاصة . طبيعي أن الرواية اليوم، ومنذ توسط شمس سماء نجيب محفوظ الروائية، تحاول أن تختلف عنه، ويمكن أن نتلمس بعض أوجه الاختلاف في روايات مثل: مدن الملح لعبد الرحمن منيف، وروايات الطيب صالح .
- نلاحظ اليوم ظهور ما يسمى ب “الروايات الضخمة”، فهل هذا صحيح، و ما رأيك تجاه من يكرس هذا النوع من الكتابة السردية؟
– فيما أرجح أن الرواية الضخمة بعدد صفحاتها، ترتبط بالنزعة الواقعية، ويمكن أن نجد هذا لدى روائيين من الإنجليز والفرنسيين والروس، ولكننا لم نقلدهم – في حينهم – كما تمرد عليهم من بني وطنهم مؤسسوا فن القصة القصيرة، المعاصرين لهم ، مثل : جي دي موباسان ، وتشيكوف، وادجار آلان بو، وكذلك يمكننا أن نرى أن دوافع إيثار شكل القصة القصيرة، والرواية القصيرة، لا تزال حاضرة ومطلوبة، فكأن كُتاب الرواية الطويلة جداً (العربية) يسبحون عكس فلسفة الزمن، وتنافس وسائل المعرفة، وتعدد مصادرها، وقد قرأت عدداً قليلاً من هذا الأسلوب، ولا أظن أنها أضافت لجماليات الفن الروائي شيئا كان ينقصه .
- حدثنا باقتضاب عن تجربتك في كتابة القصة القصيرة والمسرح، ومدى تأثيرهما على الساحة الثقافية العربية؟
– لم أحاول أن أكون (شاملا) أو سابحاً بين أشكال الإبداع، وإنما هي نزعات وقتية، وبخاصة بعد احتراف التأليف النقدي، وهو ضرورة لأستاذ جامعي يدرس هذا التخصص، ومن واجبه أن يجتاز درجات الترقي في تخصصه، ربما يكون الحنين المستقر لأول معشوقة (وهي القصة القصيرة) هو الذي طالت صحبته إلى الآن، وربما اتخذ الحنين القديم أشكالا مختلفة، كما في (جرة عسل) التي يمكن أن تقرأ على أنها مجموعة التماعات تنتمي على فن الحكاية أو القصة القصيرة، كما يمكن أن تكون “سيرة ذاتية”، أو رواية حسب مؤسسات التلقي لدى القارئ . إن مسرحية واحدة (حادثة خط الاستواء) حتى وإن غامرت بأن أصفها بالشعرية والجودة، وتأنيس الفلسفة .. إلخ ، لا تدل على تمكن في فن الدراما، فشقشقة عصفور وحيد لا تعلن عن استهلال فصل الربيع !!
- نلت العديد من الجوائز الأدبية، وهي تدل على المجهودات التي تبذلها من أجل خدمة الأدب، وتحقيق التنمية الثقافية، ففي نظرك ومن خلال تجربتك كيف تساهم الجوائز في الاهتمام بالجانب الأدبي؟
– تحمل الجوائز – مهما كان قدرها المادي – نوعا من التقدير (الرمزي) لمن يحصل عليها، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي ومحفز في اختيار موضوعات بعينها، والاجتهاد في ابتكار أشكال فنية – غير مستهلكة، وغير مألوفة – حين تكون الجهة المانحة ذات رؤية ثقافية جادة، وتحرص على عدالة التحكيم وكفايته، وبراءته من الانحياز الإقليمي، أو الموضوعي، أو الديني والمذهبي، وأخيراً: براءة الجائزة من أن تُمنح تحت وطأة الحاجة : كالمرض، أو الفقر، أو الإلحاح والمطاردة .. إلخ . ومن المؤسف أن بعض جوائزنا ذات القيمة علقت بها هذه الرائحة غير المريحة، وغير العادلة؛ فالمؤلف المريض أو الفقير أو الملحاح يحتاج إلى شيء آخر غير أن يفوز بجائزة خصصت كبراءة وإعلان تفوق وتميز لمبدع !!